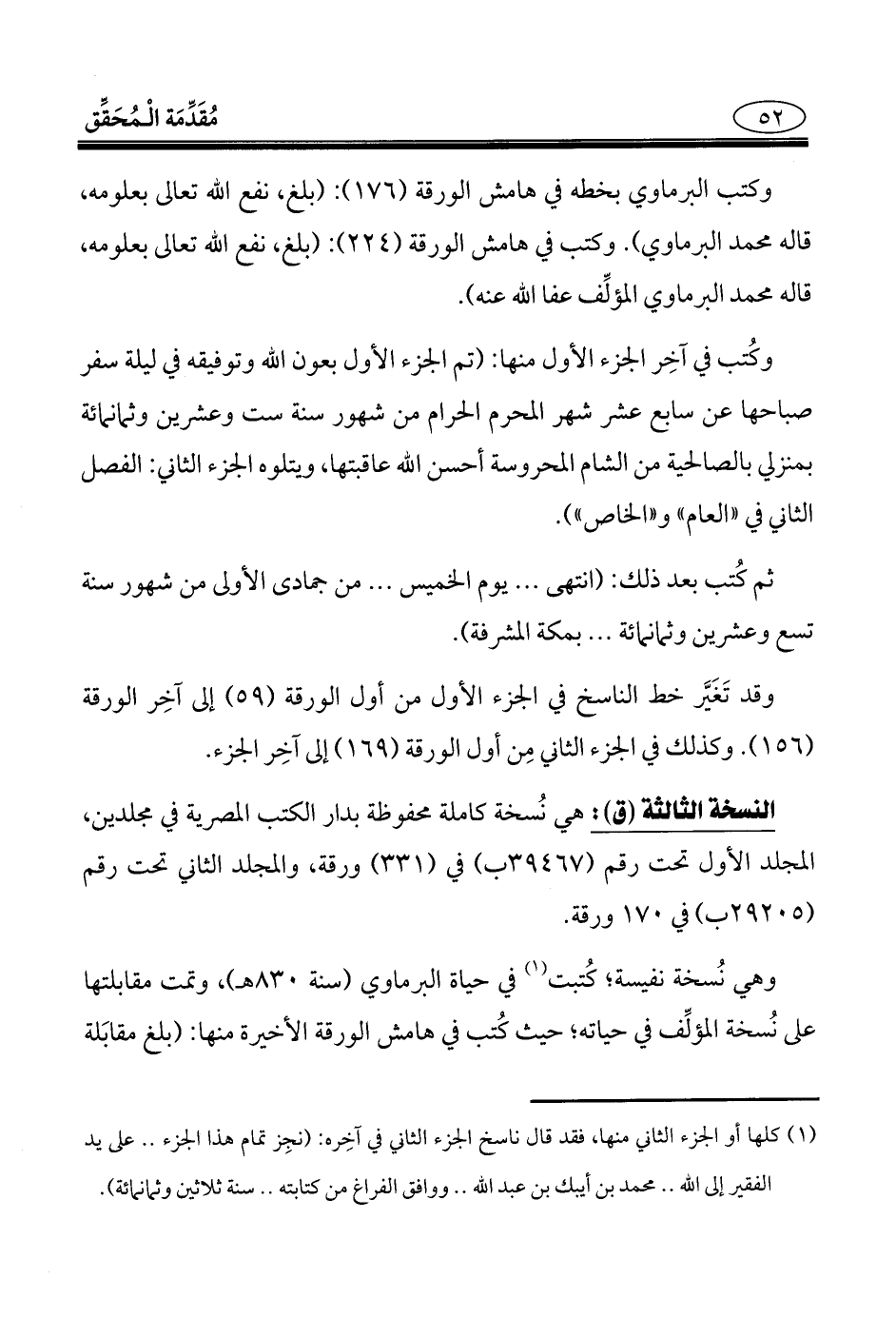
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
وكتب البرماوي بخطه في هامش الورقة (176): (بلغ، نفع الله تعالى بعلومه، قاله محمد البرماوي). وكتب في هامش الورقة (224): (بلغ، نفع الله تعالى بعلومه، قاله محمد البرماوي المؤلِّف عفا الله عنه).وكُتب في آخِر الجزء الأول منها: (تم الجزء الأول بعون الله وتوفيقه في ليلة سفر صباحها عن سابع عشر شهر المحرم الحرام من شهور سنة ست وعشرين وثمانمائة بمنزلي بالصالحية من الشام المحروسة أحسن الله عاقبتها، ويتلوه الجزء الثاني: الفصل الثاني في "العام" و"الخاص").
ثم كُتب بعد ذلك: (انتهى ... يوم الخميس ... من جمادى الأولى من شهور سنة تسع وعشرين وثمانمائة ... بمكة المشرفة).
وقد تَغَيَّر خط الناسخ في الجزء الأول من أول الورقة (59) إلى آخِر الورقة (156). وكذلك في الجزء الثاني مِن أول الورقة (169) إلى آخِر الجزء.
النسخة الثالثة (ق): هي نُسخة كاملة محفوظة بدار الكتب المصرية في مجلدين، المجلد الأول تحت رقم (39467 ب) في (331) ورقة، والمجلد الثاني تحت رقم (29205 ب) في 170 ورقة.
وهي نُسخة نفيسة؛ كُتبت (¬1) في حياة البرماوي (سنة 830 هـ)، وتمت مقابلتها على نُسخة المؤلِّف في حياته؛ حيث كُتب في هامش الورقة الأخيرة منها: (بلغ مقابَلة
¬__________
(¬1) كلها أو الجزء الثاني منها، فقد قال ناسخ الجزء الثاني في آخِره: (نجِز تمام هذا الجزء .. على يد الفقير إلى الله .. محمد بن أيبك بن عبد الله .. ووافق الفراغ من كتابته .. سنة ثلاثين وثمانمائة).
هواها، فأَلِفَ ارتكابَ المحظورات واقتضاء [الشهوات] (¬1)؛ فضَعُف وازع الدِّين بسبب ذلك، فلا يُوثق بقوله). انتهى
وخرج بِقَيْد كَوْن الملكة مانعة من اقتراف الكبيرة والإصرار على الصغيرة: مَن لا تمنعه من ذلك، وهو الفاسق، وسيأتي بيان ذلك موضَّحًا.
فإن قلتَ: فقد أَدْخَل الشافعي في العدالة تعاطي المروءة، وكذا في عبارة الأكثر من الفقهاء والأصوليين، حتى جرى على ذلك من المتأخرين البيضاوي وغيره، وعبارة صاحب "جمع الجوامع" في تعريف العدالة: مَلَكَة تمنع من اقتراف الكبائر وصغائر الخِسة والرذائل المباحة وهوى النفس.
فأشار بِـ"صغائر الخسة" إلى نحو سرقة لقمة، و"الرذائل المباحة" إلى ما يُخل بالمروءة منها، كالبَول في الطريق ونحوه مما سنذكره في موضعه. وبِـ"هوى النفس" إلى ما ذكره والده الشيخ تقي الدين - من تفقهه - من الاحتراز به عن انبعاث الأغراض حتى لا يملك نفسه عن اتباع هواها وإلا لخرج بذلك عن الاعتدال.
فلِمَ أسقطتها من التعريف؟
فالجواب عن إدخال المروءة أن مراد الشافعي ومَن تبعه على ذلك ذكر العدالة المعتبرة في الشاهد والراوي، لا العدالة من حيث هي، فضمنوا المروءة معناها لذلك، وإنما هي في الحقيقة شرط في قبول الشهادة والرواية كما يشترط فيها الضبط، ولا تدخل في حقيقة العدالة؛ ولهذا ترى في كُتب أصحابنا - كما في شرحَي الرافعي و"الروضة" وغيرها - جَعْل العدالة والمروءة شرطين متغايرين، فلو دخلت المروءة في العدالة لَاكتفي بالعدالة وجعلت شرطًا واحدًا.
¬__________
(¬1) في (ص): المشهورات.
لكن في الثاني نظر؛ فقد قال ابن الصباغ في "العدة": (إن مذهب الشافعي أن مفهوم العدد حُجة إلا إذا كان في ذِكر المعدود تنبيه على ما يُزاد عليه، نحو: "إذا بلغ الماء قُلتين لم يحمل خبثًا"، فإنه تنبيه على أن ما زاد عليهما أَوْلى بأن لا يحمل). انتهى
ومِثله قال الشافعي في "اختلاف الحديث": (إنَّ في حديث "إذا بلغ الماء قُلتين، لم يحمل نجسًا" دلالتين:
إحداهما: أن ما بلغ قُلتين فأكثر لم يحمل نجسًا.
والثانية: إذا كان دون قُلتين، يحمل النجاسة؛ لأن قوله: "إذا كان الماء كذا، لم يحمل النجاسة" دليل على أنه إذا لم يكن كذا، حمل النجاسة، وهذا يوافق حديث أبي هريرة في غسل الإناء من الولوغ؛ لأن آنيتهم كانت صغارًا) (¬1). انتهى
وعلى هذا الثاني يحمل كلام الماوردي وأنه حُجة بالنسبة إلى عدم النقصان، لا الزيادة.
قال ابن الرفعة في "المطلب" في "باب الجماعة": إن القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في عدم تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة، ولا زيادة على ثلاثة أيام في خيار الشرط، ويتعَجَّب من النووي- رحمه الله تعالى- في قوله: إن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين.
قال: (ولَعَلَّه سبق الوهم إليه مِن اللقب). انتهى
ونقل اعتباره أيضًا أبو الخطاب الحنبلي عن منصور بن أحمد، وبه قال مالك وداود.
وأما القول بأنه غير حُجة فهو رأْى منكري مفهوم الصفة، كالقاضي وإمام الحرمين، وبه قال صاحب "الهداية" من الحنفية، ونُقل عن بعض الحنفية غير ذلك، فعندهم اضطراب
¬__________
(¬1) اختلاف الحديث (ص 500).
شرطه أن لا يدخل في المستثنى منه قطعًا، وهذا يحتمل أن يراد دخوله.
ولهذا لما عَرَّف ابن الحاجب المنقطع، قال: (ما دل على مخالفة بِـ "إلا" غَيْر الصفة وأخواتها مِن غير إخراج) (¬1).
وهذا معنى قولي في النَّظم: (مِنْ وَاجِبِ الدُّخُولِ) أي: إخراج [شيء] (¬2) مِن واجب الدخول، أي: لا إخراج واجب الدخول جميعه؛ لئلا يبقى الاستثناء مستغرقًا، وهو باطل كما سيأتي.
وقولي: (فِيمَا دَلَّا) أي: دلَّ، فالألف فيه للإطلاق.
وشمل ما دَلَّ على المستثنى:
- ما تَقدم، وهو الأصل.
- وما تَأخَّر، نحو: (ما قام إلا زيدًا القوم).
- وما كان مرادًا ذِكره ولم يُذكر، وذلك في الاستثناء المفرغ. وفي تقدير التلفظ به خِلاف للنحاة، نحو: (ما قام إلا زيد). والأرجح لا يُقدر شيء، بل إرادته في المعنى كافية.
¬__________
(¬1) مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (2/ 794).
(¬2) كذا في (ص، ق)، لكن في سائر النُّسخ: لشيء.
والمراد بالانخرام أن لا يُعمل بالوصف في التعليل، لا أنَّ المصلحة التي اشتمل عليها تزول بوجود المفسدة، فيكون تَخَلّف التعليل به لِمَانِع، لا لعدم المقتضِي.
ومَن قال: (لا تنخرم) يقول: إنَّ هذا ليس بمانع. وإنما كان القول بالانخرام راجحًا؛ لأنَّ دَرْءَ الفاسد مُقَدَّم على جَلْب المصالح عند التعارُض. ويدل له أن العقلاء يعدُّون فِعل ما فيه مفسدة مُساوية لمصلحة عَبَثًا وسفهًا، كمَن سلك مَسْلكًا يُفَوِّت درهمًا ويُحَصِّل آخر مِثله أو أَقَل منه.
قلت: قد سلك الفقهاء ذلك في مسائل ولم يعدُّوه عبثًا حتى يمتنع، فقالوا: إنَّ رهن الولي ونحوه شيئًا يساوي مائة على ثمن شيء يشتريه لموليه يساوي مائتين بمائة مؤجلة جائز؛ لأنَّ ذلك الرهن إذا تلف عند المرتهن والفرض أنه لا ضمان عليه فيه يسلم له الشيء المشترى بمائة وهو يساوى مائتين، فلم يَفُت على المولى شيء. فهذا عرَّض الرهن - الذي بمائة - للتلف بحصول مائة زائدة في المبيع، إلا أنْ يُجاب بأنَ المفسدة فيه ليست محُقَّقة، بخلاف مسألتنا.
ومما رُتِّب على القول بخرم المناسبة بذلك لو كان للبلد الذي يقصده المسافر طريقان يقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخَر، فسلك الأبعد لغير غرض، لم يَقْصر في أصح القولين؛ لأن المناسب - وهو السفر البعيد - عُورِض بمفسدة وهو العدول عن الأقرب لا لمعنى، بل كأنه حَصر قَصْده في أنْ يُفَوِّت ركعتين مِن الرباعية في مُدة ذلك. وفي معنى ذلك أنْ يدخل المسجد وقت الكراهة بقصد تحية المسجد، أو يقرأ آية سجدة في الصلاة ليسجد، أو نحو ذلك.
واعلم أن اشتراط الترجيح في تحقيق المناسبة بتحقيق المانع المعارِض مع وجود المقتضِي فلا بُدَّ له مِن الاعتراف بالمناسبة، سواء أكانت المصلحة مرجوحة أو مساوية، وإلا لكان انتفاء الحكم لِانتفاء المناسبة، لا لِوجود المانع المعارِض. والله أعلم.