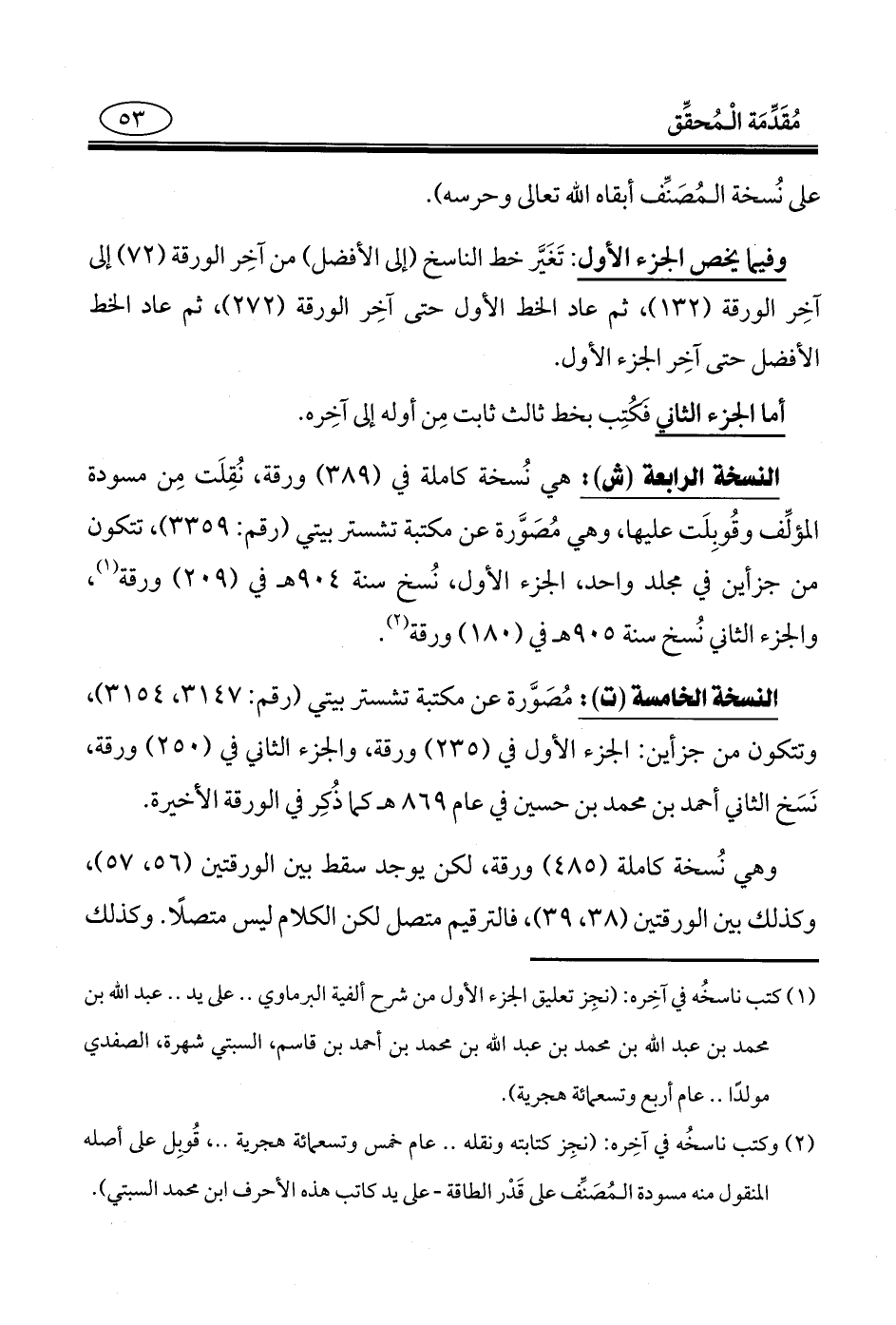
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
على نُسخة المُصَنِّف أبقاه الله تعالى وحرسه).وفيما يخص الجزء الأول: تَغَيَّر خط الناسخ (إلى الأفضل) من آخِر الورقة (72) إلى آخِر الورقة (132)، ثم عاد الخط الأول حتى آخِر الورقة (272)، ثم عاد الخط الأفضل حتى آخِر الجزء الأول.
أما الجزء الثاني فَكُتِب بخط ثالث ثابت مِن أوله إلى آخِره.
النسخة الرابعة (ش): هي نُسخة كاملة في (389) ورقة، نُقِلَت مِن مسودة المؤلِّف وقُوبِلَت عليها، وهي مُصَوَّرة عن مكتبة تشستر بيتي (رقم: 3359)، تتكون من جزأين في مجلد واحد، الجزء الأول، نُسخ سنة 904 هـ في (209) ورقة (¬1)، والجزء الثاني نُسخ سنة 905 هـ في (180) ورقة (¬2).
النسخة الخامسة (ت): مُصوَّرة عن مكتبة تشستر بيتي (رقم: 3147، 3154)، وتتكون من جزأين: الجزء الأول في (235) ورقة، والجزء الثاني في (250) ورقة، نَسَخ الثاني أحمد بن محمد بن حسين في عام 869 هـ كما ذُكِر في الورقة الأخيرة.
وهي نُسخة كاملة (485) ورقة، لكن يوجد سقط بين الورقتين (56، 57)، وكذلك بين الورقتين (38، 39)، فالترقيم متصل لكن الكلام ليس متصلًا. وكذلك
¬__________
(¬1) كتب ناسخُه في آخِره: (نجِز تعليق الجزء الأول من شرح ألفية البرماوي .. على يد .. عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن قاسم، السبتي شهرة، الصفدي مولدًا .. عام أربع وتسعمائة هجرية).
(¬2) وكتب ناسخُه في آخِره: (نجِز كتابته ونقله .. عام خمس وتسعمائة هجرية .. ، قُوبِل على أصله المنقول منه مسودة المُصَنِّف على قَدْر الطاقة - على يد كاتب هذه الأحرف ابن محمد السبتي).
وممن تعقب على البيضاوي في ذلك السبكي في شرحه، وأجاب بما أجبنا به عن الشافعي والأصحاب، إلا أنه لم يقتصر على ذلك، بل جعلها أنواعا نقلها عن الماوردي، وأن منها ما هو شرط في العدل، وستأتي عبارته بتمامها في الكلام على الشرط الثاني.
قال: (ومَن يُدْخل المروءة في العدالة فإنما يريد بذلك نوعًا منها، لا الجميع). انتهى
ومراده بكونه في نوع منها أنه شرط فيما يشترط فيه، لا أنه من حقيقة ذلك النوع حتى يحتاج لذكره، بل ذكره شرطًا مفردًا لقبول الشهادة والرواية أوضح وأَوْلى؛ لئلا يتوهم أنه من حقيقة العدالة.
ويستغنى في المخل بالمروءة عن التعرض لنوعَيْه، وهُما كونه معصية (كسرقة لقمة) أو مباحًا (كالبول في الطريق)، وحينئذ فلم يُحْتَج إلى قوله: (وصغائر الخسة).
نعم، ظاهر كلام الشافعي السابق أن العدالة المعتبرة في الشاهد هي المعتبرة في الراوي وإنْ شُرِط في الشاهد زيادة الحرية والعدد ونحو ذلك، فيرجح بذلك أحد الوجهين المحكيين عن الأصحاب أن عدالة الراوي هل يشترط أن تنتهي إلى عدالة الشاهد؟ أَمْ لا؟ حكاهما ابن عبدان في شرائط الأحكام:
أحدهما: أنه يعتبر في الراوي عدالة مَن يقبله الحاكم في الدماء والفروج والأموال.
وثانيهما: يُقبل في الرواية مَن ظاهره الدِّين والصدق.
وأما زيادة الاحتراز عن هوى النفس فيستغنى عنه بالملكة؛ لأنه ينافيها، ومما يؤيده ما سبق نقله عن محمد بن يحيى.
قولي: (مَانِعَةُ اقْتِرَافِ) هو صفة لملكة، وإطلاق الهلكة على ما ذكر لأنه سبب للهلاك، قال تعالى: {وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ} [الأنعام: 26]، وفي حديث المجامع في رمضان:
فيه.
وممن أنكر مفهوم العدد الإمام الرازي في تفصيل مُطَوَّل حاصله أنه لا يدل على نَفْي الحكم فيه فيما زاد أو نقص إلا بدليل.
تنبيهان
أحدهما: محل الخلاف فيه في عَدد لم يقصد به التكثير، كالألْف والسبعين ونحوهما مما يُستعمل في لغة العرب للمبالغة. قاله ابن فورك وغيره، فإن قولهم: (أسماء العدد نصوص) إنما هو حيث لا قرينة تدل على إرادة المبالغة، نحو؛ (جئتُك ألف مرة فلم أجدك). وبذلك يُعلم ضعف الاحتجاج بقوله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا نزل: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]: "لأزيدن على السبعين" (¬1)، فعمل - صلى الله عليه وسلم - بالمفهوم فيه، وذلك مِن أَشهر حجج المعْتَبِرين لمفهوم العَدد، بل ويجاب عنه بأمر آخَر، وهو أنه لَعلَّه قاله رجاءً لحصول المغفرة؛ بناءً على بقاء حُكم الأصل وهو الرجاء الذي كان ثابتًا قبل نزول الآية، لا لأنه فَهِمه من التقييد.
وأما جواب القاضي أبي بكر والإمام والغزالي ومَن تبعهم بالطعن في الحديث فعجيب؛ فإنه في "الصحيحين" لكن بلفظ "سأزيد".
قال أبو بكر الرازي: (فأما ما رواه أبو عبيد: "لأزيدن على السبعين" فهي رواية باطلة لا تصح ولا تجوز؛ فإنه يمتنع غفران ذنب الكافر، وإنما الروي: لو علمتُ أنه يغفر له إذا زدتُ على السبعين لَزِدْتُ) (¬2). انتهى
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (4393)، صحيح مسلم (2400) بلفظ: "سَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ".
(¬2) أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (4/ 351).
تنبيهات
أحدها: إنما قيدت الاستثناء المعدود مِن المخصِّصات بِـ "المتصل"؛ لأن المنقطع يسمى "استثناء" لكن مجازًا عند الأكثرين، واختاره ابن الحاجب وغيره.
وقيل: يُسمى حقيقةً؛ فيكون اللفظ مشتركًا.
وقيل: موضوع للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع؛ فيكون متواطئًا.
وعلى هذه الأقوال الثلاثة يُسمى "استثناء".
قال ابن الحاجب في "مختصره الكبير": إن ذلك باتفاق.
ولكن فيه نظر؛ فقد حكى الشيخ أبو إسحاق قولًا أنه لا يُسمى "استثناءً" لا حقيقةً ولا مجازًا.
ثم قال ابن الحاجب: (إنه على القول بالمجاز أو بالاشتراك لا يُجْمعان في تعريف واحد) (¬1).
ثم عرف المنقطع بما سبق، لكنه قال في تعريفه: (مِن غير إخراج)؛ ليخرج به المتصل. وهو يقتضي أنه إذا سقطت هذه اللفظة، كان بقية التعريف شاملًا لهما.
ثم ذكر تعريفه على قول التواطؤ بِـ: (ما دَلَّ على مخالفة بِـ "إلا" غير الصفة وأخواتها).
وأما ابن مالك فجمعهما في تعريفه في "التسهيل"، فقال في المستثنى: (هو المخرج تحقيقًا أو تقديرًا مِن مذكور أو متروك بِـ "إلا" أو ما بمعناها، بشرط الفائدة) (¬2).
¬__________
(¬1) منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (ص 79)، مطبعة السعادة - 1326 هـ.
(¬2) شرح التسهيل لابن مالك (2/ 264).
ص:
839 - وَالسَّادِسُ: الَّذِي يُسَمَّى "شَبَهَا" ... بَيْنَ مُنَاسِب وَطَرْب أَشْبَهَا
840 - مُعْتَبَرٌ إنْ فُقِدَ الْمُنَاسِبُ ... أَعْلَاهُ إنْ رُتبتِ الْمَرَاتِبُ
841 - هُوَ قِيَاسُ "غَلْبَةِ (¬1) الْأَشْبَاهِ" ... حُكْمًا وَوَصْفا، بَعْدهُ يُبَاهِي
842 - مَا كَانَ صُوريًّا، وَأَمَّا السَّابعُ ... فَ "الدَّوَرَانُ": الِاقْتِرَانُ الْوَاقِعُ
843 - لِلْحُكْمِ مَعْ وَصْفٍ، إذَا مَا يُوجَدُ ... يُوجَدُ، وَالْعَكْسُ، وَظَنّا يُوجِدُ
الشرح:
السادس مِن مسالك العلة: "الشَّبَه" بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة، أصل معناه: المشبه. يقال: هذا شَبَه هذا وشِبْهه (بكسر الشين وسكون الباء) وشبيهه. كما تقول: مَثَله ومثْله ومَثِيله. وهو بهذا المعنى يُطلق على كل قياس؛ لأن الفرع لا بُدَّ أن يُشْبه الأصل. لكن غلب إطلاقه في الاصطلاح الأصولي على هذا النوع الآتي بيانه.
لكن إنْ أُريدَ الذي دَلَّ على العلة فهو مصدر أو اسم مصدر، وإنْ أريد نفس العلة فهو وصف بمعنى المشبه.
ولهم في تفسيره حينئذٍ عبارات:
إحداها: أنه وَصْف يُشبه المناسب في إشعاره بالحكم لكن لا يساويه، بل دُونه، ويشبه الطردي في كونه لا يقتضي الحكم بمناسبة بينهما.
¬__________
(¬1) في (ت): غلبة. وفي (س): علبة. وفي سائر النُّسَخ: علة. وقد جَعَلْتُ اللام ساكنة؛ ليصح الوزن، وفي "تاج العروس من جواهر القاموس، 3/ 489": ("الغَلْب" بفَتْح فَسُكُون، ويُحرَّك وَهِيَ أَفْصَح).