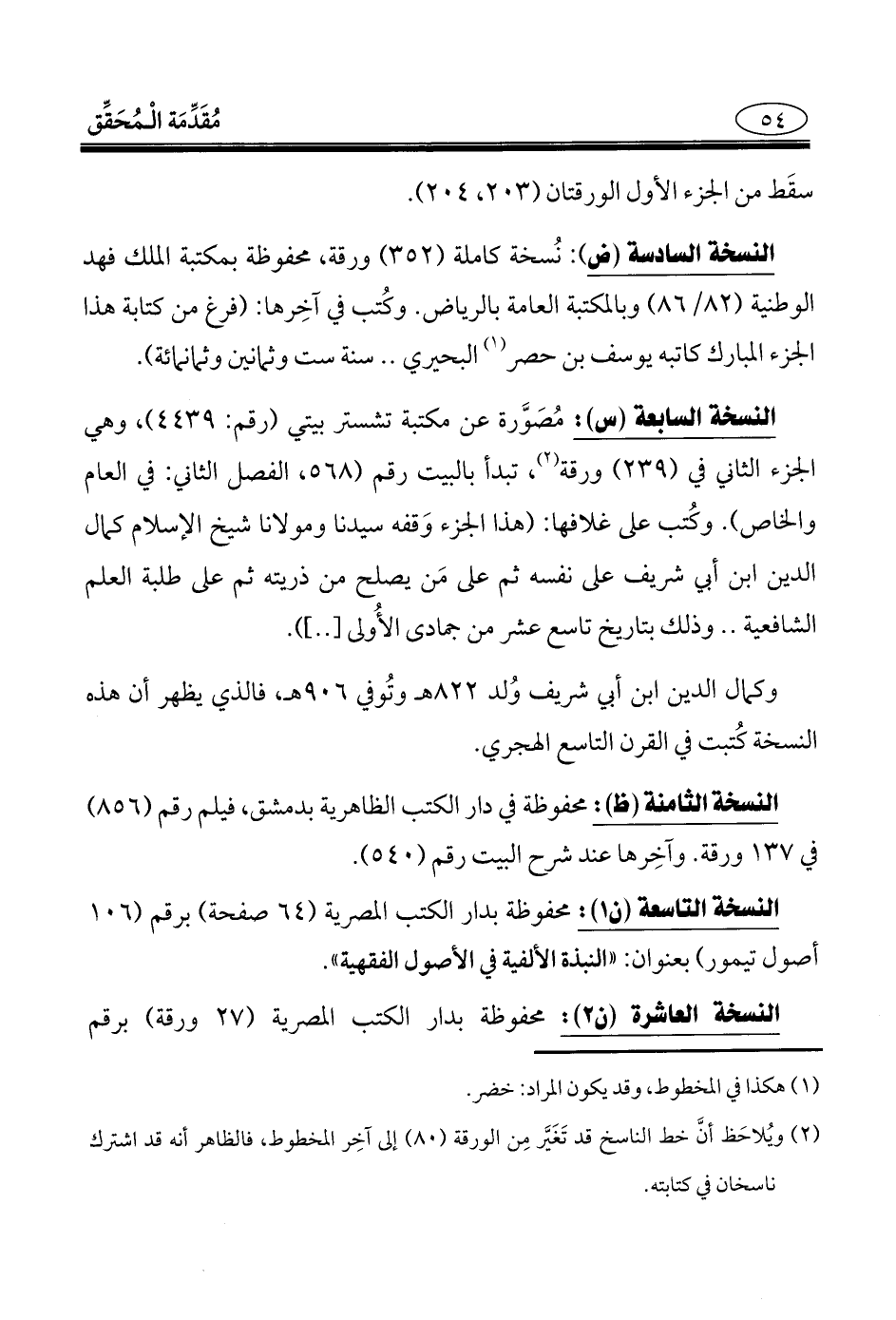
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
سقَط من الجزء الأول الورقتان (203، 204).النسخة السادسة (ض): نُسخة كاملة (352) ورقة، محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنية (82/ 86) وبالمكتبة العامة بالرياض. وكُتب في آخِرها: (فرغ من كتابة هذا الجزء المبارك كاتبه يوسف بن حصر (¬1) البحيري .. سنة ست وثمانين وثمانمائة).
النسخة السابعة (س): مُصَوَّرة عن مكتبة تشستر بيتي (رقم: 4439)، وهي الجزء الثاني في (239) ورقة (¬2)، تبدأ بالبيت رقم (568، الفصل الثاني: في العام والخاص). وكُتب على غلافها: (هذا الجزء وَقفه سيدنا ومولانا شيخ الإسلام كمال الدين ابن أبي شريف على نفسه ثم على مَن يصلح من ذريته ثم على طلبة العلم الشافعية .. وذلك بتاريخ تاسع عشر من جمادى الأُولى [ .. ]).
وكمال الدين ابن أبي شريف وُلد 822 هـ وتُوفي 906 هـ، فالذي يظهر أن هذه النسخة كُتبت في القرن التاسع الهجري.
النسخة الثامنة (ظ): محفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق، فيلم رقم (856) في 137 ورقة. وآخِرها عند شرح البيت رقم (540).
النسخة التاسعة (ن 1): محفوظة بدار الكتب المصرية (64 صفحة) برقم (106 أصول تيمور) بعنوان: "النبذة الألفية في الأصول الفقهية".
النسخة العاشرة (ن 2): محفوظة بدار الكتب المصرية (27 ورقة) برقم (37831 ب)
¬__________
(¬1) هكذا في المخطوط، وقد يكون المراد: خضر.
(¬2) ويُلاحَظ أنَّ خط الناسخ قد تَغَيَّر مِن الورقة (85) إلى آخِر المخطوط، فالظاهر أنه قد اشترك ناسخان في كتابته.
"هلكتُ وأهلكت؛ واقعت أهلي في رمضان" (¬1)، وفي الحديث كما سيأتي: "اجتنبوا السبعَ الموبقات" (¬2). أيْ: الملقيات في الهلاك وهو العذاب.
ولم أجمع لفظ "الكبيرة"، بل أفردتُ فقلتُ: (كُلِّ هَلَكَة) وإنْ عبَّر كثيرٌ بالجمع، كالبيضاوي، فقالوا: (تمنع من اقتراف الكبائر)؛ لأن ذلك يوهم أن اقتراف الكبيرة الواحدة لا يقدح.
وأما جواب بعض الشراح عن ذلك بأن الملكة إذا قويتْ على دفع الجُملة، قويتْ على دفع البعض من باب أَوْلى - فغير ظاهر؛ لأنه يقال: قد تُسْتَهْوَن الواحدة وتَنْفِرُ النفْس عن الكثير، فتكون الملكة موجودة ولكنها ضعيفة، فانعكس المعنى الذي قاله.
وقولي: (كَبِيرَةً تَكُونُ) إلى آخِره - هو تفصيل للذنب الذي هو هلكة، أي: إنه إما كبيرة وإما إصرار على صغيرة، وربما جعل الإصرار من الكبائر كما قال الغزالي في "الإحياء" في كتاب التوبة: إنَّ الصغيرة بالإصرار تصير كبيرة.
وحينئذ فإما أن يكون مراده بذلك أنها مثل الكبيرة؛ لِمَا يشتركان فيه من المعنى، فأطلق عليها "كبيرة" مجازًا؛ لذلك، لا أنها كبيرة على الحقيقة. أو تكون كبيرة حقيقةً لكنه عطف على "الكبيرة" من عطف الخاص على العام. لكن الأول أوضح.
بل قال أبو طالب القُضاعي في كتاب "تحرير القال في موازنة الأعمال": إن الإصرار حُكمه حُكم ما أصر به عليه، وإن الإصرار على الصغيرة صغيرة.
قال: (وقد جرى على أَلْسِنة الصوفية: "لا صغيرة مع إصرار"، وربما يُروى حديثًا، ولا يصح). انتهى
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم: 5737)، صحيح مسلم (رقم: 1111).
(¬2) صحيح البخاري (رقم: 2615)، صحيح مسلم (رقم: 89).
وهذه الرواية في "البخاري" في "باب الجنائز" بلفظ: "لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها" (¬1).
وقد قال ابن فورك: لا معنى لتوهين الحديث؛ لأنه قد صح، وليس بمستنكَر استغفاره - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها لا تستحيل عقلًا، والإجابة ممكنة، ولو خُلِّينا وظاهر الآية لكان الزائد على السبعين يقتضي الغفران، لكن نزل بعده: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]، فَدَلَّ ذلك على زوال حُكم المفهوم " فإن صلاته - صلى الله عليه وسلم - توجِب المغفرة؛ ولهذا امتنع مِن الصلاة على المدين.
وتَلَطَّف ابن المنير فقال: لَعلَّ القصد بالاستغفار التخفيف، كما في الدعاء به لأبي طالب، وقوله: " لأزيدن على السبعين" أي: أفعل ذلك لأُثاب على الاستغفار، فإنه عبادة.
الثانى:
قال الشيخ تقي الدين السبكي: (التحقيق عندي أن الخلاف في مفهوم العدد إنما هو عند ذِكر نفس العدد، أما المعدود فلا يكون مفهومه حُجة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان" (¬2)، فلا يكون فيه [عدم تحريم] (¬3) ميتة ثالثة) (¬4).
ثم ذكر تمثيل الأصوليين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قُلتين"، ولم يرتضه، لأنه ليس فيه ذِكر عدد، واعتل بأنَّ العدد يشبه الصفة، والمعدود يشبه اللقب، فما ذكره إنْ لم يكن تنقيح مناط
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم: 1300).
(¬2) مسند أحمد (5723)، سنن ابن ماجه (رقم: 3314)، السنن الكبرى للبيهقي (1128) وغيرها. قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: 2695).
(¬3) في (ش): (تحريم). وفي هامش (ز): (كذا في شرح منهاج البيضاوي .. وصوابه: عدم حل ميتة ثالثة).
(¬4) الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 382).
فأدخل المنقطع بقوله: (أو تقديرًا)، نحو: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} [النساء: 157]. فالظن لم يدخل في العلم تحقيقًا لكنه في تقدير الداخل، إذ هو مستحضر بذكره. أي: ما لهم به من علم ولا غيره من الشعور إلا اتباع الظن.
ونحوه: ما في الدار أحد إلا حمارًا. فإن المعنى: ما فيها عاقل ولا شيء من متعلقاته إلا الحمار.
نعم، قد قسم النحاة الاستثناء المنقطع إلي:
- ما ليس للعامل عليه تسلط، فيجب نصبه باتفاق، نحو: (ما زاد المال إلا ما نقص)، و: (ما نفع زيد إلا ما ضر).
- وما للعامل عليه تسلط، فالحجازيون يوجبون نصبه، وتميم تُرجِّحه وتجيز البدل.
فمِن النَصب قراءة السبعة قوله تعالى: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} بالنصب.
ومن الاتباع قول الشاعر:
وبَلْدَةٍ ليس بها أَنِيسُ ... إلا اليَعافِيرُ وإلاَّ العِيسُ
أي: ورب بلدة ما فيها إلا اليعافير (وهي الظباء البيض) والعيس (أي: إبلنا التي نحن سائرون عليها).
وقيل: المراد بالعيس بقر الوحش، شبَّهها بالإبل، فاستثني من الأنيس ما ليس منه.
وعبَّر في "التسهيل" عن هذا القسم بما يصح إغناؤه عن المستثنى منه وما لا يصح. وهو معنى ما سبق.
ومن أمثلة ما لا يصح إغناؤه قوله تعالى: {لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ} [هود: 43]؛ إذ لو قُدر "لا عاصم إلا المرحوم" لم يصح. وقيل في الآية أيضًا غير ذلك.
فهو بين المناسب والطردي، وهو معنى قولي: (بَيْنَ مُنَاسبٍ وَطَرْدٍ). أي: طردي. وإنما حذفت الياء منه مسامحةً؛ لأنه مُقابِل للمناسب، فيُعْلَم أنه طَرْدي، لا طرد. فإنَّ معنى "الطرد" بدون "ياء" سيأتي تفسيره بِغَير الطردِي. وسيأتي أيضًا تفسير "الطردي".
ومعنى قولي: (أَشْبَهَا) أي: أَشْبَه كُلًّا منهما.
والحاصل أن "الشَّبَه" مَنزله بين منزلتين، فهو يشبه المناسب الذاتي من حيث التفات الشرع إليه، ويُشبه الوصف الطردي مِن حيث إنه غير مناسب.
فهو يتميز عن "المناِسب" بأنه غير مناسب بالذات، وبأنَّ مناسبة المناسب عقلية وإنْ لم يَرِدْ شرْع، كالإسكار في التحريم، بخلاف الشَّبَه. ويتميز عن الطردي بأنَّ وجود الطردي كالعدم، بخلاف الشَّبَه، فإنه يُعتبر في بعض الأحكام. وسيتضح ذلك بالأمثلة.
الثانية: وبها قال القاضي أبو بكر وقضية ما في "البرهان" لإمام الحرمين: أنَّ الوصف المقارِن للحكم إنْ ناسَبَه بالذات فهو "مناسب"، كالسكْر للتحريم، أو بِالتبع -أيْ بالالتزام- فهو "الشَّبَه"، كالطهارة لاشتراط النية، فإنَّ الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية، إنما تناسبه مِن حيث إنها عبادة.
فإن لم يناممبه مطلقًا فهو "الطرد"، وهو حُكم لا يعضده معنى ولا شَبَه، كقول بعضهم: الخل مائع لا تبنى القنطرة على جِنسه، فلا تُزال به النجاسة كالدهن. فكأنَّ عِلة إزالة النجاسة بالماء أنه تُبنى القنطرة على جِنسه. فالماء القليل وإنْ لم تُبْنَ عليه القنطرة لكن تُبْنَى على جنسه.
ونحو ذلك: قول مَن يرى طهورية [المستعمل] (¬1): ما تُبنى القنطرة على جنسه فجازت الطهارة به؛ قياسًا على غير المستعمل. فبناء القنطرة في ذلك لا مناسبة فيه، ولا معنى له، بل
¬__________
(¬1) في (ت): المستعمل هنا.