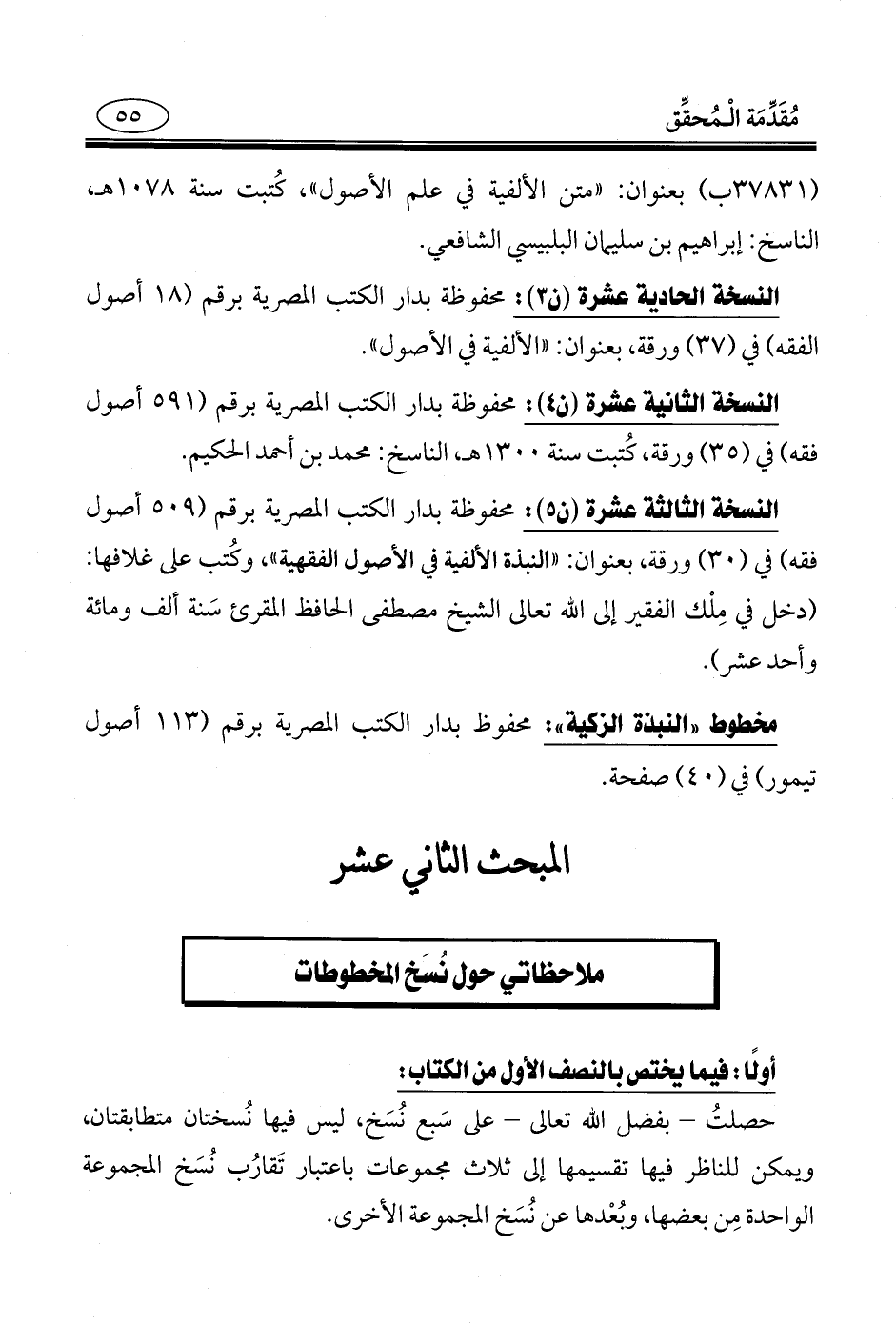
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
بعنوان: "متن الألفية في علم الأصول"، كُتبت سنة 1078 هـ، الناسخ: إبراهيم بن سليمان البلبيسي الشافعي.النسخة الحادية عشرة (ق 3): محفوظة بدار الكتب المصرية برقم (18 أصول الفقه) في (37) ورقة، بعنوان: "الألفية في الأصول".
النسخة الثانية عشرة (ن 4): محفوظة بدار الكتب المصرية برقم (591 أصول فقه) في (35) ورقة، كُتبت سنة 1300 هـ، الناسخ: محمد بن أحمد الحكيم.
النسخة الثالثة عشرة (ن 5): محفوظة بدار الكتب المصرية برقم (509 أصول فقه) في (30) ورقة، بعنوان: "النبذة الألفية في الأصول الفقهية"، وكُتب على غلافها: (دخل في مِلْك الفقير إلى الله تعالى الشيخ مصطفى الحافظ المقرئ سَنة ألف ومائة وأحد عشر).
مخطوط "النبذة الزكية": محفوظ بدار الكتب المصرية برقم (113 أصول تيمور) في (40) صفحة.
المبحث الثاني عشر: ملاحظاتي حول نُسَخ المخطوطات
أولًا: فيما يختص بالنصف الأول من الكتاب:
حصلتُ - بفضل الله تعالى - على سَبع نُسَخ، ليس فيها نُسختان متطابقتان، ويمكن للناظر فيها تقسيمها إلى ثلاث مجموعات باعتبار تَقارُب نُسَخ المجموعة الواحدة مِن بعضها، وبُعْدها عن نُسَخ المجموعة الأخرى.
وما قاله من أن الإصرار على الصغيرة صغيرة هو وجه نقله الدبيلي من أصحابنا في "أدب القضاء"، والمذهب خِلافُه.
وقولي: (أَيِ الْإكْثَارَا) تفسير للإصرار، وأن المراد به الإصرار الفعلي، لا الحكمي.
قال ابن الرفعة: ولم أظفر في ضابطه بما يثلج الصدر، وقد عبَّر عنه بعضهم بالمداومة، وحينئذ فهل المعتبر المداومة على نوع واحد من الصغائر؟ أو الإكثار من الصغائر سواء أكانت من نوع واحد أو أنواع؟
ويخرج من كلام الأصحاب فيه وجهان.
قال الرافعي: (ويوافق الثاني قول الجمهور: مَن تغلب معاصيه طاعتَه، كان مردود الشهادة).
قال: (وإذا قلنا به، لم تضر المداومة على نوع واحد من الصغائر إذا غلبت الطاعات. وعلى الأول يضر) (¬1).
لكن قال ابن الرفعة: (إن قضية كلامه أن مداومة النوع تضر على الوجهين، أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فإنه في ضمن حكايته قال: إن الإكثار من النوع الواحد كالإكثار من الأنواع، وحينئذ لا يَحسُنُ معه التفصيل. نعم، يظهر أثرهما فيما لو أتى بأنواع من الصغائر: إنْ قُلنا بالأول، لم يضر، وإنْ قُلنا بالثاني، ضَر). انتهى
واعلم أن صاحب "المهمات" زعم أن الرافعي والنووي قد خالفا ما قالاه من ذلك في كتاب الشهادات بما ذكراه في الرضاع وفي النكاح آخِر الكلام على ولاية الفاسق أن العضل إذا تكرر، يكون فسقًا، وأن أقَل التكرر فيما حكاه بعضهم ثلاث. نعم، هل الثلاث باعتبار أنكحة ثلاث؟ أو باعتبار عرض الحاكم مرات وإن كان في النكاح الواحد؟ فيه نظر. انتهى
¬__________
(¬1) العزيز شرح الوجيز (13/ 9).
فهو تفصيل حَسَن، والله أعلم.
ص:
472 - وَالشَّرْطُ، وَالْغَايَةُ، حَصْرٌ أُبْرِ مَا ... بِـ "النَّفْيِ وَاسْتِثْنَاءٍ" اوْ بِـ "إنَّمَا"
473 - أَوْ بِضَمِيرِ الْفَصْلِ، أَوْ تَقْدِيمِ ... مَعْمُولٍ انْ عُدَّ مِنَ الْمَفْهُومِ
الشرح:
أي: مِن أقسام مفهوم المخالفة مفهوم الشرط، فقولي: (وَالشَّرْطُ) عطف على قولي: (الْوَصْفُ). فلمَّا فرغتُ مِن الوصف وأقسامه شرعتُ في بيان باقي المفاهيم، وقد اشتمل البيتان منها على أقسام:
أحدها: "الشرط":
والمراد به ما علق مِن الحكم على شيء بأداة شرط كـ "إنْ" و "إذَا" ونحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي، وليس المراد الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع السابق بيانهما في خطاب الوضع.
مثال الشرط اللغوي: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6] دَلَّ منطوقه على وجوب النفقة على أُولات الحمل، فهل دَلَّ بالمفهوم بالعدم على العدم حتى يُستدل به على منع وجوب النفقة للمعتدة [غير الحامل] (¬1)؟ أوْ لا؟
ذهب الشافعي إلى دلالته عليه، وكُل مَن قال بمفهوم الصفة يقول به؛ لأنه أقوى منه. وأما المنكِرون له فاختلفوا، فقال به ابن سريج وابن الصباغ والكرخي وأبو الحسين
¬__________
(¬1) في سائر النُّسخ: الحامل. ولعلها: الحائل.
فهذا القسم الذي لا يصح فيه تسلط العامل أو يقال: (إنه لا يغني) كيف يقال: إنه مخرج تقديرا؟
ومحل بسطه النحو.
الثاني:
ما ذكرته مِن كون المخَصص مِن الاستثناء هو المتصل؛ لأن المنقطع لا إخراج به - هو ظاهر كلام الأكثر.
وزعم بعضهم أنه تخصيص، قال ابن عطية في "تفسيره": (يخصص تخصيصًا ما، لا كالمتصل) (¬1).
فإنْ زعم هؤلاء أنه بالتأويل يصير فيه إخراج ولو من مفهوم المذكور أو من لازِمه، فما جعلوه تخصيصًا إلا بِرَدِّه للمتصل، بل يكون هذا شُبهة لمن أنكر الاستثناء المنقطع في كلام العرب وبعضهم في القرآن؛ لأن المذكور منه يمكن رده للمتصل. فالنزاع راجع للفظ.
ولهذا نقل الأستاذ أبو إسحاق الاتفاق على صحة الاستثناء من غير الجنس، فإذا قال: (له علَيَّ عشرة إلا ثوبًا)، رجع الاستثناء إلى قيمة الثوب. فإن كانت أكثر منه أو مساوية، بطل الاستثناء؛ لكونه مستغرقًا في الأصح.
قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو قال: "له علَيَّ ألف إلا عبدًا"، قُبِل منه (¬2).
أي: إذا اعتُبِرَت قيمتُه فكانت أقَل.
وممن منع المنقطع إلْكِيَا وابن برهان، ونقله عن الحنفية الأستاذ أبو منصور وابن
¬__________
(¬1) عبارته في المحرر الوجيز (3/ 482): (وهذا الاستثناء المنقطع يخصص تخصيصًا ما، وليس كالمتصل).
(¬2) انظر: الأم (6/ 223).
أمر طردي.
فحاصل تفسير القاضي للشَّبَه أنه وَصْف مُقارِن للحكم مُناِسبٌ له بالتَّبع. أو يقال: مُستلْزِم لِمَا يناسبه. هذا ما نُقل عن القاضي، لكن الذي في "مختصر التقريب والإرشاد" أنَّ "قياس الشَّبَه" هو: إلحاق فرع بأصل؛ لكثرة أشباهه للأصل في الأوصاف مِن غَيْر أنْ يُعتقد أنَّ الأوصاف التي شابَهَ الفرعُ فيها الأصلَ عِلةُ حُكمِ الأصل.
الثالثة: أن الوصف الذي لا يناسب الحكم إنْ عُلِم اعتبار جنسه القريب في جنس الحكم القريب فهو "الشَّبه"؛ لأنه مِن حيث كونه غير مناسب يُظن عدم اعتباره، ومِن حيث إنه عُرِف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم مع أنَّ غيره مِن الأوصاف ليس كذلك يُظَن أنه أَوْلَى بالاعتبار؛ فتَردَّد بين أن يكون معتبرًا أو لا.
وإنْ لم يُعْلم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب للحكم فهو الطرد.
مثال الشبه: إيجاب المهر بالخلوة على القول القديم للشافعي، فإنَّ الخلوة لا تناسب وجوب المهر؛ لأن وجوبه في مقابلة الوطء إلا أنَّ جنس هذا الوصف - وهو كون الخلوة مظنة الوطء - مُعتبَر في جنس الوجوب وهو الحكم بتحريم الخلوة بالأجنبية.
الرابعة: أنَّ "الشبه" هو: الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام، ولكن أُلِفَ مِن الشرع الالتفات إليه في بعض الأحكام، فهو دُون المناسب وفوق الطردي؛ فلذلك سُمي "شبهًا"؛ لِشبهِهِ لكل منهما.
وذلك كقول الشافعي في إزالة النجاسة: طهارة تُراد لأجل الصلاة، فلا تجوز بغير الماء، كطهارة الحدث. فإنَّ الجامع هو الطهارة، ومناسبتها لِتَعَيُّن الماء فيها بعد البحث التام غير ظاهرة. وبالنسبة إلى كون الشارع اعتبرها في بعض الأحكام -كمس المصحف والصلاة والطواف- يُوهِم اشتمالها على المناسب.