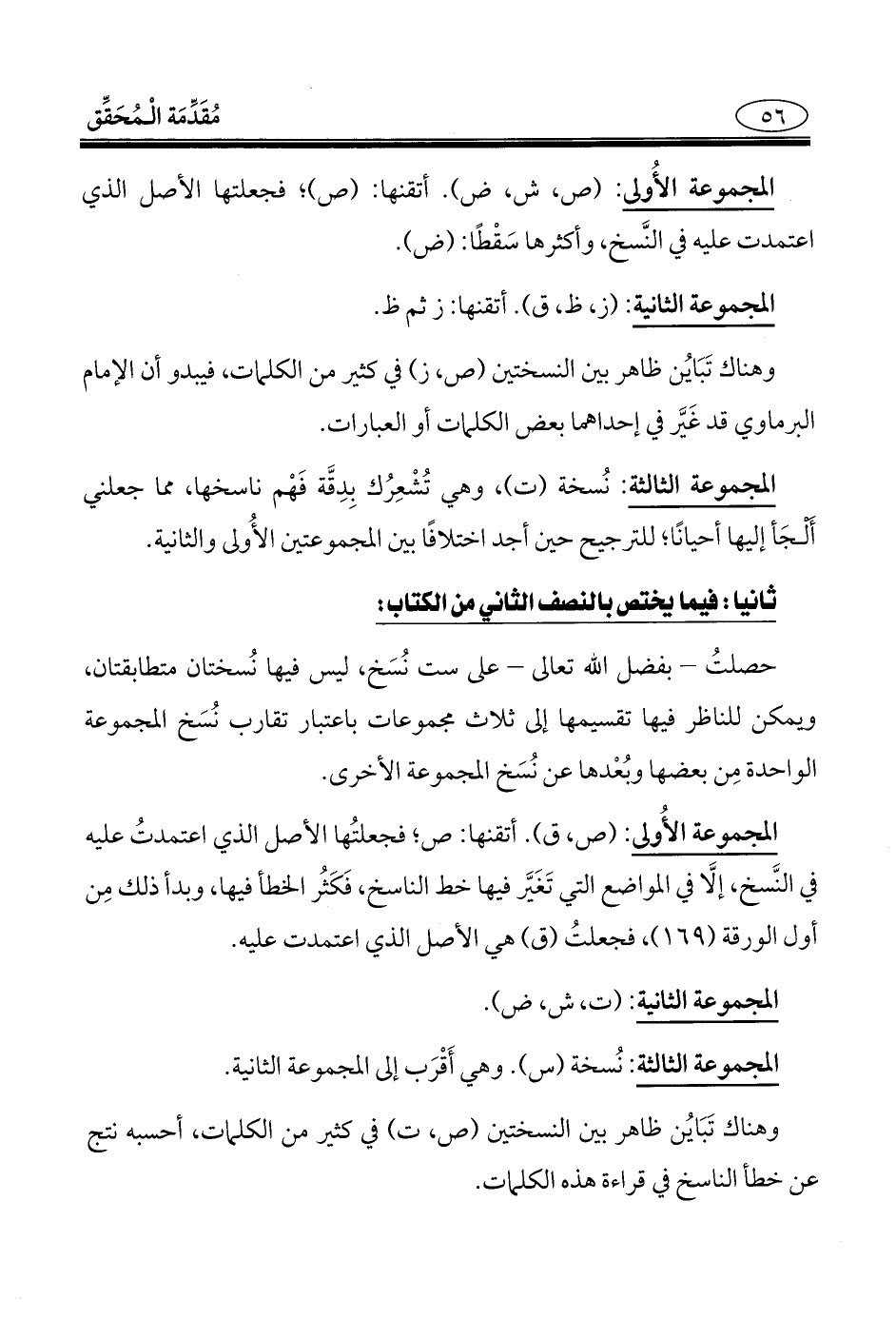
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
المجموعة الأُولى: (ص، ش، ض). أتقنها: (ص)؛ فجعلتها الأصل الذي اعتمدت عليه في النَّسخ، وأكثرها سَقْطًا: (ض).المجموعة الثانية: (ز، ظ، ق). أتقنها: ز ثم ظ.
وهناك تَبَايُن ظاهر بين النسختين (ص، ز) في كثير من الكلمات، فيبدو أن الإمام البرماوي قد غَيَّر في إحداهما بعض الكلمات أو العبارات.
المجموعة الثالثة: نُسخة (ت)، وهي تُشْعِرُك بِدِقَّة فَهْم ناسخها، مما جعلني أَلْجَأ إليها أحيانًا؛ للترجيح حين أجد اختلافًا بين المجموعتين الأُولى والثانية.
ثانيًا: فيما يختص بالنصف الثاني من الكتاب:
حصلتُ - بفضل الله تعالى - على ست نُسَخ، ليس فيها نُسختان متطابقتان، ويمكن للناظر فيها تقسيمها إلى ثلاث مجموعات باعتبار تقارب نُسَخ المجموعة الواحدة مِن بعضها وبُعْدها عن نُسَخ المجموعة الأخرى.
المجموعة الأُولى: (ص، ق). أتقنها: ص؛ فجعلتُها الأصل الذي اعتمدتُ عليه في النَّسخ، إلَّا في المواضع التي تَغَيَّر فيها خط الناسخ، فَكَثُر الخطأ فيها، وبدأ ذلك مِن أول الورقة (169)، فجعلتُ (ق) هي الأصل الذي اعتمدت عليه.
المجموعة الثانية: (ت، ش، ض).
المجموعة الثالثة: نُسخة (س). وهي أَقْرَب إلى المجموعة الثانية.
وهناك تَبَايُن ظاهر بين النسختين (ص، ت) في كثير من الكلمات، أحسبه نتج عن خطأ الناسخ في قراءة هذه الكلمات.
قلت: لكن سبق من كلام ابن الرفعة ما يلزم منه موافقة ما في النكاح لِمَا في الشهادات، فلا تناقض.
أما الإصرار الحكمي - وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها - فقيل: حُكمه حُكم مَن كررها فعلًا، بخلاف التائب منها. وفيه نظر ظاهر.
[تنبيهان]
الأول: بين العدالة وبين التقوى عموم وخصوص مِن وَجْه؛ لأن التقوى [تفسَّر] (¬1) بأن يُطاع الله، فلا يُعصَى، [فيحذر] (¬2) العبد بطاعته تعالى عن عقوبته، فيتقي الشرك، ثم المعاصي، ثم يتقي الشبهات، ثم يتقي الفضلات عن حاجته، ولا يشترط أن يكون عنده ملكة في ذلك.
والعدالة مَلَكَة، ولا يشترط فيها ترك المعاصي كلها، بل الكبائر والإصرار على الصغائر كما سبق.
الثاني: تفسير "العدالة" بما سبق يتضمن اعتبار البلوغ -[بما] (¬3) سنقرره - والعقل والإسلام فيمن يتصف بها، وكذا عدم المفسق.
فَجَعْل الثلاثة الأوُلى شروطًا زائدة على العدالة مغايرة لها - ليس تحقيقًا، إلا أنْ يراد بذلك الإيضاح بالتصريح وزيادة البيان بكثرة الشروط، فلذلك عقبت تفسير "العدالة" بما يخرج عن الأمور المذكورة بِقَوْلي:
¬__________
(¬1) في (ز): مفسرة. وفي (ش): مفسر.
(¬2) في (ز): فيحترز. وفي (ش): فيتحرز.
(¬3) في (ز): لما.
البصري، ونقله إمام الحرمين عن أكثر العلماء وبالغ في الرد على مُنكِره، وابن القشيري عن معظم أهل العراق، وأبو الحسن السهيلي في "أدب الجدل" عن أكثر الحنفية.
وذهب أكثر المعتزلة -كما قال في "المحصول"- إلى المنع، وقالوا: لا ينتفي بعدمه، بل هو باقٍ على الأصل الذي كان قبل التعليق، ورجحه المحققون من الحنفية، ونُقل عن أبي حنيفة، ونقله ابن التلمساني عن مالك، واختاره القاضي والغزالي والآمدي.
فَتَلَخَّص أنه لا خِلاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، لكن هل الدال على الانتفاء صيغة الشرط؟ أو البقاء على الأصل؟
فمَن جعل الشرط حُجة، قال بالأول، ومَن أنكره، قال بالثاني.
وقد احتج القاضي حسين في "باب بيع الأصول والثمار" من "تعليقه " على الحنفية بحديث يعلى بن أُمية أنه قال لعمر بن الخطاب: لماذا نقصر وقد أمِنا وقال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ} [البقرة: 229]؟ فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "صَدَقة تَصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (¬1).
قال: وكانا من صميم العرب وأرباب اللسان، وأن المفهوم إنما تُرك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.
ولا حُجة للمانع في نحو قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور: 33]، لأن الإكراه حرامٌ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا أَم لم يُرِدْن، فلو كان معتبرًا لَتَقَيَّد بإرادة التحصُّن.
بل جوابه:
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (رقم: 686).
القشيري، وحكاه الأستاذ أيضًا عن ابن داود، والباجي عن ابن خويز منداد.
وقيل: يقطع بصحته في الإقرار، وفي غيره وجهان. قاله الماوردي.
الثالث:
أُورِد على تعريف الاستثناء المتصل أمور:
ذكر "إلا" ونحوه في التعريف؛ لكونه أداة استثناء، فتَصوُّر ذلك فيه متوقِّف على تَصوُّر الاستثناء، فإذا عَرَّفناه به، كان دَوْرًا.
وجوابه: إنما وقع التعريف بها مِن حيث كونها مخرجة، لا من حيث خصوص الاستثناء، فإنَّ الإخراج أَعَم.
ويجاب بهذا أيضًا عن السؤال في قوله: (ونحوها) أنه إنْ كان من حيث الاستثناء، لَزم الدَّوْر، أو مِن حيث الإخراج في الجملة، دخل التخصيص بالمنفصل وغير الاستثناء من المتصل.
فيقال: المخرج بالوضع إنما هو أدوات الاستثناء، فهو المراد.
ومنها: أهملتم التقييد بكون الاستثناء والمستثنى منه مِن متكلم واحد؛ ليخرج ما لو قال الله تعالى: "اقتلوا المشركين"، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلا أهل الذمة"، فإن ذلك استثناء منفصل، لا متصل.
ولهذا قُيد به في "جمع الجوامع" وضُعِّف مقابِله؛ ولهذا قال الرافعي: لو قال: (لي عليك مائة) فقال: (إلا درهمًا) لم يكن مقرًّا بما عدا المستثنى على الأصح.
وأما استناد مَن جوَّزه مِن متكلِّمَيْن إلى أن المثال السابق في قول الله تعالى وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا بِدع فيه؛ لأن الكلامَيْن كالواحد؛ لأنه مُبلِّغ عن الله، فذاك لخصوص المثال، لا في كل استثناء مِن متكلِّمَين.
وهذا القول نقله الآمدي عن أكثر المحققين، وهو الأقرب إلى قواعد الأصول. وهذا قريب مِن العبارة الأُولى، بل العبارات كلها عند التأمل تكاد أن تتحد.
وإنما قصدنا بذلك زيادة الإيضاح بتكرار معنى "الشَّبَه" بعبارات مختلفة. وقد قال إمام الحرمين: إنه لا يتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة الحدود.
قولي: (مُعْتَبرٌ) إلى آخِره هو "خبر" المبتدأ وهو "الَّذِي يُسَمَّى".
والغرض بذلك أنه إذا عُرف معنى "الشَّبه" فهل يجوز التعليل به؟ أولا؟
فيه مذاهب:
أرجحها المنقول عن الشافعي: نعم، لكن بشرط أن لا يكون هناك وصف مناسب يُعَلَّل به. فقد قال القاضي في "التقريب": أجمع الناس على أنه لا يُصار إلى قياس الشَّبه مع إمكان قياس العِلة. فالخلاف إنما هو فيما تَعذَّر فيه قياس العلة ولم يوجد إلا الوصف الشبهي؛ فيكون علة. وكان قدماء أصحابنا يستعملونه في المناظرات.
قال ابن السمعاني: (وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج به في مواضع مِن كُتبه، كقوله في إيجاب النية في الوضوء كالتيمم: طهارتان، فكيف تفترقان؟ ) (¬1). وغير ذلك.
ودليل الاحتجاج به أنه يفيد ظن وجود العلة، أمَّا على القول بأن له مناسبة ما فظاهر، وأمَّا على الباقي فلأنه لا بُدَّ للحكم مِن علة؛ لأنه لا يُشرع إلا لحكمة، وتلك العلة إما هذا الوصف أو غيره، وا لأصل عدم غيره؛ فتعَيَّن.
المذهب الثاني: وهو قول القاضي أبي بكر والصيرفي وأبي إسحاق المروزي والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وأبي زيد الدبوسي وغيره مِن الحنفية: أنه ليس بحجة. لكنه عند القاضي
¬__________
(¬1) قواطع الأدلة في أصول الفقه (2/ 165).