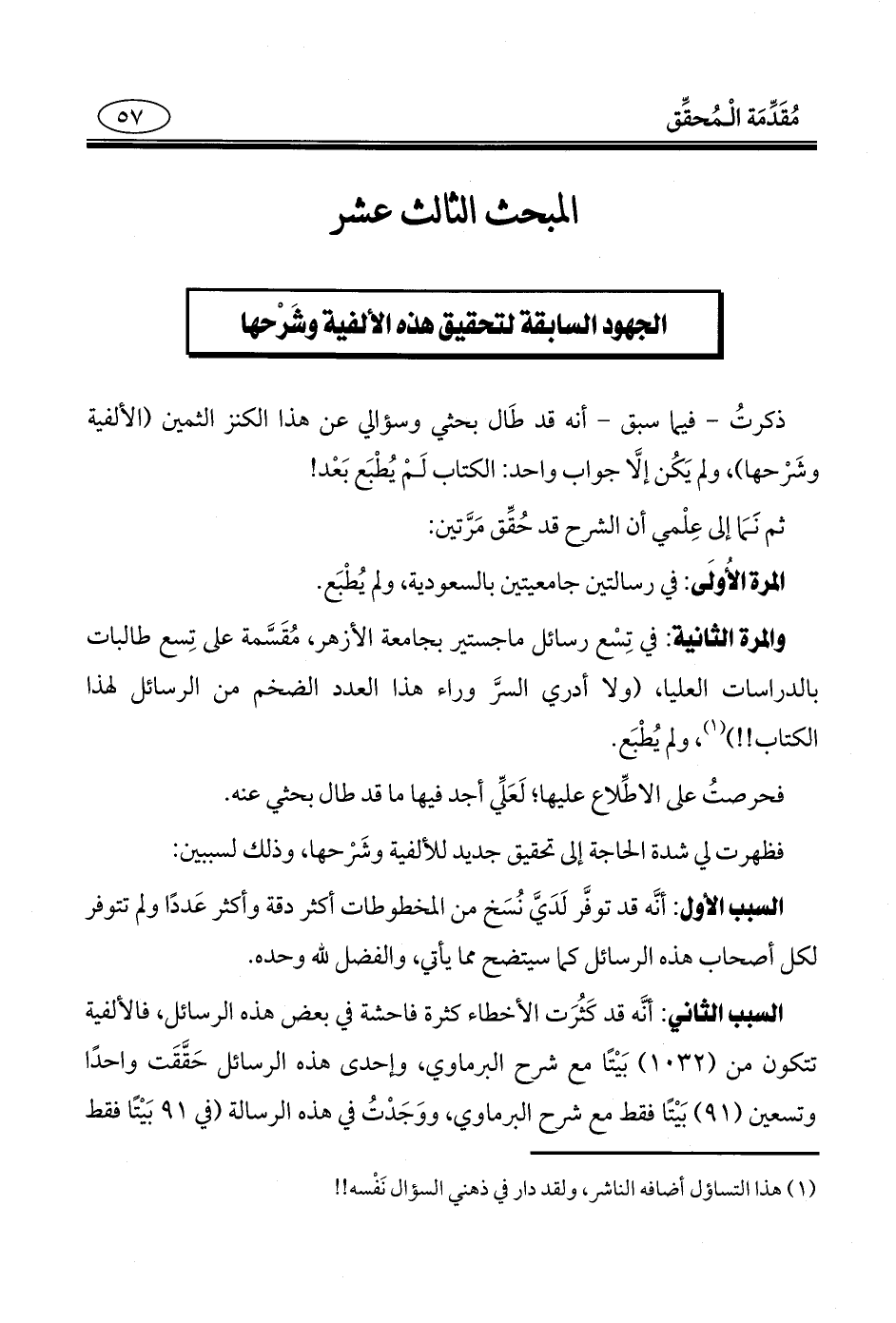
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
المبحث الثالث عشر: الجهود السابقة لتحقيق هذه الألفية وشَرْحهاذكرتُ - فيما سبق - أنه قد طَال بحثي وسؤالي عن هذا الكنز الثمين (الألفية وشَرْحها)، ولم يَكُن إلَّا جواب واحد: الكتاب لَمْ يُطْبَع بَعْد!
ثم نَمَا إلى عِلْمي أن الشرح قد حُقِّق مَرَّتين:
المرة الأُولَى: في رسالتين جامعيتين بالسعودية، ولم يُطْبَع.
والمرة الثانية: في تِسْع رسائل ماجستير بجامعة الأزهر، مُقَسَّمة على تِسع طالبات بالدراسات العليا، (ولا أدري السرَّ وراء هذا العدد الضخم من الرسائل لهذا الكتاب! ! ) (¬1)، ولم يُطْبَع.
فحرصتُ على الاطِّلاع عليها؛ لَعَلِّي أجد فيها ما قد طال بحثي عنه.
فظهرت لي شدة الحاجة إلى تحقيق جديد للألفية وشَرْحها، وذلك لسببين:
السبب الأول: أنَّه قد توفَّر لَدَيَّ نُسَخ من المخطوطات أكثر دقة وأكثر عَددًا ولم تتوفر لكل أصحاب هذه الرسائل كما سيتضح مما يأتي، والفضل لله وحده.
السبب الثاني: أنَّه قد كَثُرَت الأخطاء كثرة فاحشة في بعض هذه الرسائل، فالألفية تتكون من (1032) بَيْتًا مع شرح البرماوي، وإحدى هذه الرسائل حَقَّقَت واحدًا وتسعين (91) بَيْتًا فقط مع شرح البرماوي، ووَجَدْتُ في هذه الرسالة (في 91 بَيْتًا فقط
¬__________
(¬1) هذا التساؤل أضافه الناشر، ولقد دار في ذهني السؤال نَفْسه! !
ص:
285 - فَيَخْرُجُ الْمَجْنُونُ وَالصَّبِيُّ ... وَكَافِرٌ وَفَاسِقٌ [مَقْضِيُّ] (¬1)
الشرح:
أما خروج المجنون بِقَيْد العقل الذي تضمنته الملَكَة فواضح، وأما الصبي فإنه وإنْ [وافق سلامته] (¬2) مما يَفسُقُ به غيره فليس ذلك لملَكَة قائمة به، بل على سبيل الاتفاق، وحينئذ فيضْعُف بذلك دعوى مَن يَصِف الصبي بالعدالة، وأن البلوغ إنما هو شرط لقبول روايته أو شهادته ونحو ذلك.
وأما الكافر فمنفي عنه هذه الملكة قطعًا، ووصفه بأنه عدل في دينه (في نحو ولاية النكاح ونظر الوقف والوصاية على الكفار ونحو ذلك) إنما هو بالنسبة لمعتقدهم، فهي ملكة نسبية، لا على الإطلاق، وهي العدالة الحقيقية التي هي شرط هنا، وسيأتي في ذلك مزيد بيان في مرتكب الفسق في اعتقاده دُون نفس الأمر وعكسه.
ومن اللطائف في رواية الكافر ما رواه أحمد في مسنده عن عروة بن عمرو الثقفي: سمعت أبا طالب -يعني عَمَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -- قال: سمعتُ الأمين ابن أخي يقول: "اشكُر تُرزَق، ولا تكفر فتُعذب" (¬3). ورواه الحافظ الصريفيني، وقال: غريب رواية أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) في (ز، ق، ت، ن 3، ن 4): مقصي. وفي (ص، ض، ظ، ش، ن 1، ن 2، ن 5): مقضي. مقصي: تم اقصاؤه. مقضي: قضي بفسقه.
(¬2) كذا في (ت). لكن في (ز): وفق لسلامه. وفي (ص، ض، ق، ظ): وافق لسلامته.
(¬3) لم أجده في "مسند أحمد"، وقال السخاوي في "فتح المغيث، 2/ 5": (لا يصح).
- أنه مما خرج مخرج الغالب؛ إذِ الغالب أن الإكراه يكون عند إرادة التحصن، فلا يعمل بمفهومه كما سبق.
- وأنه مُعارَض بالإجماع على تحريم الإكراه على البغاء مطلقًا، فلا يُعمل بالمفهوم مع مُعارَضة الإجماع.
وهذان أجاب بهما ابن الحاجب، وأَحسن منهما الجواب بأنه لا يُتصور الإكراه عند عدم إرادة التحصن؛ لأن اجمراه حَمْلُ المرء على ما يَكره، فإذا لم يُتصور الإكراه، جاز أن يقول: ليس بحرام؛ لأنه غير متصور، والتحريم فرع كونه مُتصوَّرًا.
وعلى هذا فالفائدة في الشرط التنصيص على قُبح فعلهم وتشنيعه عليهم، وإنما يُعتبر مفهوم الشرط وغيره حيث لم يظهر للتخصيص فائدة كما سبق، وقد ظهر للتقييد -بإرادة التحصن- فائدة كما قررناه.
ومِثله: {وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة: 172]، وقول القائل لابنه: (أطعني إنْ كنتَ ابني)، فإنَّ المراد التنبيه على السبب الباعث للحكم، لا تقييد الحكم به.
تنبيه:
حرف هذه المسألة الذي نشأ منه الخلاف فيها أن لفظ "أنت طالق" و"أنت حر" مثلًا عِلة في حصول الطلاق والعتق، فإذا قُيد بشرطٍ كـ "أنت طالق -أو حر- إنْ دخلت الدار"، فيقال: إن دخول الشرط هل يمنع انعقاد العِلة؟ أو لا يمنع إلا الحكم؟
فعند الحنفية يمنع انعقاد العلة، وعندنا لا يمنع. فإذا بقيت العلة منعقدة مع وجدان الشرط، أَوجبت الحكم عند وجود المعلق عليه و [نَفَتْه] (¬1) عند عدمه. وأما عندهم فإذا
¬__________
(¬1) كذا في (ص، ش، ض). لكن في (ز، ت، ق، ظ): نفيه.
ولذلك احْتِيج في: (قول العباس - رضي الله عنه - بعد قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يُخْتَلَى خلاها": إلا الإذخر. فقال: "إلا الإذخر") (¬1) إلى تأويله بأن العباس أراد أن يُذكره - صلى الله عليه وسلم - بالاستثناء؛ خشية أن يسكت عنه اتكالًا على فَهم السامع ذلك بقرينة وفهمًا منه أنه يريد استثناءه؛ ولأجل ذلك أعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستثناء فقال: "إلا الإذخر". ولم يكتف باستثناء العباس.
فكل ذلك يرشد إلى اعتبار كونه من متكلم واحد.
وجوابه: أن اشتراط الاتصال كافٍ في ذلك، فإنه ليس المراد به مجرد اتصال زمانه بزمان المستثنى منه، بل تعقيب المتكلِّم كلامه بكلامه؛ للارتباط في نطقه.
ولذلك شُرِطت فيه نيته قبل أن يفرغ مِن المستثنى منه، أو مِن أوله على رأْيٍ مرجوح كما بُيِّن في الفقه على اضطراب فيه وقع للرافعي.
فإنْ فُرض أن المتكلم بالمستثنى منه اتكل على المتكلم بالاستثناء، فالأول لم يستثن، والثاني لم ينطق بمفيد؛ لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه.
وقد سبق في مباحث اللغة أن الكلام هل يشترط فيه أن يكون من واحد؟ أوْ لا؟ وأن ابن مالك رد على مَن اشترطه، وأن التحقيق فيه أن الإسناد إنْ صدر مِن كل مِن القائل: (زيد) والقائل: (قائم)، فكل منهما متكلم بكلام ذكر بعضه وحذف الآخَر لِقرينة تَكلُّم الآخر، والحذفُ للقرينة اللفظية في المبتدأ والخبر وفي الفعل ومرفوعه جائزٌ. وإنْ لم يكن لأحدهما قصد ولا إسناد فلا كلام لا مِن هذا ولا مِن هذا.
الرابع:
اختُلف في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب منشأها إشكال في معقولية الاستثناء.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (112)، صحيح مسلم (1355).
صالح لأنْ يُرَجَّح به كما ذكره في "باب ترجيح العلل" من "التقريب"، وقال: إن اعتبار الشَّبه يؤثَر عن الشافعي، ولا يكاد يصح عنه مع عُلو رُتْبَتِه في الأصول.
وجنح الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى حمل ما نُقل عن الشافعي مِن ذلك على الترجيح، وقال: إنما أراد الشافعي ترجيح إحدى العِلتين في الفرع؛ لكثرة الشَّبه.
الثالث: أنَّ الشَّبه إنما يُحتج به في التعليل إذا كان في قياس فرع قد اجتذبه أصلان، فَيلْحَق بأحدهما [بِغَلَبَة] (¬1) الأشباه، ويسمونه "قياس [غَلَبَة] (¬2) الأَشْبَاه"، وهو ما يدل عليه نَص الشافعي في "الأُم" الآتي ذِكره بعد ذلك. لكن على القول الأول إنما يكون هذا أرجح أقسام الشَّبه، لا أنَّ اعتباره مُتَعَين.
نعم، على القول بأنَّ الشَّبه حُجة خِلاف آخَر وهو أنَّ الشافعي يعتبر المشابهة في الحكم؛ ولهذا أَلحقَ العبد المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته على القاتل بجامع أنَّ كلَّ واحدٍ منهما يُباع ويُشترى.
ومن أمثلته: أنْ نقول في الترتيب في الوضوء: عبادة يُبْطِلها الحدَث؛ فكان الترتيب فيها مستحقًّا، أَصْلُه الصلاة. فالمشابهة في الحكم الذي هو البطلان بالحدَث، ولا تَعَلُّق له بالترتيب، وإنما هو مجرد شبه.
ومنها: الأخ لا يستحق النفقة على أخيه؛ لأنه لا تحرم منكوحة أحدهما على الآخَر؛ فلا يستحق النفقة، كقرابة بَنِي العَم.
واعتبر أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن عُليَّة المشابهة في الصورة دون الحكم، كقياس الخيل على البغال والحمير في سقوط الزكاة. وقياس الحنفية في حرمة اللحم، وكَرَدِّ وطء
¬__________
(¬1) في (ص، ق، ش): بعلة.
(¬2) في (ص، ق، ض): (علة). وقد يمرر ذلك في مواضع تأتي، فَلَم أُنبِّه عليه.