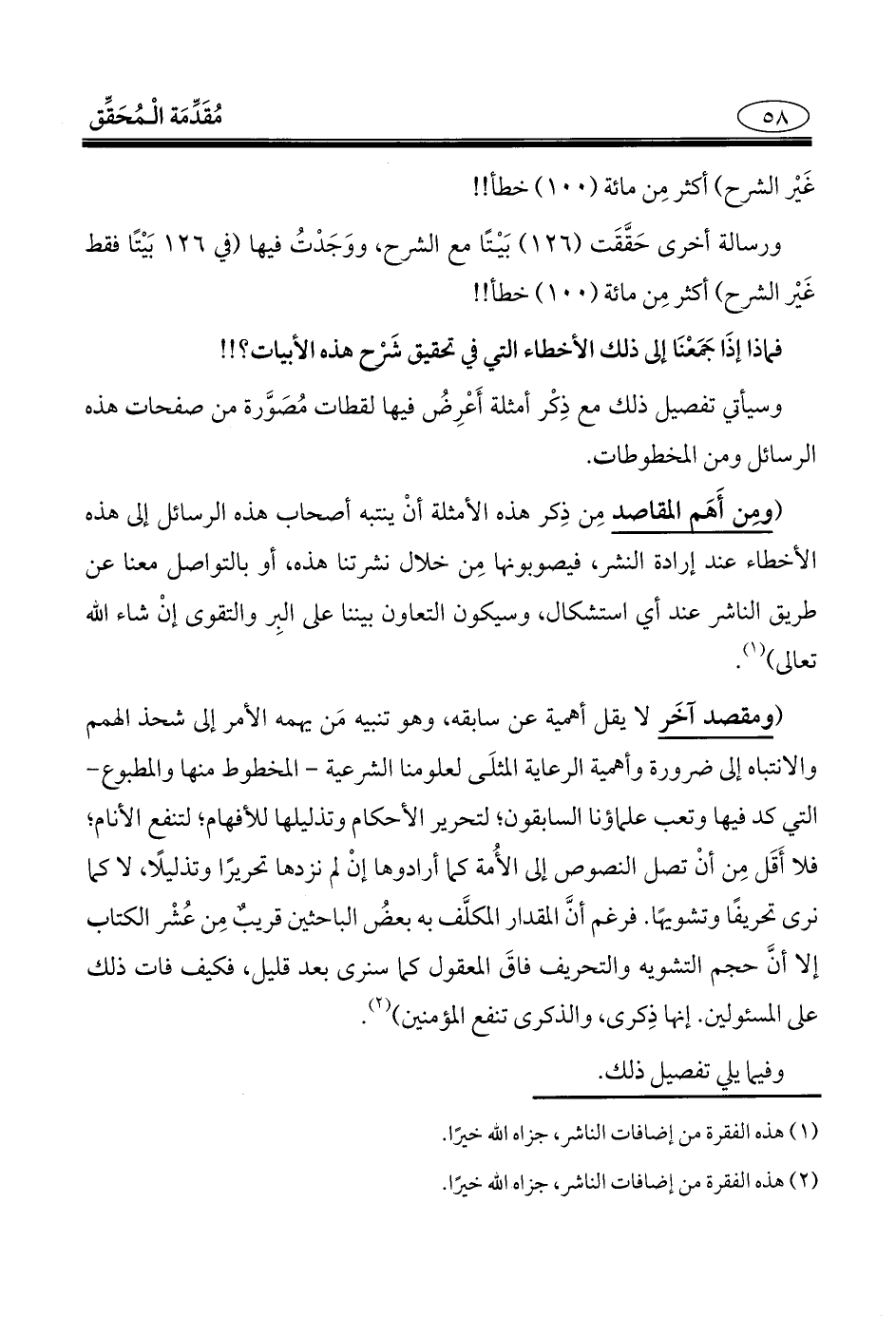
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
غَيْر الشرح) أكثر مِن مائة (100) خطأ! !ورسالة أخرى حَقَّقَت (126) بَيْتًا مع الشرح، ووَجَدْتُ فيها (في 126 بَيْتًا فقط غَيْر الشرح) أكثر مِن مائة (100) خطأ! !
فماذا إذَا جَمَعْنَا إلى ذلك الأخطاء التي في تحقيق شَرْح هذه الأبيات؟ ! !
وسيأتي تفصيل ذلك مع ذِكْر أمثلة أَعْرِضُ فيها لقطات مُصَوَّرة من صفحات هذه الرسائل ومن المخطوطات.
(ومِن أَهَم المقاصد مِن ذِكر هذه الأمثلة أنْ ينتبه أصحاب هذه الرسائل إلى هذه الأخطاء عند إرادة النشر، فيصوبونها مِن خلال نشرتنا هذه، أو بالتواصل معنا عن طريق الناشر عند أي استشكال، وسيكون التعاون بيننا على البِر والتقوى إنْ شاء الله تعالى) (¬1).
(ومقصد آخَر لا يقل أهمية عن سابقه، وهو تنبيه مَن يهمه الأمر إلى شحذ الهمم والانتباه إلى ضرورة وأهمية الرعاية المثلَى لعلومنا الشرعية - المخطوط منها والمطبوع - التي كد فيها وتعب علماؤنا السابقون؛ لتحرير الأحكام وتذليلها للأفهام؛ لتنفع الأنام؛ فلا أَقَل مِن أنْ تصل النصوص إلى الأُمة كما أرادوها إنْ لم نزدها تحريرًا وتذليلًا، لا كما نرى تحريفًا وتشويهًا. فرغم أنَّ المقدار المكلَّف به بعضُ الباحثين قريبٌ مِن عُشْر الكتاب إلا أنَّ حجم التشويه والتحريف فاقَ المعقول كما سنرى بعد قليل، فكيف فات ذلك على المسئولين. إنها ذِكرى، والذكرى تنفع المؤمنين) (¬2).
وفيما يلي تفصيل ذلك.
¬__________
(¬1) هذه الفقرة من إضافات الناشر، جزاه الله خيرًا.
(¬2) هذه الفقرة من إضافات الناشر، جزاه الله خيرًا.
واعْلَم أن الصبي أَعَم مِن أن يكون مميِّزًا أو غير مميز، فإن الجمهور على عدم قبول المميز في الرواية والشهادة؛ لاحتمال كذبه، كما في الفاسق، بل أَوْلى؛ لِعِلْمه بأنه غير مُكلَّف، وأنه غير مؤاخَذ بالكذب؛ لأجل ذلك فلا واخ له عن ارتكابه، ولأن الصحابة لم يقبلوا إلا بالغًا، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُرسل لتبليغ شرعه إلا بالغًا. وهذان الأمران هما العمدة في تثبيت خبر الواحد.
وقيل: يُقبَل الصبي الموثوق به؛ لِغَلبة الظن بصدقه.
ويردُّه ما سبق، بل في "مختصر التقريب" للقاضي أبي بكر أنه لا يُقْبَل بالإجماع. لكن ردَّه ابن القشيري بأن الخلاف فيه شهير، أيْ: للأصوليين والمحدثين والفقهاء. وقد حكى فيه إمام الحرمين وجهًا، بل حكى القاضي الحسين الخلاف قولين للشافعي في إخباره عن القبلة، وجرى عليه الرافعي والنووي، وقيَّداه بالمميز، وحكيا في باب التيمم فيه وجهين أيضًا، إلا أنهما قيداه بالمراهق. ونقل التفصيل بين المراهق وغيره أيضًا ابن عَقيل الحنبلي في كتاب "الواضح"، بل في "المنخول" للغزالي أن محل الخلاف في المراهق الثبت، وستأتي مسائل كثيرة من ذلك.
وفي المسألة قول رابع للمالكية: إنه يُقبل في الدماء دُون غيرها، قال ابن الحاجب في "مختصر الأصول": (وأما إجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل تفرقهم فمستثنى؛ لكثرة الجناية بينهم منفردين) (¬1).
أيْ على أصل المالكية.
لكن انتقد عليه في ادعاء إجماع المدينة، فالمشهور في كتبهم إنما هو نَقْله عن علي ومعاوية وعروة بن الزبير وشريح وعمر بن عبد العزيز. بل قال ابن حزم: لا نعلم أحدًا قبل مالك
¬__________
(¬1) مختصر منتهى السؤل والأمل (1/ 559)، الناشر: دار ابن حزم.
انتفت العلة، لم يكن انتفاء الحكم مسندًا إلى انتفائها.
والخلاف بين الفريقين في ذلك طويل، محله ما وُضع للحجاج.
الثاني: "مفهوم الغاية":
وهي مد الحكم بأداة الغاية كـ "إلى" و"حتى" و"اللام" ونحوها. وألحقَ بعضهم به نحو: "صوموا صومًا آخِره الليل". قال الهندي: وفيه نظر (¬1).
فمثال الغاية [بحرفها] (¬2) قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، وحديث: "لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول" (¬3).
وهو حُجة كما نَص عليه الشافعي، فقال في "الأم": (وما جعل الله تعالى له غاية فالحكم بعد مُضِي الغاية فيه غَيْره قَبْل مُضِيها).
ثم مَثَّله بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] الآية: (وكان في شرط القصر بحالةٍ موصوفةٍ دليلٌ على أن حُكمهم في غير تلك الصفة غير القصر) (¬4). انتهى
وقد اعترف به جمعٌ ممن أنكر مفهوم الشرط، كالقاضي أبي بكر والغزالي والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين، وإليه ذهب مُعظم نُفاة المفهوم كما قاله القاضي في "التقريب"، قال: وكنا
¬__________
(¬1) نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 2087).
(¬2) في (ز): نحو.
(¬3) سنن ابن ماجه (1792)، سنن أبي داود (رقم: 1573). قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: 1573).
(¬4) الأم (5/ 28).
فإنك إذا قلت: (قام القوم إلا زيدًا)، فإنْ لم يكن زيد دخل فيهم، فكيف أُخْرج هذا وقد اتفق أهل العربية على أنه إخراج؟ وإنْ كان دخل، فتناقَض أول الكلام وآخِره.
وكذا نحو: (له علَيَّ عشرة إلا درهمًا)، بل أَبْلغ؛ لأن العدد نَص في مدلوله، والعام فيه الخلاف السابق.
وذلك يؤدي إلى نفي الاستثناء من كلام العرب؛ لأنه كذب على هذا التقدير في أحد الطرفين، ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
أحد المذاهب وبه قال القاضي أبو بكر: أن نحو: "عشرة إلا ثلاثة" مدلوله سبعة، لكن له لفظان، أحدهما: مركَّب، وهو: "عشرة إلا ثلاثة"، والآخَر: "سبعة". وقصد بذلك أن يُفرق بين التخصيص بدليل متصل فيكون الباقي فيه حقيقة، أو بالمنفصل فيكون تناول اللفظ للباقي مجازًا. ووافقه إمام الحرمين على أن ذلك بمنزلة اسمين بالوضع: أحدهما مركب، والآخر مفرد.
والثاني (ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين): أن المراد بِـ "عشرة": سبعة، و"إلا" قرينة بيَّنت أن الكل استُعمل وأُريد به الجزء مجازًا. وعلى هذا فالاستثناء مُبيِّن لغرض المتكلم بالمستثنى منه.
فإذا قال: (علَيَّ عشرة)، كان ظاهرًا في الجميع، ويحتمل إرادة بعضها مجازًا، فإذا قال: (إلا ثلاثة)، فقد بَيَّن أن مراده بِـ "العشرة" سبعة فقط كما في سائر التخصيصات.
واستنكر إمام الحرمين هذا القول، وقال: (إنه مُحَال، لا يعتقده لبيب) (¬1).
والثالث (واختاره ابن الحاجب): أن المراد بالعشرة: عشرة باعتبار أفراده، ولكن لا يُحكم بما أُسنِد إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منها، ففي اللفظ أسند الحكم إلى عشرة، وفي
¬__________
(¬1) البرهان (1/ 270).
الشبهة إلى النكاح في سقوط الحد ووجوب المهر؛ لشبهه بالوطء في النكاح في الأحكام. ويقتضى ذلك قتل الحر بالعبد كما يقول أبو حنيفة؛ ولهذا نقل عنه إمام الحرمين في "البرهان" كابن عُليَّة، وقال: إنه ألحقَ التشهد الثاني بالأول في عدم الوجوب، فقال: تشهُّد؛ فلا يجب، كالتشهد الأول.
ونحو ذلك عن أحمد، إذ قال بوجوب الجلوس للتشهد الأول؛ لأنه أحد الجلوسين في تشهد الصلاة؛ فوجب، كالجلوس الأخير.
وقال الإمام الرازي: (المعتبَر حصول المشابهة فيما يُظَن أنه مُستلزِم لِعِلَّة الحكم، أو أنه عِلة للحكم، سواء أكانت المشابهة في الصورة أو المعنى) (¬1).
ثم الذين قالوا بِعِلية الشبه في الحكم وفي الصورة اختلفوا أَيُّهما أَوْلى؟
فقيل: الشبه في الحكم أَوْلى. وقيل: هو والصوري سواء.
فيتلخص - عند عدم قياس العلة - في الشَّبه سبعة مذاهب:
- البطلان مطلقًا.
- اعتباره في الحكم ثُم في الصورة.
- اعتباره فيهما سواء.
- اعتباره في الحكم فقط.
- في الصورة فقط.
- فيما يُظَن استلزامه للعلة.
- في قياس "غَلَبة الأشباه" فقط، وهو ظاهر نَص الشافعي. إذ قال في "الأم" في "باب
¬__________
(¬1) المحصول في أصول الفقه (5/ 279).