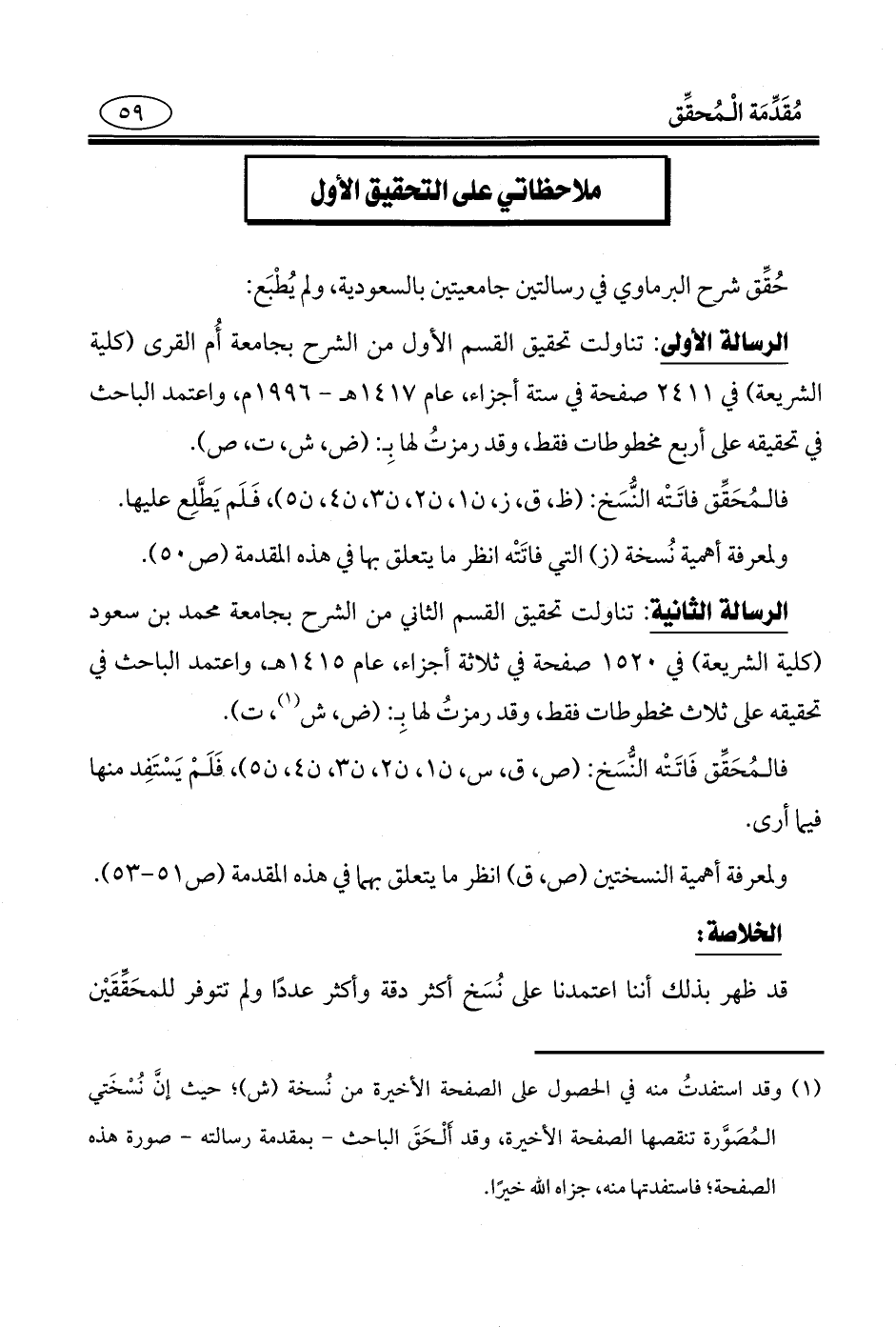
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
ملاحظاتي على التحقيق الأولحُقِّق شرح البرماوي في رسالتين جامعيتين بالسعودية، ولم يُطْبَع:
الرسالة الأولى: تناولت تحقيق القسم الأول من الشرح بجامعة أُم القرى (كلية الشريعة) في 2411 صفحة في ستة أجزاء، عام 1417 هـ - 1996 م، واعتمد الباحث في تحقيقه على أربع مخطوطات فقط، وقد رمزتُ لها بِـ: (ض، ش، ت، ص).
فالمُحَقِّق فاتَتْه النُّسَخ: (ظ، ق، ز، ن 1، ن 2، ن 3، ن 4، ن 5)، فَلَم يَطَّلِع عليها.
ولمعرفة أهمية نُسخة (ز) التي فاتَتْه انظر ما يتعلق بها في هذه المقدمة (ص 50).
الرسالة الثانية: تناولت تحقيق القسم الثاني من الشرح بجامعة محمد بن سعود (كلية الشريعة) في 1520 صفحة في ثلاثة أجزاء، عام 1415 هـ، واعتمد الباحث في تحقيقه على ثلاث مخطوطات فقط، وقد رمزتُ لها بِـ: (ض، ش (¬1)، ت).
فالمُحَقِّق فَاتَتْه النُّسَخ: (ص، ق، س، ن 1، ن 2، ن 3، ن 4، ن 5)، - فَلَمْ يَسْتَفِد منها فيما أرى.
ولمعرفة أهمية النسختين (ص، ق) انظر ما يتعلق بهما في هذه المقدمة (ص 51 - 53).
الخلاصة:
قد ظهر بذلك أننا اعتمدنا على نُسَخ أكثر دقة وأكثر عددًا ولم تتوفر للمحَقِّقَيْن
¬__________
(¬1) وقد استفدتُ منه في الحصول على الصفحة الأخيرة من نُسخة (ش)؛ حيث إنَّ نُسْخَتي المُصَوَّرة تنقصها الصفحة الأخيرة، وقد أَلْحَقَ الباحث - بمقدمة رسالته - صورة هذه الصفحة؛ فاستفدتها منه، جزاه الله خيرًا.
قال مقالته. فكأنه ينازع في ثبوت ذلك عمن ذكر.
وفي رؤوس المسائل للقاضي عبد الوهاب منهم أنه قول علي - رضي الله عنه - وابن أبي ليلى، ولا مخالِف لهما. قال: وحكي أنه قول عمر.
فربما يكون ذلك علقة لابن الحاجب في دعواه إجماع المدينة، لكن قال القاضي عَقب ذلك: إن عدم قبولهم قال به ابن عباس وعطاء والحسن والزهري، فكيف يقول: ولا مخالف لهما؟ ! ثم على تقدير صحة إجماع المدينة فقد سبق أنه غير حُجة، خلافًا لمن زعمه منهم.
وحكى النووي في "شرح المهذب" (¬1) - في باب الأذان في مسألة أذان الصبي - عن الجمهور قبول إخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة، بخلاف ما طريقه النقل، كرواية الأخبار. وسبقه إلى ذلك المتولي، فيكون هذا أيضًا قولًا خامسًا في المسألة.
على أنه قد وقع في الفقه مسائل تعتبر من الصبي المميز إخبارًا وإنشاءً، إما قطعًا أو بخلاف، ولها مدارك غير ما نحن فيه من الوثوق بالصدق وإن كان العلائي جعل في "القواعد" أنَّ الخلاف فيها جارٍ من الخلاف في رواية الصبي.
ولا بأس بإيراد شيء منها - لتكميل الفائدة - على ترتيب الفقه، وبيان المرجَّح فيها:
منها: أن يخبر بتنجيس الماء أو الثوب أو الأرض. في كلٍّ وجهان، الأصح عدم القبول، وكذا إخباره بأن هذا المرض مخوف حتى يبيح التيمم، وسبق بيانها.
ومنها: أذانه صحيح، وسبق كلام النووي فيه وفيما أشبهه.
ومنها: إمامته جائزة عندنا، ولكن لا تكمل به الأربعون في الجمعة. قيل: وجعل هذا من قبول خبره؛ لأنها تتضمن إخباره بالطهارة وغيرها من الشروط وبالنية ونحو ذلك. ولا
¬__________
(¬1) المجموع شرح المهذب (3/ 100).
نصرنا إبطال حُكم الغاية، والأصح عندنا الآن القول به.
قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها "حروف الغاية"، وغاية الشيء: نهايته، فلو ثبت الحكم بعدها، لم يفد تسميتها "غاية".
واحتج القاضي أيضًا بالاتفاق على تقدير ضد الحكم بعدها، ففي: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} يُقَدر: "فاقربوهن"، وفي: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] يُقَدر: "فتحِل"، ونحو ذلك.
ولا شك أن المضمر كالملفوظ به؛ لأنه إنما أُضمِر لَسَبقه إلى فَهم العارف باللسان، فكأنه نَص أهل اللغة على أنه منطوق.
وهذا مِن القاضي يدل على أن انتفاء الحكم فيما بَعد الغاية مِن جهة المنطوق لا المفهوم، على خِلاف ما نقله ابن الحاجب عنه.
ولهذا قال العبدري في "المستوفى" وابنُ الحاج في "تعليقة المستصفى" وجَرَى عليه صاحب "البديع" من الحنفية: ذهب طائفة من الحنفية إلى انتفاء الحكم فيما بعدها مع ذهابهم إلى عدم اعتبار مفهوم الغاية، تصميمًا على إنكار المفاهيم. ووافقهم الآمدي، ونقله المازري عن [الأزدي] (¬1) تلميذ القاضي (¬2).
¬__________
(¬1) كذا في (ظ). لكن في (ز، ص، ق، ض): الأدري. وفي (ش): الأودي. وفي (ت): الأردي.
وهو الحسين بن حاتم الأزدي، صاحب القاضي أبي بكر الباقلاني.
(¬2) هذه الفقرة جاءت هكذا في جميع النُّسخ، لكن عبارة الزركشي في (البحر المحيط، 3/ 131) هكذا: (كَذَا قَالَ الْعَبْدَرِيُّ فِي "الْمُسْتَوْفَى" وَابْنُ الْحْاجِّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى "الْمُسْتَصْفَى": عَدُّ الْأُصُولِيِّينَ الْمُغَيَّا بِـ "إِلَى" وَ"حَتَّى" فِي الْمَفْهُومِ جَهْلٌ بِكَلَامِ الْعَرَبِ، فَإِنَّ الْمُخَالِفَ بِمَا يَقْتَضِيهِ "حَتَّى" وَ"إِلَى" لَا مِنْ جِهَةِ الْمَفْهُومِ. قُلْتُ: ويَلْزَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا بِذَلِكَ فِي الشَّرْطِ، فَإِنَّ الجْزَاءَ مُرْتَبِطٌ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ، هُوَ=
المعنى إلى سبعة.
وعلى هذا فليس الاستثناء مُبيِّنًا للمراد بالأول، بل به يحصل الإخراج، وليس هناك إلا الإثبات، ولا نفي أصلًا، فلا تناقض.
ثم ذكر استدلاله على ذلك وإبطال غيره، وأطال، ثم قال:
- (فتبيَّن أن الاستثناء - على قول القاضي- ليس بتخصيص) (¬1).
أي: لأن "التخصيص" قَصْرُ العام على بعض أفراده، وهنا لم يُرد بالعام بعض أفراده، بل بالمجموع المركب.
- (وأنه على قول الأكثر تخصيص) (¬2).
أي: لِمَا فيه من قَصْر اللفظ على بعض مسمياته.
- (وأنه على الثالث المختار - عنده- محتمل) (¬3).
أي: لِأَنْ يكون تخصيصًا؛ نظرًا إلى كون الحكم في الظاهر للعام والمراد الخصوص، وأنْ لا يكون مخصصًا؛ نظرًا إلى أنه أُريدَ بالمستثنى منه تمام مسماه.
وذكر القاضي عضد الدين في تحقيق هذه المذاهب كلامًا أطال فيه، وتعقب عليه في بعضه السبكي في "شرح المختصر"، فليراجَع منه. والله أعلم.
¬__________
(¬1) مختصر المنتهى (2/ 799).
(¬2) مختصر المنتهى (2/ 799).
(¬3) مختصر المنتهى (2/ 799).
اجتهاد الحاكم" ما نَصه: والقياس قياسان، أحدهما: أن يكون في معنى الأصل، فذلك الذي لا يحل لأحد خِلافُه. ثم قياس الشبه أنْ يشبه الشيء بالشيء مِن الأصل، والشيء مِن الأصل غيره، فيشبه هذا بهذا الأصل، ويشبه غيره بالأصل غيره.
قال الشافعي: (وموضع الصواب فيه عندنا - والله أعلم - أنْ ينظر، فأيهما كان أَوْلى بشبهِه صَيَّره إليه، إنْ أَشْبَه أحدهما في خصلتين والآخَر في خصلة، ألحَقَه بالذي هو أَشْبَه في خصلتين) (¬1). انتهى
فلذلك أوجب الشافعي القيمة في قتل العبد بالغة ما بلغت؛ لأنه يشبه الأموال في أكثر الأحكام ويشبه الأحرار في قليلٍ منها؛ فوجب اعتبار الكثرة.
وحينئذٍ فإذا رتبت أنواع الشَّبه عند القائل باعتباره مطلقًا، فأعلاها قياس غلبة الأشباه إذا كان في الحكم، ثم إذا كان في الصفة، ثم إذا كان في الصورة.
وإلى ذلك أشرتُ بقولي في النَّظم بعد قِيَاس "غَلْتةِ الْأَشْبَاهِ": (حُكْمًا)، أي: فهو المقدَّم.
وقولي: (وَوَصْفًا، بَعْدَهُ) أي: بعد الحكمي.
وقولي: (يُبَاهِي) - جملة حالية، أي: حال كون هذا الذي يشابه في الوصف يباهي ما كان صوريًّا.
نعم، الشافعي - كما سبق - لا يقول بالشَّبَه الصوري كما بيَّنه ابن برهان وغيره، وكذا نقله ابن السمعاني عن أصحابنا.
¬__________
(¬1) الأم (7/ 94).