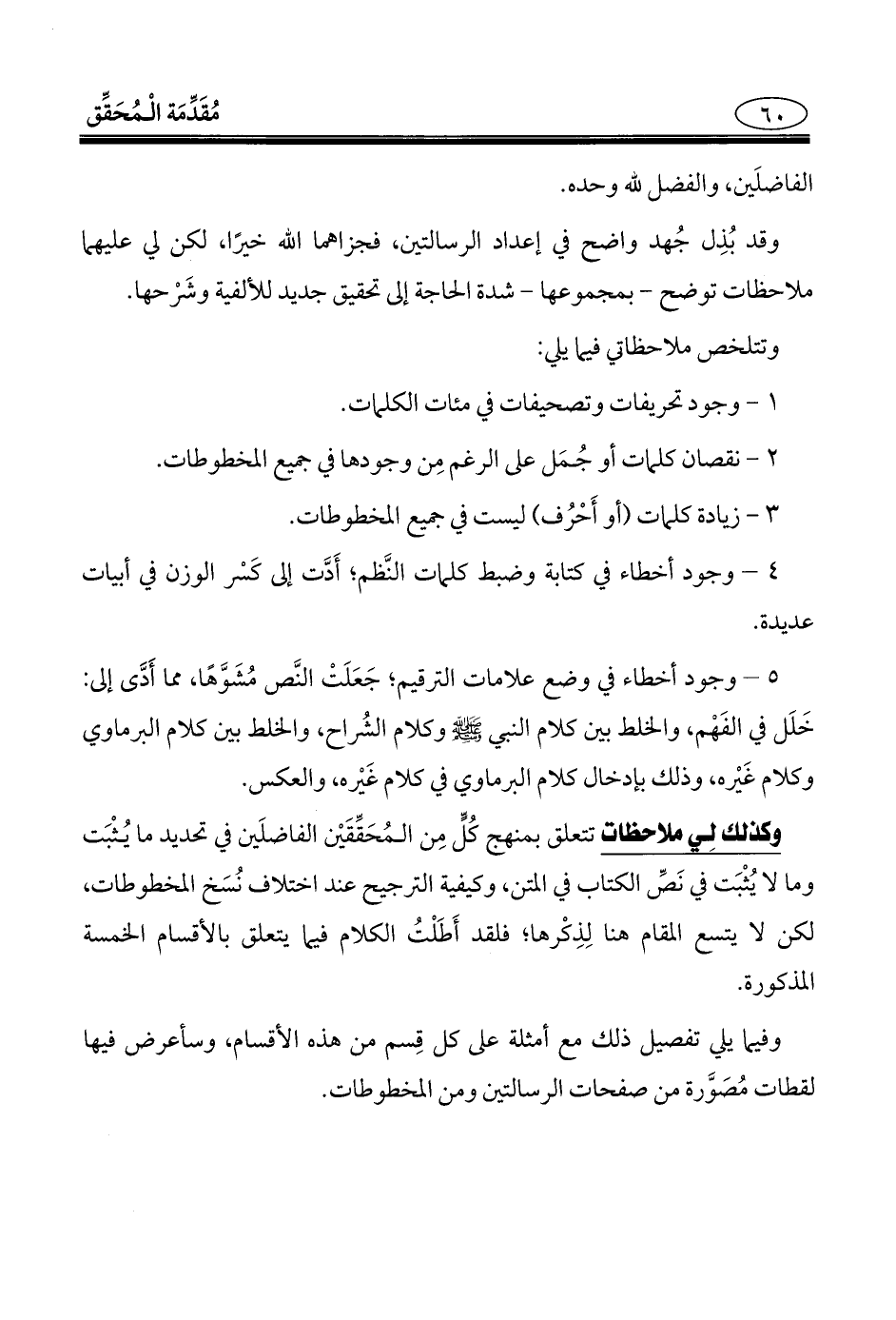
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
الفاضلَين، والفضل لله وحده.وقد بُذِل جُهد واضح في إعداد الرسالتين، فجزاهما الله خيرًا، لكن لي عليهما ملاحظات توضح - بمجموعها - شدة الحاجة إلى تحقيق جديد للألفية وشَرْحها.
وتتلخص ملاحظاتي فيما يلي:
1 - وجود تحريفات وتصحيفات في مئات الكلمات.
2 - نقصان كلمات أو جُمَل على الرغم مِن وجودها في جميع المخطوطات.
3 - زيادة كلمات (أو أَحْرُف) ليست في جميع المخطوطات.
4 - وجود أخطاء في كتابة وضبط كلمات النَّظم؛ أَدَّت إلى كَسْر الوزن في أبيات عديدة.
5 - وجود أخطاء في وضع علامات الترقيم؛ جَعَلَتْ النَّص مُشَوَّهًا، مما أَدَّى إلى: خَلَل في الفَهْم، والخلط بين كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وكلام الشُراح، والخلط بين كلام البرماوي وكلام غَيْره، وذلك بإدخال كلام البرماوي في كلام غَيْره، والعكس.
وكذلك لِي ملاحظات تتعلق بمنهج كُلٍّ مِن المُحَقِّقَيْن الفاضلَين في تحديد ما يُثْبَت وما لا يُثْبَت في نَصِّ الكتاب في المتن، وكيفية الترجيح عند اختلاف نُسَخ المخطوطات، لكن لا يتسع المقام هنا لِذِكْرها؛ فلقد أَطَلْتُ الكلام فيما يتعلق بالأقسام الخمسة المذكورة.
وفيما يلي تفصيل ذلك مع أمثلة على كل قِسم من هذه الأقسام، وسأعرض فيها لقطات مُصَوَّرة من صفحات الرسالتين ومن المخطوطات.
يخفى ما فيه من النظر.
ومنها: إذا أخبر برؤية الهلال وجعلناه رواية لا شهادة، فالقياس جريان الخلاف فيه، لكن المشهور الرد جزمًا. قاله الرافعي.
ومنها: إذا جامع في نهار رمضان عمدًا وهو صائم، لا كفارة على أصح الوجهين ولو قلنا [بأن] (¬1) عَمْدَه عمدٌ؛ لِعَدَم التزام العبادات.
ومنها: إذا حج وباشر محظورات الإحرام عمدًا، كلبس ونحوه، وجبت الفدية في الأصح؛ لأن عَمْدَه في العبادات كالبالغ، كتعمد كلامه في الصلاة أو أكله في الصوم، وفيه قول غريب حكاه الداركي: إنه إن [كان] (¬2) يلتذ باللباس والطيب، وجبت، وإلا فلا.
نَعَم، الفرْق بين هذه المسألة ومسألة الجماع في الصوم أن الفدية هنا إنْ وجبت في مال الولي وهو الأرجح إن كان قد أحرم بإذنه، فهو من خطاب الوضع، أو في مال الصبي وهو إذا أحرم بغير إذنه، فهو من قبيل [الإتلاف] (¬3)، بخلاف الجماع في الصوم؛ [بدليل أن الفدية تجب في الحلق والتقليم ونحوهما ولو نسيانًا، بخلاف الطيب ولبس المخيط. وأما الصوم فإنما تجب الكفارة فيه حيث كان عمدًا يأثم به، والصبي لا إثم عليه] (¬4).
ولا يخفَى ما فيه من نظر.
ومنها: بيعه وشراؤه - لاختبار الرشد - يصح قبل البلوغ (على وَجْهٍ).
ومنها: اعتماده في الإذن في دخول الدار، وحمل الهدية على الأصح، لكن للقرينة، لا
¬__________
(¬1) في (ز، ص): ان.
(¬2) في (ز): كان ممن.
(¬3) في (ز): الاتلافات.
(¬4) ليس في (ز).
تنبيه:
إذا تُصُوِّر في الغاية تطاول، هل يتعلق الحكم بأولها؟ أو يتوقف الحكم على تمامها؟ الأكثر على الأول.
تظهر فائدته في قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، فيجب دم التمتع عندنا إذا فرغ مِن العمرة وأحرم بالحج؛ لأنه يسمى حينئذٍ "متمتعًا"، [فيكتفَى] (¬1) بأولها.
وقال مالك ما لم يقف بعرفة لا يجب دم التمتع. وقال عطاء: ما لم يَرْمِ جمرة العقبة.
منشأ ذلك أنه لا يكتفَى بأول الغاية.
ولنا قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، والاتفاق على التعلق بأوله، وليس استيعاب الليل ولا مُضِي شيء منه شرطًا.
الثالث: "مفهوم الحصر":
وذكرت منه أربعة أمور:
أولها: الحصر بالنفي والاستثناء، سواء فيه الاستثناء من التام والاستثناء المفرغ، وسواء أكان النفي فيه بـ "ما" أو "لا" أو "ليس" أو "لم" أو "إن"، أو ما هو في معنى النفي، نحو: {فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ} [الأحقاف: 35]، {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ} [التوبة: 32]، وسواء أكانت أداة الاستثناء "إلا" أو غيرها، نحو: لا إله إلا الله، وما لي سِوَى
¬__________
= غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ كَالْغَايَةِ. وَذَهَبَ الْآمِدِيُّ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْحْنَفِيَّةِ إلَى الْمَنْعِ، تَصْمِيمًا عَلَى إنْكَارِ الْمَفْهُومِ، وَنَقَلَهُ الْمَازِرِيُّ عَن الْأَزْدِيِّ تِلْمِيذِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ).
(¬1) في (ز): فينتفي.
ص:
628 - وَشَرْطُهُ اتِّصَالُهُ بِالْعَادَةِ ... وَعَدَمُ اسْتِغْرَاقِهِ لِلْجُمْلَةِ
629 - وَلَوْ يَكُونُ مُخْرَجٌ أَكْثَرَ مِنْ ... بَاقٍ أَوِ اسْتِوَاهُمَا [مِمَّا] (¬1) زُكِنْ
الشرح:
ذكرتُ لصحة الاستثناء شرطين، وذكرتُ في أمر ثالث أنه لا يُشترط وإنْ شَرَطه بعضهم.
فأما الشرط الأول:
فأنْ يتصل الاستثناء بالمستثنى منه اتصالًا عاديًّا حتى يُغتفر الفصل بالتنفس أو السعال أو نحو ذلك، وكذا إذا طال الكلام متعلقًا بالمستثنى منه، فإنه لا يضر كما قاله الإمام.
والخلاف في اشتراط ذلك نُقِل عن ابن عباس وغيره.
فَعَنِ ابن عباس: جواز تأخيره إلى شهر.
وقيل: إلى سنة.
وقيل: أبدًا، كما يجوز التأخير في تخصيص العام وبيان المجمل.
وعن سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر.
وعن عطاء والحسن: ما لم يَقُم من المجلس. حكاه عنهما الشيخ أبو إسحاق.
وعن مجاهد: إلى سنتين.
¬__________
(¬1) في (ق، ن 2، ن 5): فيما.
تنبيهات
أحدها:
مما يدور بين أصلين فيكون من قياس غلبة الأشباه: الظهار، فإنه لفظ محرم معدود من الكبائر، لكنه دائر بين القذف والطلاق، فيتفرع من ذلك ما لو قال: (أنتِ علَيَّ كعين أمي). فإنْ أراد الكرامة فليس بظهار، أو الظهار فظهار على المذهب. أو أطلق فَعَلَى أيهما يُحْمَل؟ وجهان، أرجحهما: يُحمل على الكرامة. ويتجه أن حالة الإطلاق مترددة بين مشابهة الطلاق والقذف، فقضية مشابهته للطلاق أنْ يُحمل على الظهار؛ لأنه كان طلاقًا في الجاهلية. وقضية مشابهته للقذف أنْ يُحمل على الإكرام؛ وذلك لأنه لو قال: (عينك طالق)، طلقت. ولو قال: (زَنَتْ عَيْنك)، لم يكن قذفًا.
ومنه: زكاة الفطر مترددة بين المؤنة والقُرْبة، ويبنى عليه فروع في بابها.
ومنه: الكفارة مترددة بين العبادة والعقوبة.
ومنه: الحوالة مترددة بين الاستيفاء والاعتياض.
ومنه: المسابقة مترددة بين الإجارة والعارَّية.
ومنه: اللعان متردد بين اليمين والشهادة، وينبني عليه لعان الذمي والرقيق. والصحيح الصحة فيهما.
ومنه: الجنين يُشبه الجزء والمنفرد. فإذا قال: (بِعْتكها إلا حملها)، فعَلَى الأول باطل كما لو استثنى جزءًا، وعلى الثاني صحيح كما لو قال: (بِعْتُك الاثنين إلا هذا).
الثاني:
بَنَى القاضي قياس الشَّبه على أنَّ المصيب مِن المجتهدين واحد؟ أو الكل؟ فعَلَى الأول