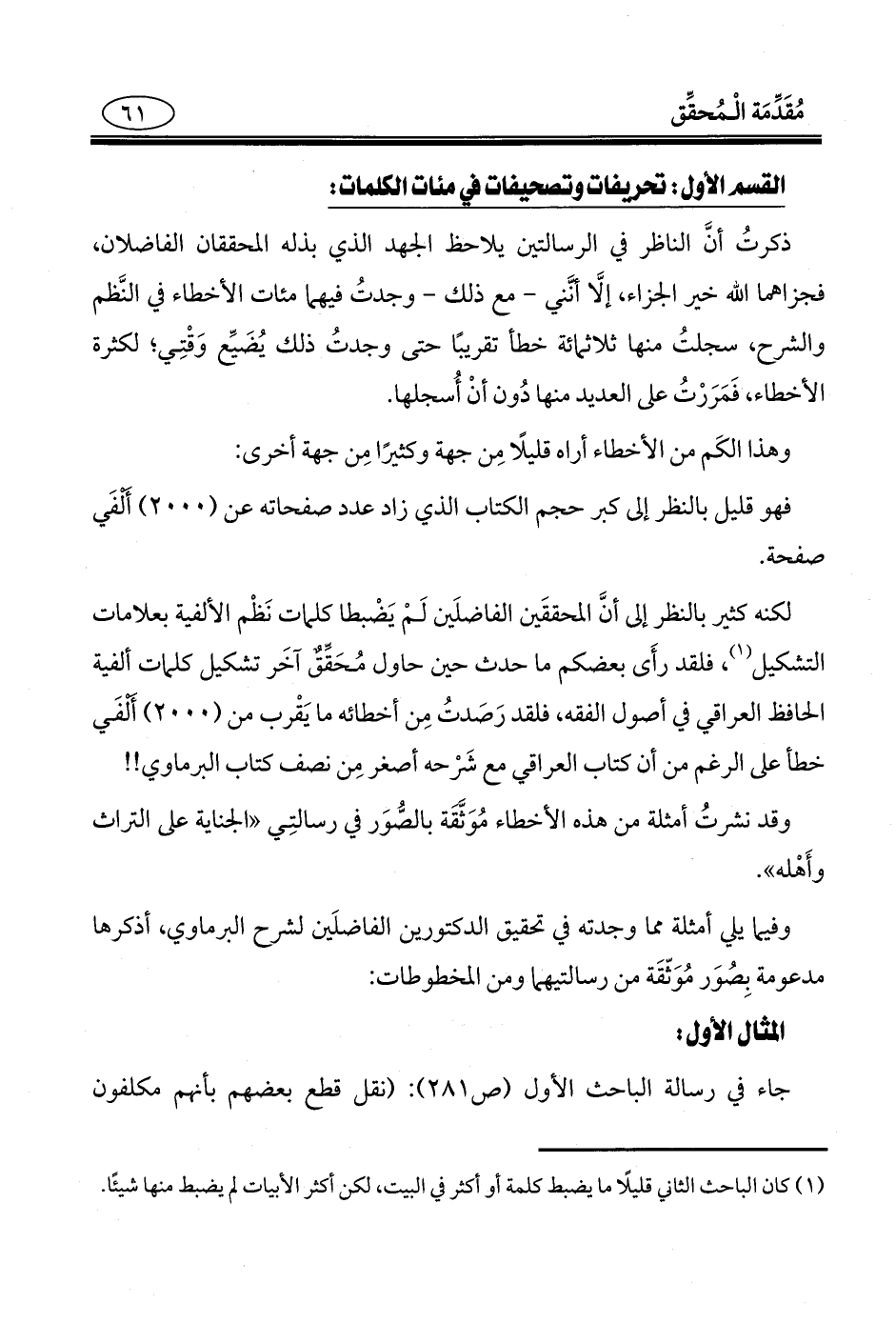
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
القسم الأول: تحريفات وتصحيفات في مئات الكلمات:ذكرتُ أنَّ الناظر في الرسالتين يلاحظ الجهد الذي بذله المحققان الفاضلان، فجزاهما الله خير الجزاء، إلَّا أنَّني - مع ذلك - وجدتُ فيهما مئات الأخطاء في النَّظم والشرح، سجلتُ منها ثلاثمائة خطأ تقريبًا حتى وجدتُ ذلك يُضَيِّع وَقْتِي؛ لكثرة الأخطاء، فَمَرَرْتُ على العديد منها دُون أنْ أُسجلها.
وهذا الكَم من الأخطاء أراه قليلًا مِن جهة وكثيرًا مِن جهة أخرى:
فهو قليل بالنظر إلى كبر حجم الكتاب الذي زاد عدد صفحاته عن (2000) أَلْفَي صفحة.
لكنه كثير بالنظر إلى أنَّ المحققَين الفاضلَين لَمْ يَضْبطا كلمات نَظْم الألفية بعلامات التشكيل (¬1)، فلقد رأَى بعضكم ما حدث حين حاول مُحَقِّقٌ آخَرَ تشكيل كلمات ألفية الحافظ العراقي في أصول الفقه، فلقد رَصَدتُ مِن أخطائه ما يَقْرب من (2000) أَلْفَي خطأ على الرغم من أن كتاب العراقي مع شَرْحه أصغر مِن نصف كتاب البرماوي! !
وقد نشرتُ أمثلة من هذه الأخطاء مُوَثَّقَة بالصُّوَر في رسالتِي "الجناية على التراث وأَهْله".
وفيما يلي أمثلة مما وجدته في تحقيق الدكتورين الفاضلَين لشرح البرماوي، أذكرها مدعومة بِصُوَر مُوَثّقَة من رسالتيهما ومن المخطوطات:
المثال الأول:
جاء في رسالة الباحث الأول (ص 281): (نقل قطع بعضهم بأنهم مكلفون
¬__________
(¬1) كان الباحث الثاني قليلًا ما يضبط كلمة أو أكثر في البيت، لكن أكثر الأبيات لم يضبط منها شيئًا.
لمجرد إخباره. وفي "البحر" للروياني: قال الزُّبَيري: يجوز توكيل الصبي في طلاق زوجته. وغلطه فيه.
ومنها: إخباره بأن الشريك قد باع حتى تسقط الشفعة بالتأخير، وفيها وجهان، الأصح: لا يقبل، فالشفعة باقية. وكذا إخباره بأن المرض مخوف حتى يُحسب تصرف المريض من الثلث، الأصح: لا يقبل.
ومنها: تصح وصيته على قولٍ، والأصح المنع.
ومنها: لو قتل مورثه عمدًا وقُلنا: إنَّ عمْده خطأ، وإنَّ الخطأ لا يمنع الإرث، هل يرث؟ أو لا؟
ومنها: وطء الصبي هل يثبت المصاهرة؟ إن قلنا: إن عمْده عمدٌ، كان كوطء الزاني، وإلا فكالشبهة، وأجروا مثله في وطء المجنون.
ومنها: أخبر بطلب صاحب الدعوة له، قال الماوردي والروياني: يَلْزَمه الإجابة. إلا أن الروياني اشترط أن يقع في قلبه صِدْقه. ويشبه أن ذلك للقرينة في مثل الدعوات.
ومنها: خلع الصغيرة المميزة يقع رجعيًّا على الأصح عند البغوي والمتولي، ورجح الإمام والغزالي أنه لا يقع شيء؛ بناءً على أن عَمْدَه ليس عمدًا.
ومنها: قال للصَّبية: (أنت طالق إن شئتِ)، فقالت: (شئتُ). فيه وجهان.
ومنها: إذا شارك في الجناية بالغًا، فإنْ قُلنا: عمده عمدٌ، اقتص مِن البالغ، وإلا فلا.
ومنها: تغليظ الدية عليه إن قُلنا: عمده عمدٌ.
ومنها: تحمُّل العاقلة عنه وغير ذلك من الأحكام المتعلقة [بالعمد] (¬1).
¬__________
(¬1) في (ز): بالعقد.
الله.
رضيتُ بك اللهم ربًّا فلن أرى ... أدين إلها غيرك الله واحدا
ونحو: ما قام القوم إلا زيد، و: ما رأيت إلا زيدًا، ونحو ذلك من الأمثلة، وهي واضحة.
وقد اعترف أكثر منكري المفهوم -كالقاضي والغزالي- باعتبار الفهوم هنا، وأصرَّ الحنفية على نفيهم.
نعم، الصحيح أن الدلالة هنا بالمنطوق؛ بدليل أنه لو قال: (ما له عَلَيَّ إلا دينار)، كان ذلك إقرارًا بالدينار. ولو كان بالمفهوم، لم يؤاخَذ به؛ لعدم اعتبار المفهوم في الأقارير.
وبذلك صرح أبو الحسين بن القطان في نحو: "لا نكاح إلا بولي" (¬1)، و"لا صيام لمن يبيت الصيام من الليل" (¬2)، فقال: إن النفي والإثبات كلاهما بالمنطوق، وليس أحدهما بالمفهوم؛ لأنك لو قلتَ: "لا تُعطِ زيدًا شيئًا إلا إنْ دخل الدار"، كان العطاء والمنع منصوصًا عليهما.
وممن جزم بأنه منطوق أيضًا الشيخ أبو إسحاق في "الملخص"، ورجحه القرافي في "القواعد"، وإنما أدخلتُه في [المفاهيم] (¬3) تبعًا للمشهور في الأصول.
قال الماوردي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (¬4): إنه يدل على قبولها بالطهور، ونَفْي الحكم عن تلك الصفة موجِب لإثباته عند عدمها، وهو الظاهر من مذهب
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) في (ز): المفهوم.
(¬4) سبق تخريجه.
وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخَر.
وقيل: يشترط أن ينوي في الكلام أنه سيستثنى.
قال القاضي: إن صح النقل عن ابن عباس في جواز تأخيره فلعَل مراده أن يستثنى متصلًا بالكلام ثم يظهر ما نواه بعد ذلك، فإنه يُدين.
وقال بعضهم: يجوز في كلام الله تعالى. وحمل بعضهم خلاف ابن عباس على ذلك، أي: يجوز تراخيه في القرآن دُون غيره.
وضُعِّف هذا القول بأن كلام الله إنْ أُريد به القديم فلا يوصف لا بإخراج ولا بإدخال، وإنْ أُريدَ اللفظ المنزل ولو إلى اللوح المحفوظ كما قال المقْترح، فذلك إنما هو على أساليب كلام العرب، ما امتنع فيه يمتنع فيه، وما جاز فيه جاز فيه؛ لأن القرآن إنما نزل بلُغة العرب، فلا يكون مخالفًا لِلُغتهم.
وبالجملة فهذه الأقوال كلها ضعيفة، وما نُقل منها عن هذه الأئمة فيجب تأويله.
أما ضعفها فلأن أهل الأدب (أيْ: أهل العربية) متفقون على اشتراط الاتصال؛ ولهذا أَوَّلوا ما يُنقل عن ابن عباس وغيره من أهل الحجة في لسان العرب وبأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" (¬1). ولم يقُل: (أو ليستثنِ).
وكذلك لَمَّا أرشد الله تعالى أيوب عليه السلام بقوله: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ
¬__________
(¬1) سنن النسائي (3781)، سنن ابن ماجه (2108)، وغيرهما. قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح النسائي 3790).
وفي صحيح مسلم (رقم: 1650) بلفظ: (من حَلَفَ على يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا منها، فَلْيُكَفِّرْ عن يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلْ).
يبطل قياس الشبه، وعلى الثاني صحيح؛ لأنَّ كل مجتهد مأمور باتِّباع ما غلب على ظنه.
[فكان] (¬1) القاضي يقول: إنَّ رَدَّ قياس الشَّبه ليس قطعيًّا، بل بالظن.
ولكن مقتضَى كلام إمام الحرمين أنه لا يوافقه على ذلك.
نعم، في البناء على ذلك نَظَر ظاهر.
الثالث:
قال القاضي أبو حامد المروروذي في أصوله: إنَّا لا نعني بقياس الشبه أن يشبه الشيء بالشيء مِن وَجْه أو أكثر؛ لأنه ليس في العالم شيء إلا وهو يُشْبه شيئًا آخَر مِن وَجْه أو أكثر، لكن نعني أنه لا يوجد شيء أَشْبَهَ به منه. فلا يوجد شيء أَشْبَه مِن الوضوء بالتيمم؛ فَيُلْحَق به، وأكثرَ أصحابنا من الاحتجاج به.
قال: لإفادته الظن كما في أصل قياس العِلة، فإنه إنما احْتُجَّ به لإفادته الظن.
واعترض ذلك الأبياري بأنه قياس في الأصول؛ فلا يُسْمَع.
وجوابه: أنه لم يحتج بنفس القياس، بل استند به إلى تكليف الشارع بما غلب على الظن كما في القياس ونحوه، فالمدار على الضرورة؛ لأنَّ النصوص لا تَفِي بالحادثات، وقياس العِلة قد لا لفي بغير المنصوص.
الرابع:
قال ابن الحاجب: (إنَّ عِليَّة الشَّبَه تثبت بجميع مسالك العِلة) (¬2).
أي: مِن نَص أو إجماع أو غيرهما. أي: بأنْ يدل على اعتبار هذا الوصف في بعض
¬__________
(¬1) كذا في جميع النّسخ، ويحتمل: فكَأنَّ.
(¬2) مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (2/ 1102).