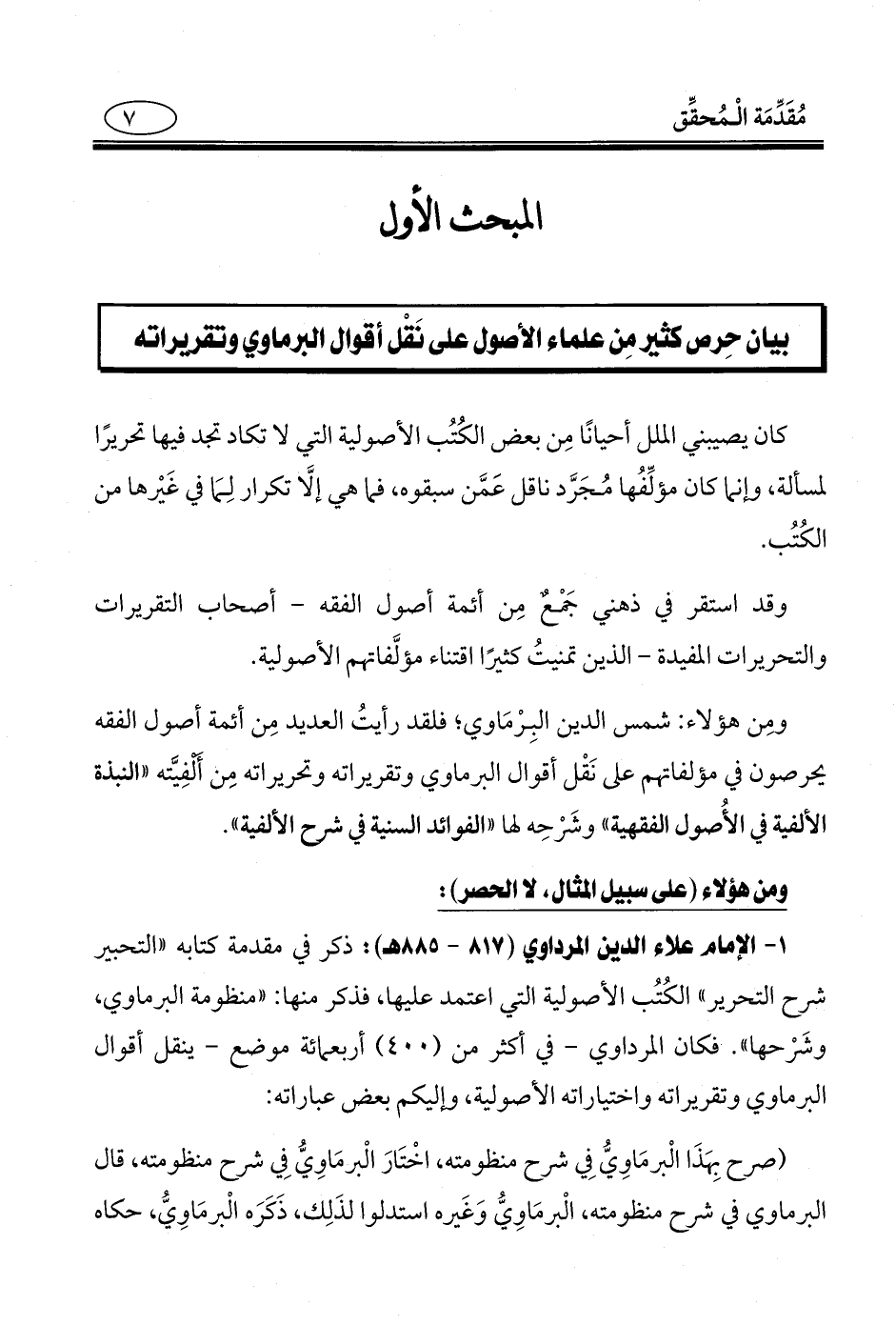
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
المبحث الأول: بيان حِرص كثير مِن علماء الأصول على نَقْل أقوال البرماوي وتقريراتهكان يصيبني الملل أحيانًا مِن بعض الكُتُب الأصولية التي لا تكاد تجد فيها تحريرًا لمسألة، وإنما كان مؤلِّفُها مُجَرَّد ناقل عَمَّن سبقوه، فما هي إلَّا تكرار لِمَا في غَيْرها من الكُتُب.
وقد استقر في ذهني جَمْعٌ مِن أئمة أصول الفقه - أصحاب التقريرات والتحريرات المفيدة - الذين تمنيتُ كثيرًا اقتناء مؤلَّفاتهم الأصولية.
ومِن هؤلاء: شمس الدين البِرْمَاوي؛ فلقد رأيتُ العديد مِن أئمة أصول الفقه يحرصون في مؤلفاتهم على نَقْل أقوال البرماوي وتقريراته وتحريراته مِن أَلْفِيَّته "النبذة الألفية في الأُصول الفقهية" وشَرْحِه لها "الفوائد السنية في شرح الألفية".
ومن هؤلاء (على سبيل المثال، لا الحصر):
1 - الإمام علاء الدين المرداوي (817 - 885 هـ): ذكر في مقدمة كتابه "التحبير شرح التحرير" الكُتُب الأصولية التي اعتمد عليها، فذكر منها: "منظومة البرماوي، وشَرْحها". فكان المرداوي - في أكثر من (400) أربعمائة موضع - ينقل أقوال البرماوي وتقريراته واختياراته الأصولية، وإليكم بعض عباراته:
(صرح بِهَذَا الْبرمَاوِيُّ فِي شرح منظومته، اخْتَارَ الْبرمَاوِيُّ فِي شرح منظومته، قال البرماوي في شرح منظومته، الْبرمَاوِيُّ وَغَيره استدلوا لذَلِك، ذَكَرَه الْبرمَاوِيُّ، حكاه
متواتر" و"آحاد"، على معنى: متواتر أو آحاد سنده.
و"الآحاد": جمع أحد، كَـ: بطل وأبطال. وهمزة "أحد" مبدلة من واو الواحد. وأصل "آحاد" أأحاد بهمزتين، أبدلت الثانية ألفًا كـ "آدم ".
و"المتواتر": المتتابع، تقول: تواتر القومُ، أي: جاءوا متتابعين بِمُهلة.
وقولي: (فَالثَّانِ) شروع في شرح كل من القسمين، وقدمتُ الثاني؛ لقوته، ولأن القرآن متواتر وهو أول الأدلة وأصلها، وأيضًا فلِيعلم أن ما خرج من تعريفه هو "الآحاد"؛ لأن ذلك كالملكة والعدم.
فَ " المتواتر": خبر جَمعْ يمتنع تواطؤُهم على الكذب عن محسوس أو عن خبر جَمْع مِثْلهم إلى أنْ ينتهي إلى محسوس، أيْ: معلوم بإحدى الحواس الخمس، كمشاهدة أو سماع.
فخرج بالقيد الأول: أخبارُ الآحاد ولو كان مستفيضًا، وسيأتي بيانه، خلافًا لدعوى الماوردي في "الحاوي" والأستاذ أبي إسحاق وجَمع أنه قِسم آخَر ثالث.
وخرج بالانتهاء إلى محسوس: ما كان عن معقول، أيْ: معلوم بدليل عقلي، كإخبار أهل السُّنة دهريًّا بحدوث العالم، فإنه لا يوجب له عِلمًا؛ لتجويزه غلَطهم في الاعتقاد، بل هو معتقد ذلك، وأيضًا فَعِلم المخبرين به نظري، و"التواتر" يفيد العلم الضروري، فيصير الفرع أقوى من أصله.
قلتُ: مثل ذلك [إذا] (¬1) لم يتفق المخبرون على واحد بالشخص الذي هو شرط في المتواتر، بل كل أحدٍ إنما يخبر عن اعتقاد نفسه وإنْ توافقوا نوعًا، ولأجل ذلك لم يكن الإجماع من قبيل الخبر المتواتر، والحجية فيه إنما هي من حيث [ثناء] (¬2) الشرع على تَوافُق
¬__________
(¬1) ليست في جميع النُّسخ، وقد وضع ناسخُ (ت) علامة في هذا الموضع، وكتب في الهامش: لعله "إذا".
(¬2) في (ز): بناء.
يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد مِن الخلْق إلى معرفته) (¬1).
قال: (وقد اتفق أصحابنا وغيرهم مِن المحققين على أنَّه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد) (¬2).
ورجح هذا الشيخ أَبو إسحاق؛ لأن الله تعالى أَوْرَدَ هذا مدحًا للعلماء، فلو كانوا لا يعرفون معناه لَشاركوا العامة وبَطل مدحهم. وصححه أيضًا سليم في "التقريب"، وحكاه القاضي أَبو بكر وإمام الحرمين في "البرهان" عن أكثر القراء والنحاة، قال: وهو مذهب ابن مسعود وأُبي بن كعب، أي: عكس حكاية الأستاذ والبغوي عنه.
وإلى هذا أشرتُ بقولي: (وَقَدْ يُطْلِعُ بَعْضَ أَصْفِيَاهُ). والأصل: أصفيائه، ولكن قصرتُه؛ للضرورة.
واعلم أنَّه قد سبق في باب الأدلة - عقب ذِكر الكتاب والسُّنة - الخلافُ في أنَّه هل يجوز أن يكون فيهما لفظ له معنى لكن لا نفهمه؛ وبيان أن خلاف الحشوية ليس في هذا القِسم كما زعم بعضهم، ولا في ورود لفظ بلا معنى أصلًا؛ فإنه لا يُظن بعاقل أن يقوله، وأن الإمام في "المحصول" إنما حكى خلاف الحشوية في كون اللفظ له معنى ولكن أُريدَ غيره، وإنْ كان قد أقام دليلا يقتضي أن خلاف الحشوية في التكلم بما لا يفيد، فراجعه؛ فإنه مهم.
¬__________
(¬1) شرح صحيح مسلم للنووي (16/ 218).
(¬2) شرح صحيح مسلم للنووي (16/ 218).
فيتوجه الكلام إلى أمرين:
ما ينتهي إليه التخصيص، [و] (¬1) بيان أقَل الجمع.
فالأول: فيه مذاهب:
أحدها: المختار -وهو رأي القفال الشاشي- أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقَل المراتب التي ينتهي إليها ذلك العام الذي قد خُصَّ.
فإن لم يكن جمعًا ولا في معنى الجمع كَـ "مَن" و"ما" و"أين" ونحو ذلك، فإلى أن يبقى واحد.
وإنْ كان جمعًا كَـ "الرجال" أو ما في معناه كَـ "النساء" و"القوم" و"الرهط" ونحو ذلك، فإلى أن يبقى أقَل ما ينطلق عليه الجمع أو ما في معناه.
وعلى هذا فيُفَصَّل في الجمع:
فإنْ كان جمع قِلة فإلى ثلاثة أو اثنتين على الخلاف الآتي في أقَل الجمع.
وإنْ كان جمع كثرة أو ما في معنى الجمع إذا لم يُقيِّد أهل العلم أقَله بشيء فإلى أحد عشر.
بل حكى قوم الاتفاق في إبقاء واحد إذا لم تكن الصيغة جمعًا أو معناه. فقال الأستاذ أبو إسحاق: (إنه لا خلاف في ذلك). وحكى القاضي عبد الوهاب عنه أنه ألحق أسماء الأجناس -كَـ "السارق" و "السارقة"- بالجمع المعرَّف في امتناع ردِّه إلى الواحد.
وقال الأصفهاني: (ينبغي أن يلحق بذلك أيضًا "أيّ" و"مَن" و"ما"؛ لتناوله الواحد والاثنين) (¬2).
¬__________
(¬1) كذا في (ص)، لكن في (س): وفي.
(¬2) الكاشف عن المحصول (4/ 401 - 402).
الذي وقصته ناقته: "لا تمسوه طِيبًا ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا" (¬1). أخرجاه.
الثانية: أن تدخل في كلام الشارع على الحكم، نحو: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} [المائدة: 38]، و {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} [النور: 2].
وإلى هاتين الحالتين أشرتُ بقولي: (فَالْفَاءِ ثَبَتْ في كَلِمِ الشَّارعِ) أي: سواء دخلت على العلة أو الحكم. وما ذكرتُه مِن أنَّ تَقدُّم العلة ثم مجيء الحكم بـ "الفاء" أقوى مِن عكسه -هو ما قاله الإمام الرازي؛ لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة؛ لأنَّ الطرد واجب في العِلل، دُون العكس.
ونازعه النقشواني، وقال: بل تقديم المعلول على العلة أقوى؛ لأن الحكم إذا تَقدَّم، طلبت النفسُ عِلته. فإذا ذُكِر وصفٌ، ركنَتْ إلى أنه هو العلة، بخلاف ما لو تقدمت العلة ثم جاء الحكم، فقد تكتفي النفسُ بأنَّ ما سبق عِلته، وقد تطلب له علة بطريق أخرى.
وأطال في ذلك، ولا يخفَى ضَعفُه وقوة ما قاله الإمام.
وهل ما دخلت عليه "الفاء" في نَص الكتاب أقوى مما في نَص السُّنَّة؟ أو متساويان؟
فبالأول قال الآمدي، وبالثاني قال الهندي وهو الحق؛ لاستوائهما في عدم تَطرُّق الخطأ إليهما.
الثالثة: أن تكون "الفاء" في كلام الراوي ولا تكون إلا داخلة على الحكم، والعلة ما قبلها، نحو: "سها - صلى الله عليه وسلم -، فسجد" (¬2). وسواء كان الراوي فقيهًا أو لا. لكنه إذا كان فقيهًا، كان
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) سنن أبي داود (رقم: 1039)، سنن الترمذي (رقم: 395)، سنن النسائي (1236) وغيرها. قال الألباني في (إرواء الغليل: 403): (فالإسناد صحيح، لولا أن لفظه "ثم تشهد" شاذة فيما يبدو).