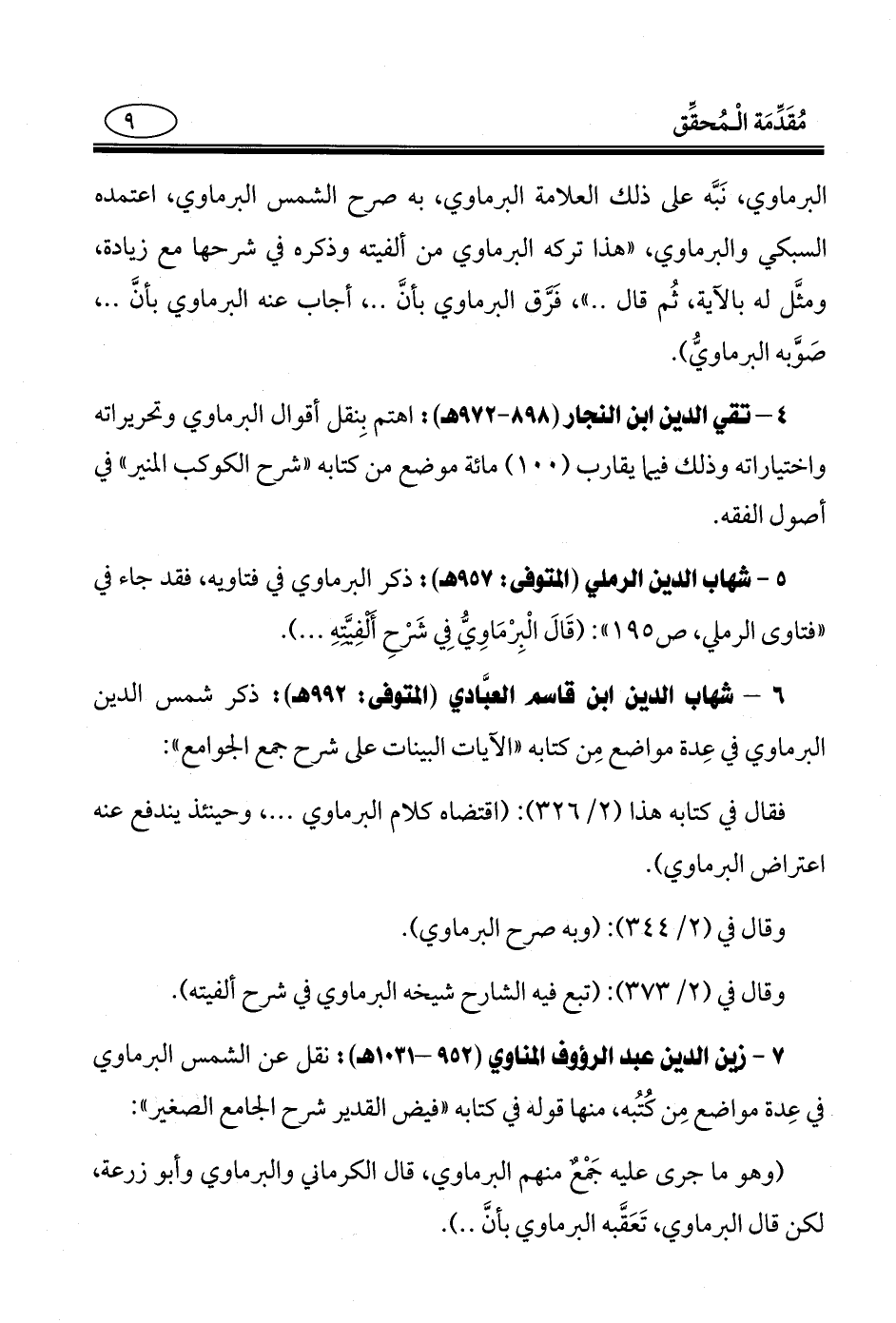
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
البرماوي، نَبَّه على ذلك العلامة البرماوي، به صرح الشمس البرماوي، اعتمده السبكي والبرماوي، "هذا تركه البرماوي من ألفيته وذكره في شرحها مع زيادة، ومثَّل له بالآية، ثُم قال .. "، فَرَّق البرماوي بأنَّ .. ، أجاب عنه البرماوي بأنَّ .. ، صَوَّبه البرماويُّ).4 - تقي الدين ابن النجار (898 - 972 هـ): اهتم بِنقل أقوال البرماوي وتحريراته واختياراته وذلك فيما يقارب (100) مائة موضع من كتابه "شرح الكوكب المنير" في أصول الفقه.
5 - شهاب الدين الرملي (المتوفى: 957 هـ): ذكر البرماوي في فتاويه، فقد جاء في "فتاوى الرملي، ص 195": (قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ ... ).
6 - شهاب الدين ابن قاسم العبَّادي (المتوفى: 992 هـ): ذكر شمس الدين البرماوي في عِدة مواضع مِن كتابه "الآيات البينات على شرح جمع الجوامع":
فقال في كتابه هذا (2/ 326): (اقتضاه كلام البرماوي ... ، وحينئذ يندفع عنه اعتراض البرماوي).
وقال في (2/ 344): (وبه صرح البرماوي).
وقال في (2/ 373): (تبع فيه الشارح شيخه البرماوي في شرح ألفيته).
7 - زين الدين عبد الرؤف المناوي (952 - 1031 هـ): نقل عن الشمس البرماوي في عِدة مواضع مِن كُتُبه، منها قوله في كتابه "فيض القدير شرح الجامع الصغير":
(وهو ما جرى عليه جَمْعٌ منهم البرماوي، قال الكرماني والبرماوي وأبو زرعة، لكن قال البرماوي، تَعَقَّبه البرماوي بأنَّ .. ).
وأُجيب بأنه لم يذكروه بمعناه الخاص عند الأصوليين، بل بمعنى الكثرة كما قال ابن عبد البر في حديث المسح على الخفين: إنه استفاض وتَواتَر. ونحو ذلك.
والله أعلم.
ص:
261 - [لِذَا] (¬1) يُفِيدُ الْعِلْمَ بِالضَّرُورَهْ ... في جُملَةٍ أَسْلَفْتُها مَشْهُورَهْ
262 - فَحَيْثُمَا الْعِلْمُ بِهِ قَدْ حَصَلَا ... فَآيَةُ اجْتِمَاعِ شَرْطٍ فُصِّلَا
الشرح:
أي: فلأجل أن المتواتر خبر مَن يستحيل تواطؤهم على الكذب كان مفيدًا لسامعه عِلمًا ضروريًّا لا يحتاج إلى نظر، وقد أسلفتُ في المقدمة في تعريف "العِلم" بالمعنى الثالث أنَّ موجب الجزْم فيه إما أن يكون بحسٍّ أو عقل أو [تكرر] (¬2)، والحس إما سمع وهو التواتر إلى غير ذلك من الأقسام المفيدة لليقين بالضرورة وهي محصورة، لكن المتواتر إنما يفيد العلم بالضرورة بشروط، وإنما علامة اجتماعها إفادته العلم.
وهو معنى قولي: (فَآيَةُ اجْتِمَاعِ شَرْطٍ فُصِّلَا) أي: جنس الشرط، وسأذكر هنا تفصيل الشروط، فالكلام يقع في ثلاثة أمور: إفادته العلم، وكونه ضروريًّا، وتفصيل الشروط.
فالأول: ذهب الجمهور إلى ذلك، وقالت السُّمَّنية: لا يفيده. وهي -بضم السين المهملة وتشديد الميم- طائفة من عبدة الأصنام يقولون بالتناسخ، وينقل ذلك أيضًا عن البراهمة
¬__________
(¬1) في (ز، ت، ش، ظ، ن): لذا. وفي (ض، ص، ق): كذا.
(¬2) كذا في (ض، ق). لكن في (ص، ظ، ت، ش): مكرر.
وللقفال الشاشي قول بالوقف، إذ قال: القولان محتملان، ولا يُنكَر أن يكون في "المتشابه" ما لا يُعلم.
ومنهم مَن جمع بين القولين بأن الله تعالى يَعلم ذلك على التفصيل، والراسخون في العلم يعلمونه على الإجمال.
وبالجملة فالمختار: الوقف على {إِلَّا اللهُ}، فإذا جمع بما ذكرناه، زال الإشكال واجتمع القولان.
الثالث: الخلاف في "المتشابه" لا يجري في آيات أحكام الشريعة كما قال الأستاذ أَبو إسحاق؛ إذ ليس شيء منها إلَّا وعُرف بيانه، وليس في السُّنَّة ما يشاكله.
وفي "المنخول" للغزالي أن: ("المتشابه" في الآيات المتضمنة للتكليف مُحال، ويبين المقصود منه رسم المسألة في آية الاستواء، قال مالك لَمَّا سُئل عنه: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة". وقال سفيان بن عيينة: يُفْهَم منه ما يُفهم مِن قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} [البقرة: 29]. وقد تحزَّب الناس فيه، فَضلَّ قوم فأجروه على الظاهر، وفاز مَن قَطع بنفي الاستقرار، وإنْ تردد في مُجْمَله فلا يُعاب عليه، فإنَّ تعليم الأدلة على نفي الاستقرار لا نراه واجبًا على الآحاد، بل يجب على كل شخص في كل إقليم أن يقوم ليدفع البدع إذا [ثارت]) (¬1) (¬2). انتهى
الرابع: مِن هذا الخلاف تشعَّب العلماء في آيات الصفات وأحاديثها المشكلة: هل يجب تأويلها بِناء على أن بعض الراسخين في العِلم قد يَطَّلِعون على المعنى؟ أوْ لا؛ لكونه مما استأثر الله تعالى به، ويحتمل أن المراد غير ما أُوِّل به، فيرون الإمساك عنه لذلك؟
¬__________
(¬1) كذا في (ت، ق)، لكن في (ص، ز، ش، ض، ظ): فارت.
(¬2) المنخول (ص 172).
أربعة. وزاد بعضهم في نقله عن "الرسالة" أنه قال: وهُم الأربعة الذين تخلَّفوا عن أُحد.
لكن الذي رأيته في "الرسالة" في عِدة نُسخ صحيحة في "باب ما يكون من الكتاب عام الظاهر والمراد خاص" ما سبق بدون هذه الزيادة.
أما الناس في قوله تعالى: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} [آل عمران: 173] فذكر كثير من المفسرين أنه أبو سفيان، فيكون أيضًا شاهدًا للمسألة.
ومِثله أيضًا قوله تعالى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء: 54]، المراد بالناس هُم النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قاله كثير، ونحوه أيضًا قوله تعالى: {فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ} [آل عمران: 39]. قيل: هو جبريل وحده، وكذا قيل به في قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ} [آل عمران: 42]، {يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ} [النحل: 2] أيْ: بالوحي؛ لأن الرسول إلى جميع الأنبياء جبريل.
قلتُ: وفي الاستدلال بذلك على المسألة نظر؛ فإن ذلك إنما هو مِن العام المراد به خاص، لا من العام المخصوص، ويدل على ذلك ترجمة الشافعي السابقة.
المذهب الثالث: ما ذهب إليه أبو الحسين، وربما نُقل عن المعتزلة مِن غير تعيين، وإليه مَيل إمام الحرمين، واختاره الغزالي، ونقله بعض المتأخرين عن أكثر أصحابنا: أنه لا بُدَّ مِن بقاء جَمعٍ كثير.
قيل: إلا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيمًا، نحو: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} [المرسلات: 23]. لكن لا حاجة إلى هذا الاستثناء؛ لأن هذا من إطلاق العام وإرادة الخاص، وليس الكلام فيه كما بيَّناه.
وهذا المذهب نقله أيضًا الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين، واختاره الإمام وأتباعه، لكن اختلفوا في تفسير ذلك الجمع الكثير الذي يبقى.
وجعل ابن الحاجب أيضًا من الصريح: "سها، فسجد"، و"زَنَا ماعز، فرجِم"؛ لاحتمال أن يكون المذكور جزءَ علة ولم يذكر الجزء الآخر. فهو وإنْ كان نَصًّا في الاعتبار به لكن ليس نَصَّا في الاستقلال كما في: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6] الآية، فإنَّ التقدير فيها: إذا قمتم مُحْدِثين. فحذف بعض العلة الموجِبة للوضوء. وكذا في: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}، السرقة جزء من الموجِب للقطع؛ لتوقفه على الحرز والنصاب؛ ولذلك اختُلف في أنَّ الآية مُجْمَلة كما سبق.
وبالجملة: فالمدار في الصراحة وعدمها على مَحَال وقوع ذلك فيها. ففي بعض المواضع يتعذر الحمل على غير التعليل؛ فيتعيَّن التعليل، فيكون صريحًا كما سبق في الشرط لفظًا أو معنًى. وفي موضع يحتمل؛ فيكون من الظاهر، لا من الصريح.
والناظر يَعْتَبِر ذلك، ويعمل بمقتضى الحال.
الرابع مِن صِيَغ الظاهر:
" إنَّ" المكسورة المشددة، نحو: {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ} [يوسف: 53]، {إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ} [نوح: 27]، "لبيك، إن الحمد والنعمة لك" (¬1)، "إنك إنْ تذر ورثتك أغنياء خير مِن أنْ تذرهم عالة" (¬2)، "إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" (¬3)، ونحو ذلك، وهو كثير.
وقد أنكر التبريزي على الإمام جَعْلها للتعليل، وسبقه ابن الأنباري إلى إنكار مجيئها
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (1474)، صحيح مسلم (1184).
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) مسند أحمد (22633)، سنن الترمذي (92)، سنن ابن ماجه (367)، شرح معاني الآثار (1/ 18) وغيرها. وقال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: 92، صحيح ابن ماجه: 299).