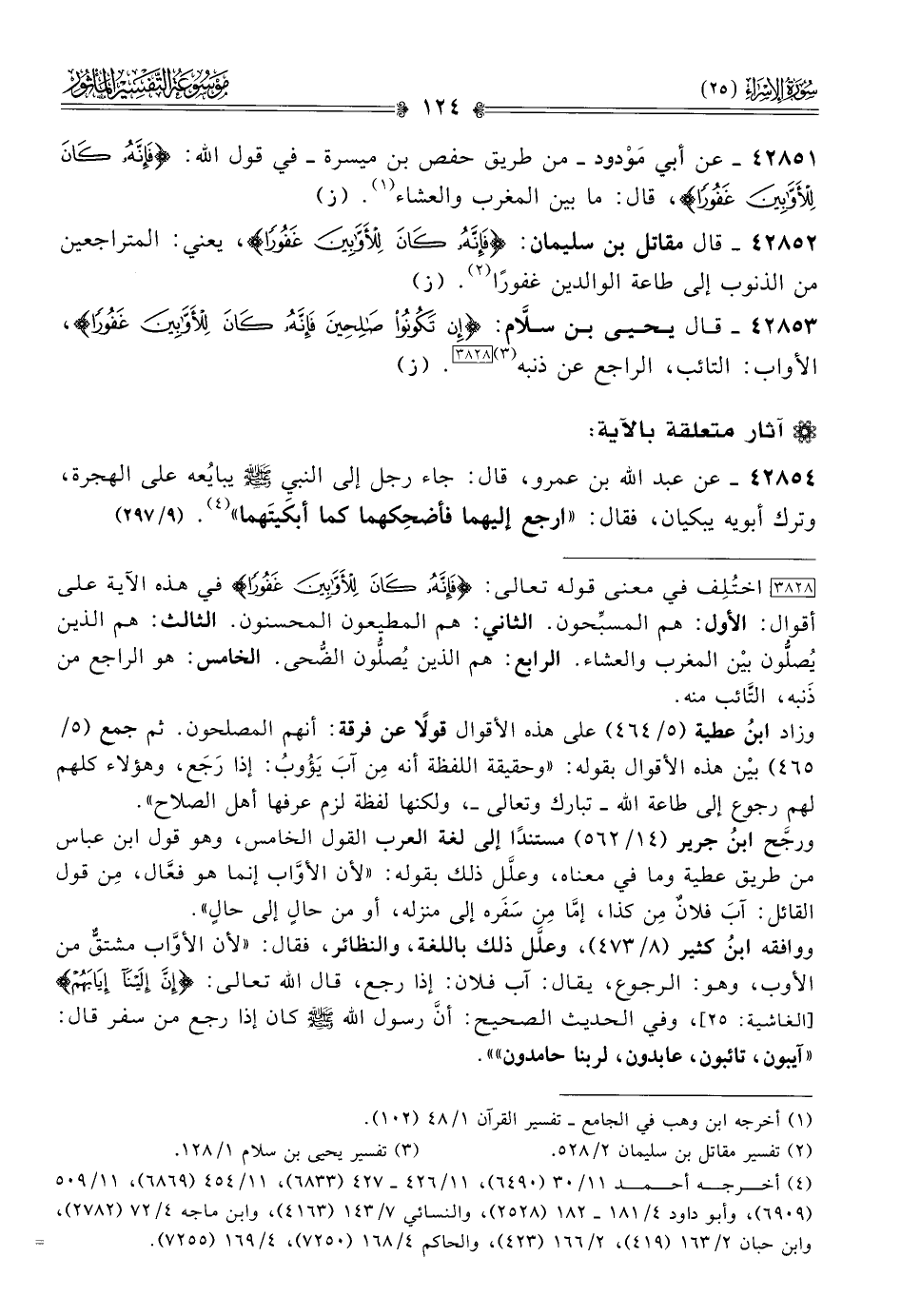
كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 13)
٤٢٨٥١ - عن أبي مَوْدود -من طريق حفص بن ميسرة- في قول الله: {فإنه كان للأوابين غفورا}، قال: ما بين المغرب والعشاء (¬١). (ز)٤٢٨٥٢ - قال مقاتل بن سليمان: {فإنه كان للأوابين غفورا}، يعني: المتراجعين من الذنوب إلى طاعة الوالدين غفورًا (¬٢). (ز)
٤٢٨٥٣ - قال يحيى بن سلّام: {إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا}، الأواب: التائب، الراجع عن ذنبه (¬٣) [٣٨٢٨]. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
٤٢٨٥٤ - عن عبد الله بن عمرو، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايُعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: «ارجع إليهما فأضحِكهما كما أبكَيتَهما» (¬٤). (٩/ ٢٩٧)
---------------
[٣٨٢٨] اختُلِف في معنى قوله تعالى: {فَإنَّهُ كانَ لِلأَوّابِينَ غَفُورًا} في هذه الآية على أقوال: الأول: هم المسبِّحون. الثاني: هم المطيعون المحسنون. الثالث: هم الذين يُصلُّون بيْن المغرب والعشاء. الرابع: هم الذين يُصلُّون الضُّحى. الخامس: هو الراجع من ذَنبه، التّائب منه.
وزاد ابنُ عطية (٥/ ٤٦٤) على هذه الأقوال قولًا عن فرقة: أنهم المصلحون. ثم جمع (٥/ ٤٦٥) بيْن هذه الأقوال بقوله: «وحقيقة اللفظة أنه مِن آبَ يَؤُوبُ: إذا رَجَع، وهؤلاء كلهم لهم رجوع إلى طاعة الله -تبارك وتعالى-، ولكنها لفظة لزم عرفها أهل الصلاح».
ورجَّح ابنُ جرير (١٤/ ٥٦٢) مستندًا إلى لغة العرب القول الخامس، وهو قول ابن عباس من طريق عطية وما في معناه، وعلَّل ذلك بقوله: «لأن الأوّاب إنما هو فعّال، مِن قول القائل: آبَ فلانٌ مِن كذا، إمّا مِن سَفَره إلى منزله، أو من حالٍ إلى حالٍ».
ووافقه ابنُ كثير (٨/ ٤٧٣)، وعلَّل ذلك باللغة، والنظائر، فقال: «لأن الأوّاب مشتقٌّ من الأوب، وهو: الرجوع، يقال: آب فلان: إذا رجع، قال الله تعالى: {إنَّ إلَيْنا إيابَهُمْ} [الغاشية: ٢٥]، وفي الحديث الصحيح: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رجع من سفر قال: «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون»».
_________
(¬١) أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/ ٤٨ (١٠٢).
(¬٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ٥٢٨.
(¬٣) تفسير يحيى بن سلام ١/ ١٢٨.
(¬٤) أخرجه أحمد ١١/ ٣٠ (٦٤٩٠)، ١١/ ٤٢٦ - ٤٢٧ (٦٨٣٣)، ١١/ ٤٥٤ (٦٨٦٩)، ١١/ ٥٠٩ (٦٩٠٩)، وأبو داود ٤/ ١٨١ - ١٨٢ (٢٥٢٨)، والنسائي ٧/ ١٤٣ (٤١٦٣)، وابن ماجه ٤/ ٧٢ (٢٧٨٢)، وابن حبان ٢/ ١٦٣ (٤١٩)، ٢/ ١٦٦ (٤٢٣)، والحاكم ٤/ ١٦٨ (٧٢٥٠)، ٤، ١٦٩ (٧٢٥٥).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال أبو نعيم في الحلية ٧/ ٢٥٠: «مشهور من حديث مسعر». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٤٢٢: «في سنده عطاء بن السائب». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٦٠٥ (١١١٤): «وهو من حديث عطاء بن السائب، لكنه عند أبي داود والنسائي من رواية الثوري، وعند الحاكم من رواية شعبة عنه، وقد سمعا منه قبل الاختلاط». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ٢٨٥ (٢٢٨١): «إسناده صحيح».