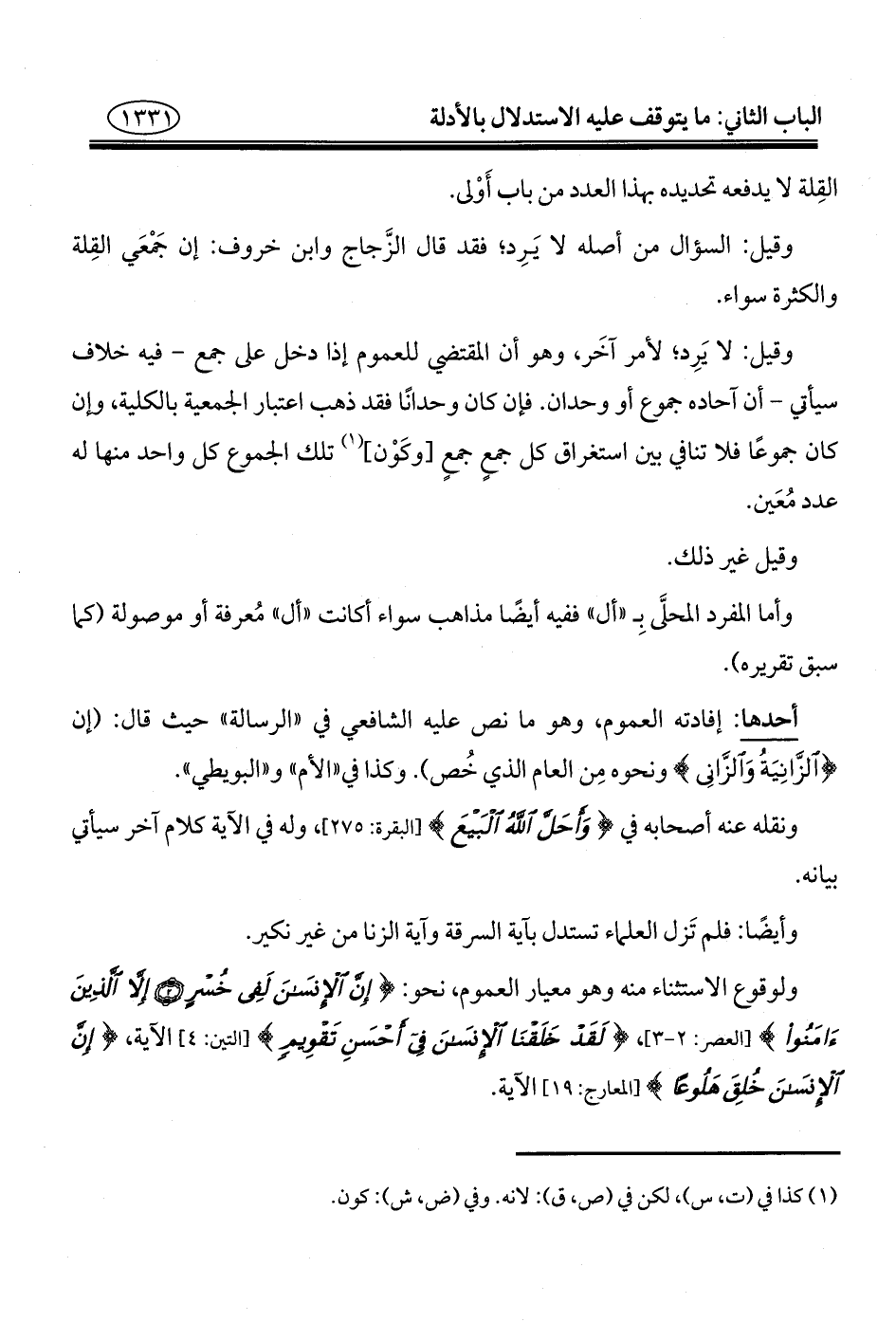
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)
القِلة لا يدفعه تحديده بهذا العدد من باب أَوْلى.وقيل: السؤال من أصله لا يَرِد؛ فقد قال الزَّجاج وابن خروف: إن جَمْعَي القِلة والكثرة سواء.
وقيل: لا يَرِد؛ لأمر آخَر، وهو أن المقتضي للعموم إذا دخل على جمع -فيه خلاف سيأتي- أن آحاده جموع أو وحدان. فإن كان وحدانًا فقد ذهب اعتبار الجمعية بالكلية، وإن كان جموعًا فلا تنافي بين استغراق كل جمعٍ جمعٍ [وكَوْن] (¬١) تلك الجموع كل واحد منها له عدد مُعَين.
وقيل غير ذلك.
وأما المفرد المحلَّى بِـ "أل" ففيه أيضًا مذاهب سواء أكانت "أل" مُعرفة أو موصولة (كما سبق تقريره).
أحدها: إفادته العموم، وهو ما نص عليه الشافعي في "الرسالة" حيث قال: (إن {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} ونحوه مِن العام الذي خُص). وكذا في "الأم" و"البويطي".
ونقله عنه أصحابه في {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥]، وله في الآية كلام آخر سيأتي بيانه.
وأيضًا: فلم تَزل العلماء تستدل بآية السرقة وآية الزنا من غير نكير.
ولوقوع الاستثناء منه وهو معيار العموم، نحو: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} [العصر: ٢ - ٣]، {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين: ٤] الآية، {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا} [المعارج: ١٩] الآية.
---------------
(¬١) كذا في (ت، س)، لكن في (ص، ق): لانه. وفي (ض، ش): كون.