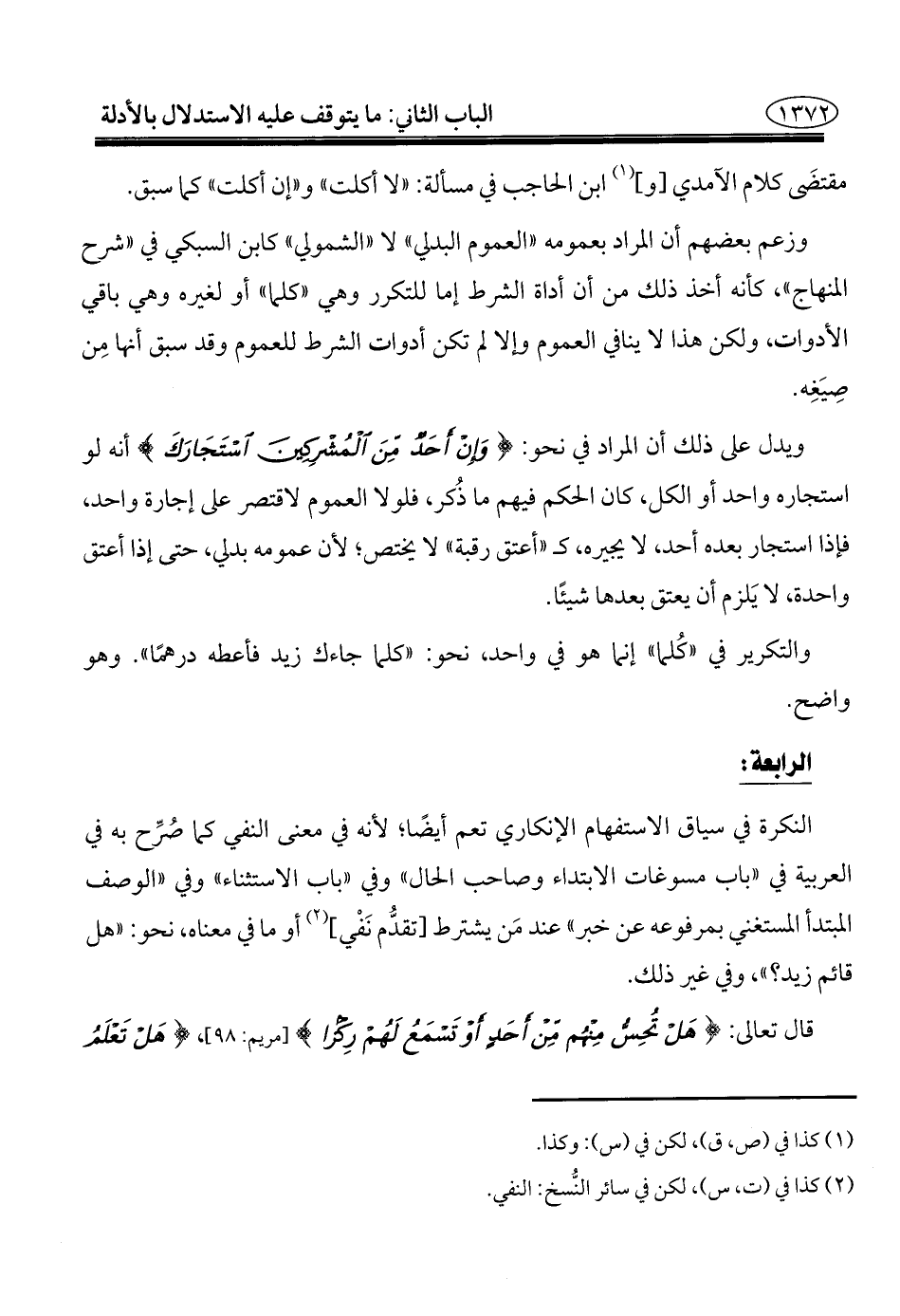
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)
مقتضَى كلام الآمدي [و] (¬١) ابن الحاجب في مسألة: "لا أكلت" و"إن أكلت" كما سبق.وزعم بعضهم أن المراد بعمومه "العموم البدلي" لا "الشمولي" كابن السبكي في "شرح المنهاج"، كأنه أخذ ذلك من أن أداة الشرط إما للتكرر وهي "كلما" أو لغيره وهي باقي الأدوات، ولكن هذا لا ينافي العموم وإلا لم تكن أدوات الشرط للعموم وقد سبق أنها مِن صِيَغِه.
ويدل على ذلك أن المراد في نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} أنه لو استجاره واحد أو الكل، كان الحكم فيهم ما ذُكر، فلولا العموم لاقتصر على إجارة واحد، فإذا استجار بعده أحد، لا يجيره، كـ "أعتق رقبة" لا يختص؛ لأن عمومه بدلي، حتى إذا أعتق واحدة، لا يَلزم أن يعتق بعدها شيئًا.
والتكرير في "كُلما" إنما هو في واحد، نحو: "كلما جاءك زيد فأعطه درهمًا". وهو واضح.
الرابعة:
النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تعم أيضًا؛ لأنه في معنى النفي كما صُرِّح به في العربية في "باب مسوغات الابتداء وصاحب الحال" وفي "باب الاستثناء" وفي "الوصف المبتدأ المستغني بمرفوعه عن خبر" عند مَن يشترط [تقدُّم نَفْي] (¬٢) أو ما في معناه، نحو: "هل قائم زيد؟ "، وفي غير ذلك.
قال تعالى: {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا} [مريم: ٩٨] , {هَلْ تَعْلَمُ
---------------
(¬١) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): وكذا.
(¬٢) كذا في (ت، س)، لكن في سائر النُّسخ: النفي.