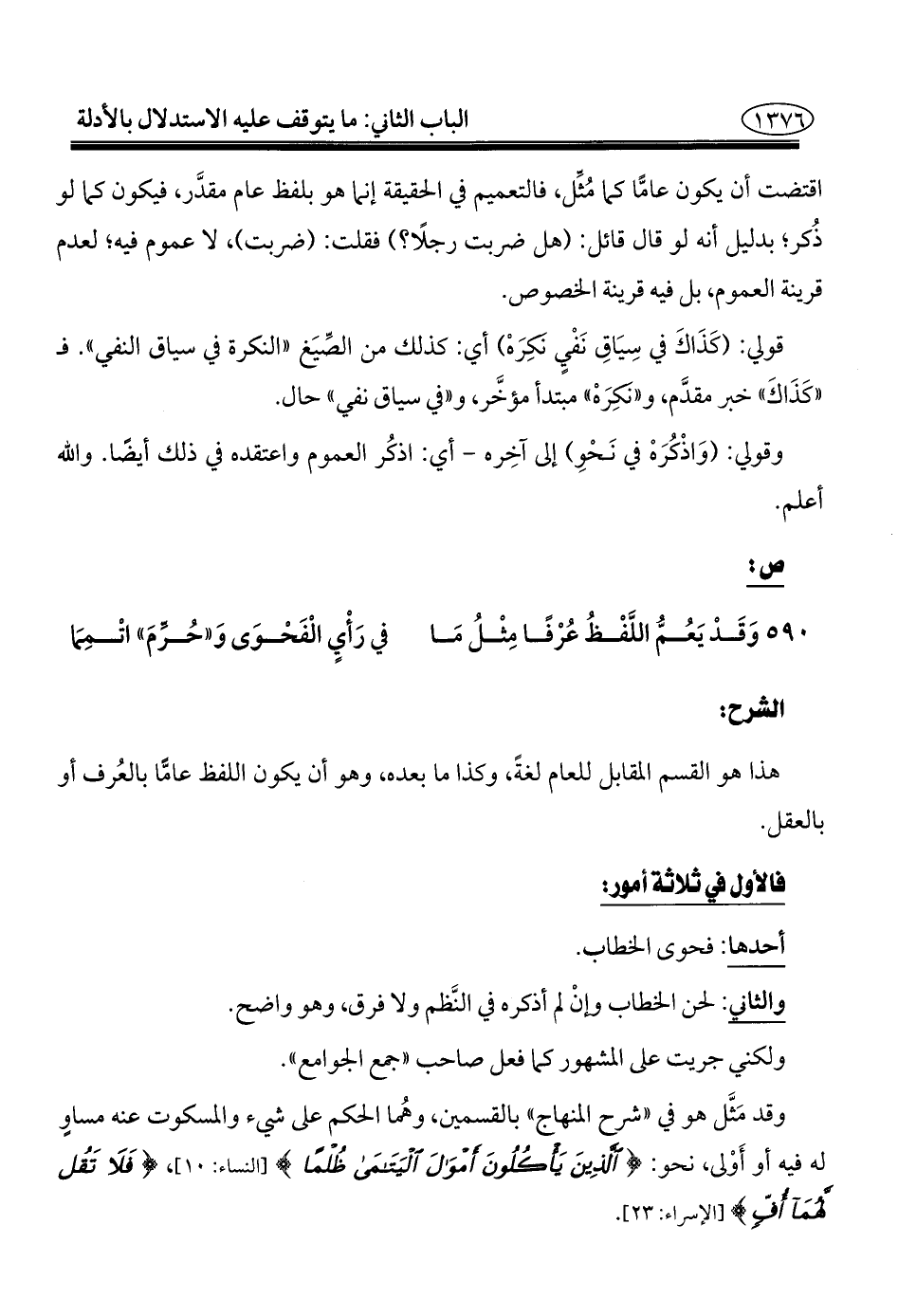
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)
اقتضت أن يكون عامًّا كما مُثِّل، فالتعميم في الحقيقة إنما هو بلفظ عام مقدَّر، فيكون كما لو ذُكر؛ بدليل أنه لو قال قائل: (هل ضربت رجلًا؟ ) فقلت: (ضربت)، لا عموم فيه؛ لعدم قرينة العموم، بل فيه قرينة الخصوص.قولي: (كَذَاكَ في سِيَاقِ نَفْيٍ بكِرَهْ) أي: كذلك من الصِّيَغ "النكرة في سياق النفي". فـ "كَذَاكَ" خبر مقدَّم، و"نَكِرَهْ" مبتدأ مؤخَّر، و"في سياق نفي" حال.
وقوفي: (وَاذْكُرَهْ في نَحْوِ) إلى آخِره -أي: اذكُر العموم واعتقده في ذلك أيضًا. والله أعلم.
ص:
٥٩٠ - وَقَدْ يَعُمُّ اللَّفْظُ عُرْفًا مِثْلُ مَا ... في رَأْيٍ الْفَحْوَى وَ"حُرِّمَ" اتْمِمَا
الشرح:
هذا هو القسم المقابل للعام لغةً، وكذا ما بعده، وهو أن يكون اللفظ عامّا بالعُرف أو بالعقل.
فالأول في ثلاثة أمور:
أحدها: فحوى الخطاب.
الثاني: لحن الخطاب وإنْ لم أذكره في النَّظم ولا فرق، وهو واضح.
ولكني جريت على المشهور كما فعل صاحب "جمع الجوامع".
وقد مَثَّل هو في "شرح المنهاج" بالقسمين، وهُما الحكم على شيء والمسكوت عنه مساوٍ له فيه أو أَوْلى، نحو: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: ١٠] {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣].