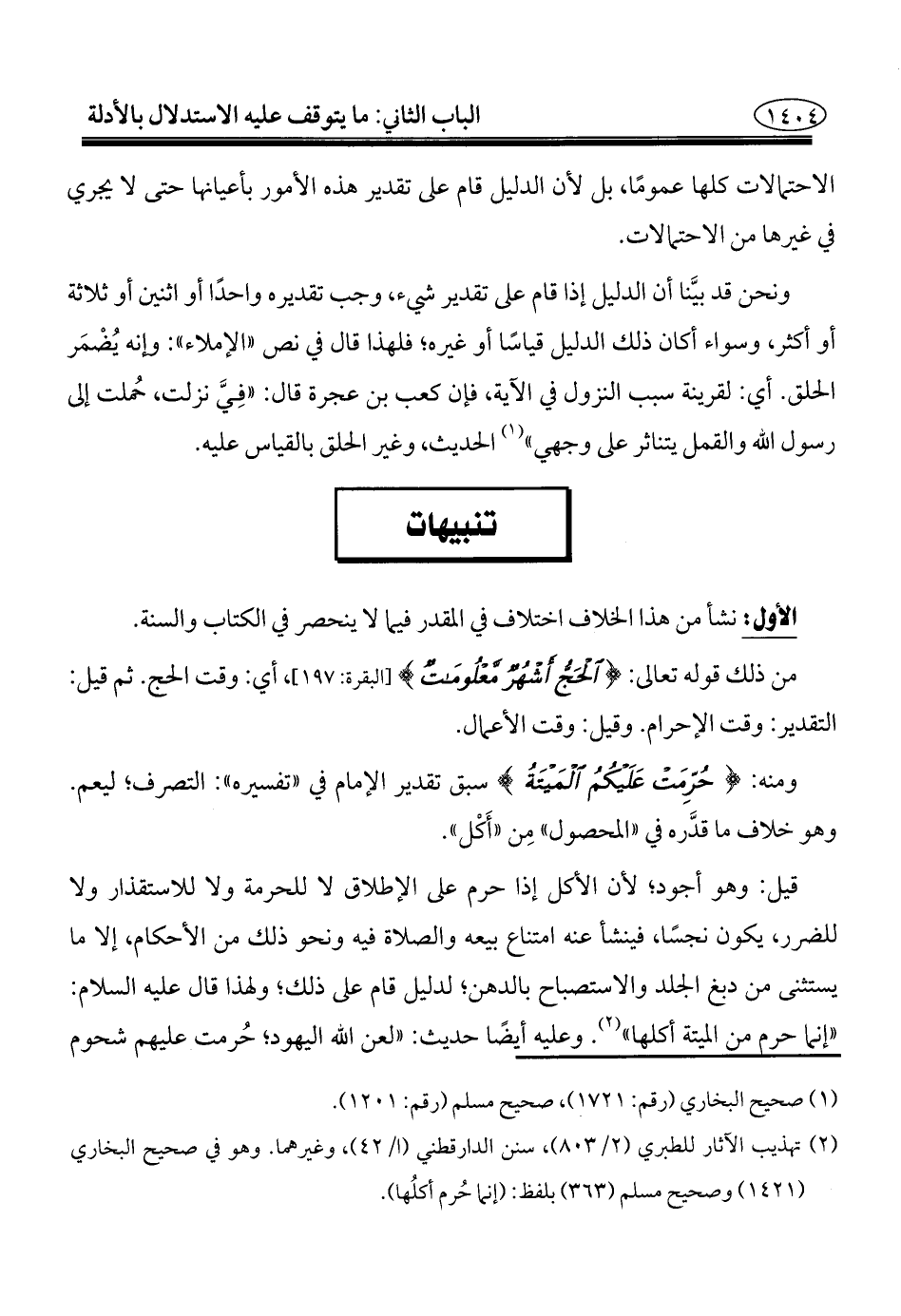
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)
الاحتمالات كلها عمومًا، بل لأن الدليل قام على تقدير هذه الأمور بأعيانها حتى لا يجري في غيرها من الاحتمالات.ونحن قد بيَّنا أن الدليل إذا قام على تقدير شيء، وجب تقديره واحدًا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، وسواء أكان ذلك الدليل قياسًا أو غيره؛ فلهذا قال في نص "الإملاء": وإنه يُضْمَر الحلق. أي: لقرينة سبب النزول في الآية، فإن كعب بن عجرة قال: "فِيَّ نزلت، حُملت إلى رسول الله والقمل يتناثر على وجهي" (¬١) الحديث، وغير الحلق بالقياس عليه.
تنبيهات
الأول: نشأ من هذا الخلاف اختلاف في المقدر فيما لا ينحصر في الكتاب والسنة.
من ذلك قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧] أي: وقت الحج. ثم قيل: التقدير: وقت الإحرام. وقيل: وقت الأعمال.
ومنه: هو {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} سبق تقدير الإِمام في "تفسيره": التصرف؛ ليعم. وهو خلاف ما قدَّره في "المحصول" مِن "أَكْل".
قيل: وهو أجود؛ لأن الأكل إذا حرم على الإطلاق لا للحرمة ولا للاستقذار ولا للضرر، يكون نجسًا، فينشأ عنه امتناع بيعه والصلاة فيه ونحو ذلك من الأحكام، إلا ما يستثنى من دبغ الجلد والاستصباح بالدهن؛ لدليل قام على ذلك، ولهذا قال عليه السلام: "إنما حر من الميتة أكلها" (¬٢). وعليه أيضًا حديث: "لعن الله اليهود؛ حُرمت عليهم شحوم
---------------
(¬١) صحيح البخاري (رقم: ١٧٢١)، صحيح مسلم (رقم: ١٢٠١).
(¬٢) تهذيب الآثار للطبري (٢/ ٨٠٣)، سنن الدارقطني (١/ ٤٢)، وغيرهما. وهو في صحيح البخاري (١٤٢١) وصحيح مسلم (٣٦٣) بلفظ: (إنما حُرم أكلُها).