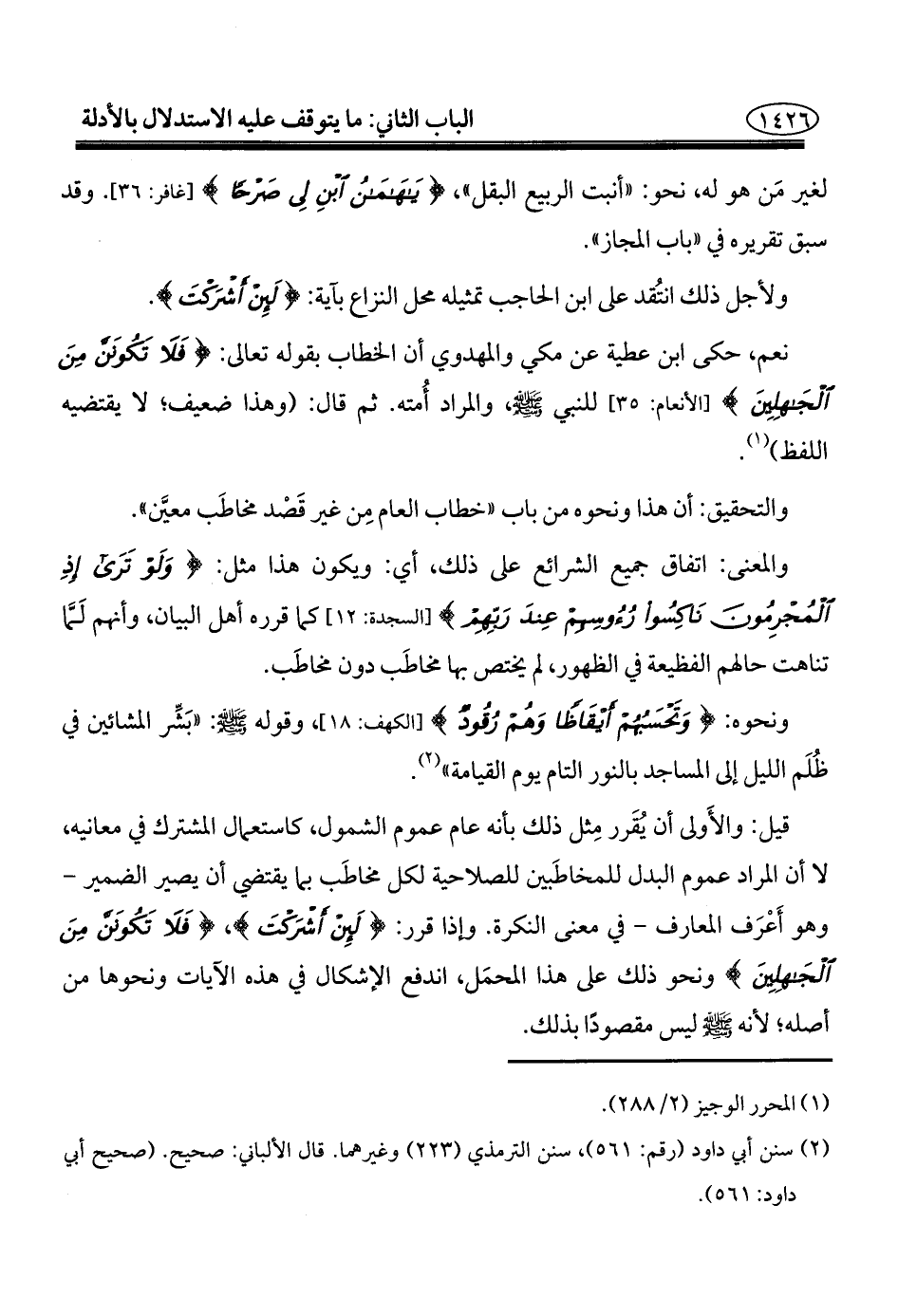
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)
لغير مَن هو له، نحو: "أنبت الربيع البقل"، {يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا} [غافر: ٣٦]. وقد سبق تقريره في "باب المجاز".ولأجل ذلك انتُقد على ابن الحاجب تمثيله محل النزاع بآية: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ}.
نعم، حكى ابن عطية عن مكي والمهدوي أن الخطاب بقوله تعالى: {فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ} [الأنعام: ٣٥] للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والمراد أُمته. ثم قال: (وهذا ضعيف؛ لا يقتضيه اللفظ) (¬١).
والتحقيق: أن هذا ونحوه من باب"خطاب العام مِن غير قَصْد مخاطَب معيَّن".
والمعنى: اتفاق جميع الشرائع على ذلك، أي: ويكون هذا مثل: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [السجدة: ١٢] كما قرره أهل البيان، وأنهم لَمَّا تناهت حالهم الفظيعة في الظهور، لم يختص بها مخاطَب دون مخاطَب.
ونحوه: {وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ} [الكهف: ١٨]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بَشِّر المشائين في ظُلَم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة" (¬٢).
قيل: والأَولى أن يُقَرر مِثل ذلك بأنه عام عموم الشمول، كاستعمال المشترك في معانيه، لا أن المراد عموم البدل للمخاطَبين للصلاحية لكل مخاطَب بما يقتضي أن يصير الضمير - وهو أَعْرَف المعارف - في معنى النكرة. وإذا قرر: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ}، {فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ} ونحو ذلك على هذا المحمَل، اندفع الإشكال في هذه الآيات ونحوها من أصله؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ليس مقصودًا بذلك.
---------------
(¬١) المحرر الوجيز (٢/ ٢٨٨).
(¬٢) سنن أبي داود (رقم: ٥٦١)، سنن التِّرمِذي (٢٢٣) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٥٦١).