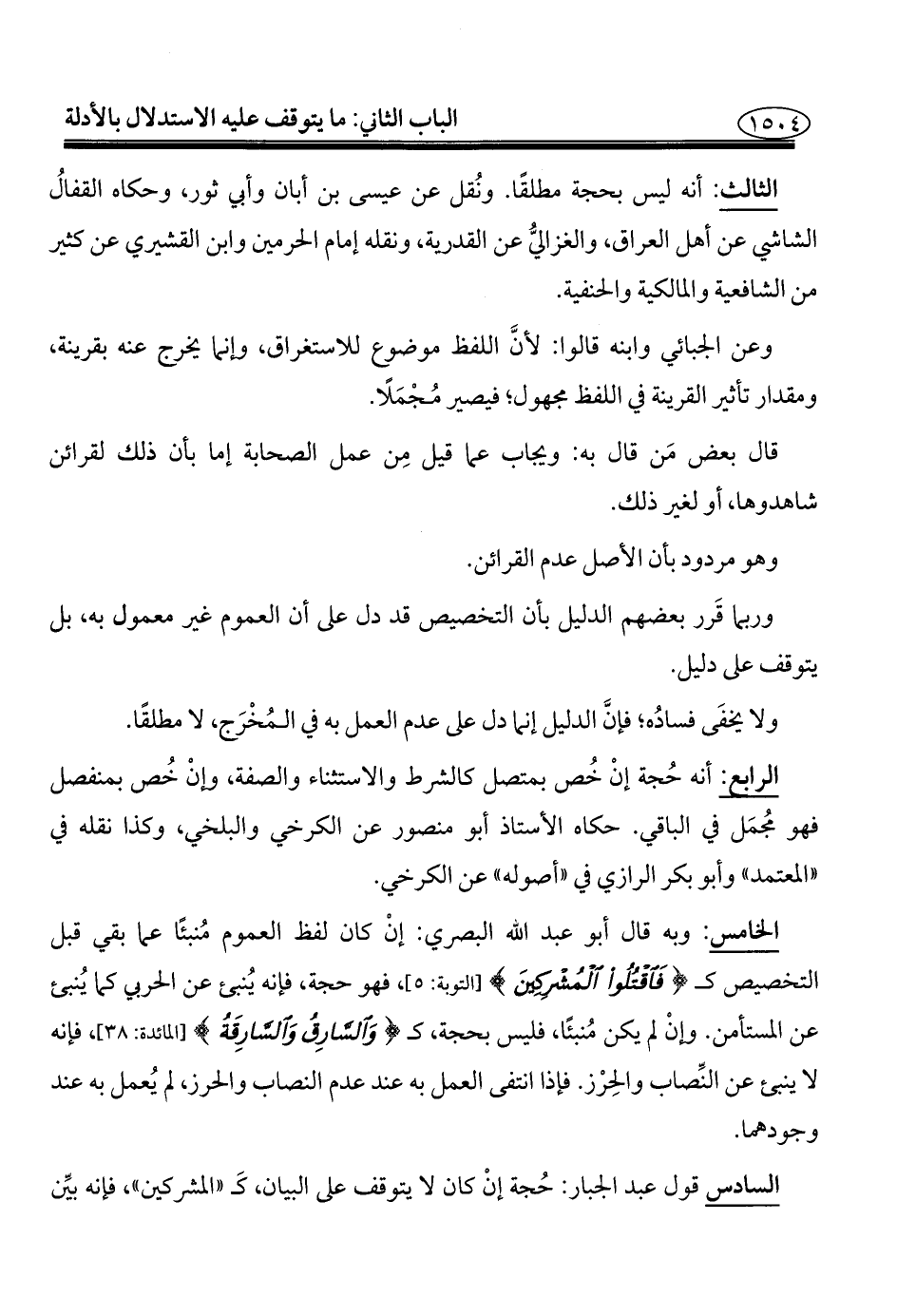
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 4)
الثالث: أنه ليس بحجة مطلقًا. ونُقل عن عيسى بن أبان وأبي ثور، وحكاه القفالُ الشاشي عن أهل العراق، والغزاليُّ عن القدرية، ونقله إمام الحرمين وابن القشيري عن كثير من الشافعية والمالكية والحنفية.وعن الجبائي وابنه قالوا: لأنَّ اللفظ موضوع للاستغراق، وإنما يخرج عنه بقرينة، ومقدار تأثير القرينة في اللفظ مجهول؛ فيصير مُجْمَلًا.
قال بعض مَن قال به: ويجاب عما قيل مِن عمل الصحابة إما بأن ذلك لقرائن شاهدوها، أو لغير ذلك.
وهو مردود بأن الأصل عدم القرائن.
وربما قَرر بعضهم الدليل بأن التخصيص قد دل على أن العموم غير معمول به، بل يتوقف على دليل.
ولا يخفَى فسادُه؛ فإنَّ الدليل إنما دل على عدم العمل به في المُخْرَج، لا مطلقًا.
الرابع: أنه حُجة إنْ خُص بمتصل كالشرط والاستثناء والصفة، وإنْ خُص بمنفصل فهو مجُمَل في الباقي. حكاه الأستاذ أبو منصور عن الكرخي والبلخي، وكذا نقله في "المعتمد" وأبو بكر الرازي في "أصوله" عن الكرخي.
الخامس: وبه قال أبو عبد الله البصري: إنْ كان لفظ العموم مُنبئًا عما بقي قبل التخصيص كـ {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥]، فهو حجة، فإنه يُنبئ عن الحربي كما يُنبئ عن المستأمن. وإنْ لم يكن مُنبئًا، فليس بحجة، كـ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: ٣٨]، فإنه لا ينبئ عن النِّصاب والحِرْز. فإذا انتفى العمل به عند عدم النصاب والحرز، لم يُعمل به عند وجودهما.
السادس قول عبد الجبار: حُجة إنْ كان لا يتوقف على البيان، كَـ "المشركين"، فإنه بيِّن