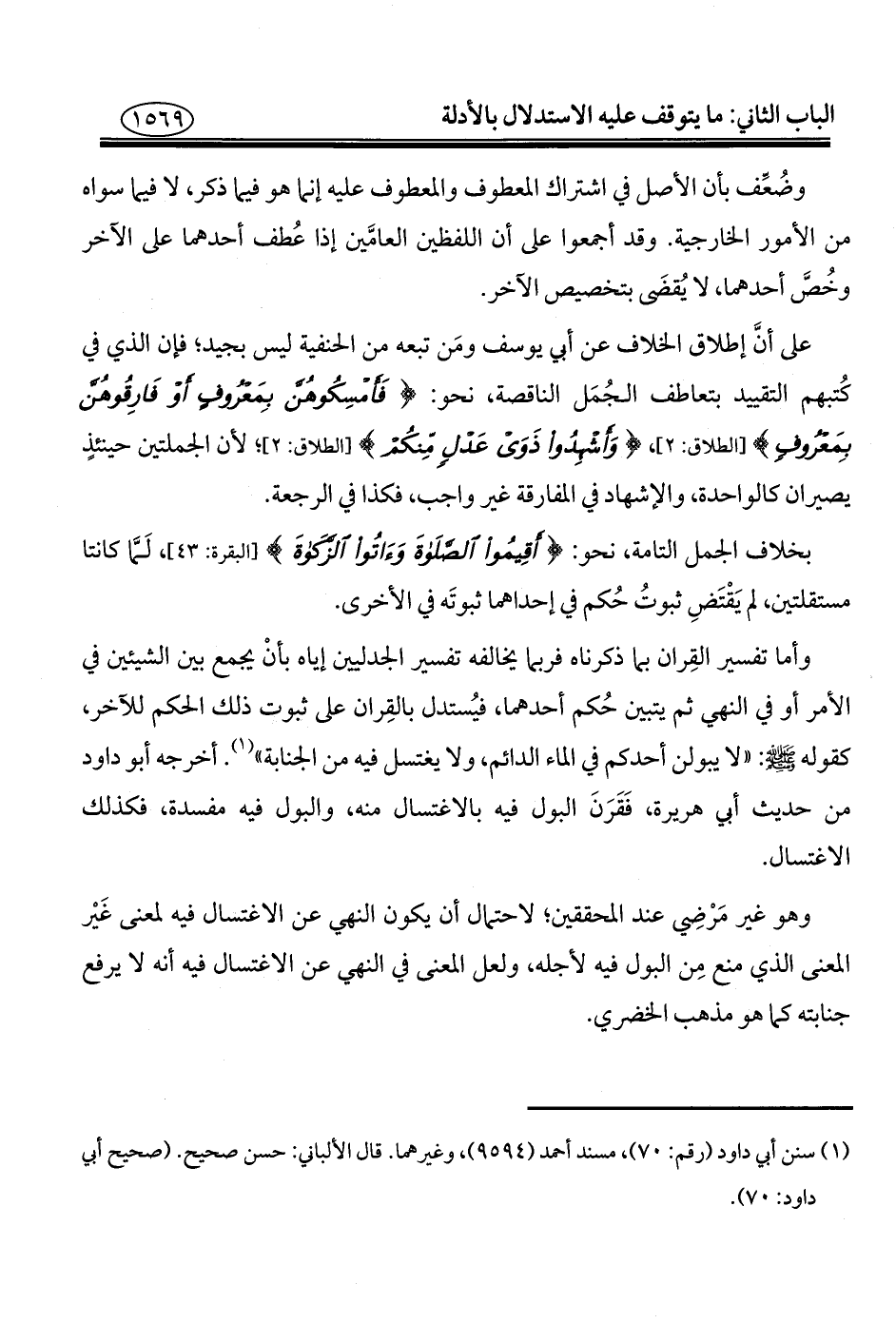
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 4)
وضُعِّف بأن الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إنما هو فيما ذكر، لا فيما سواه من الأمور الخارجية. وقد أجمعوا على أن اللفظين العامَّين إذا عُطف أحدهما على الآخر وخُصَّ أحدهما، لا يُقضَى بتخصيص الآخر.على أنَّ إطلاق الخلاف عن أبي يوسف ومَن تبعه من الحنفية ليس بجيد؛ فإن الذي في كُتبهم التقييد بتعاطف الجُمَل الناقصة، نحو: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٢]، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، لأن الجملتين حينئذٍ يصيران كالواحدة، والإشهاد في المفارقة غير واجب، فكذا في الرجعة.
بخلاف الجمل التامة، نحو: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: ٤٣]، لَمَّا كانتا مستقلتين، لم يَقْتَضِ ثبوتُ حُكم في إحداهما ثبوتَه في الأخرى.
وأما تفسير القِران بما ذكرناه فربما يخالفه تفسير الجدليين إياه بأنْ يجمع بين الشيئين في الأمر أو في النهي ثم يتبين حُكم أحدهما، فيُستدل بالقِران على ثبوت ذلك الحكم للآخر، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة" (¬١). أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة، فَقَرَنَ البول فيه بالاغتسال منه، والبول فيه مفسدة، فكذلك الاغتسال.
وهو غير مَرْضِي عند المحققين؛ لاحتمال أن يكون النهي عن الاغتسال فيه لمعنى غَيْر المعنى الذي منع مِن البول فيه لأجله، ولعل المعنى في النهي عن الاغتسال فيه أنه لا يرفع جنابته كما هو مذهب الخضري.
---------------
(¬١) سنن أبي داود (رقم: ٧٠)، مسند أحمد (٩٥٩٤)، وغيرهما. قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح أبي داود: ٧٠).