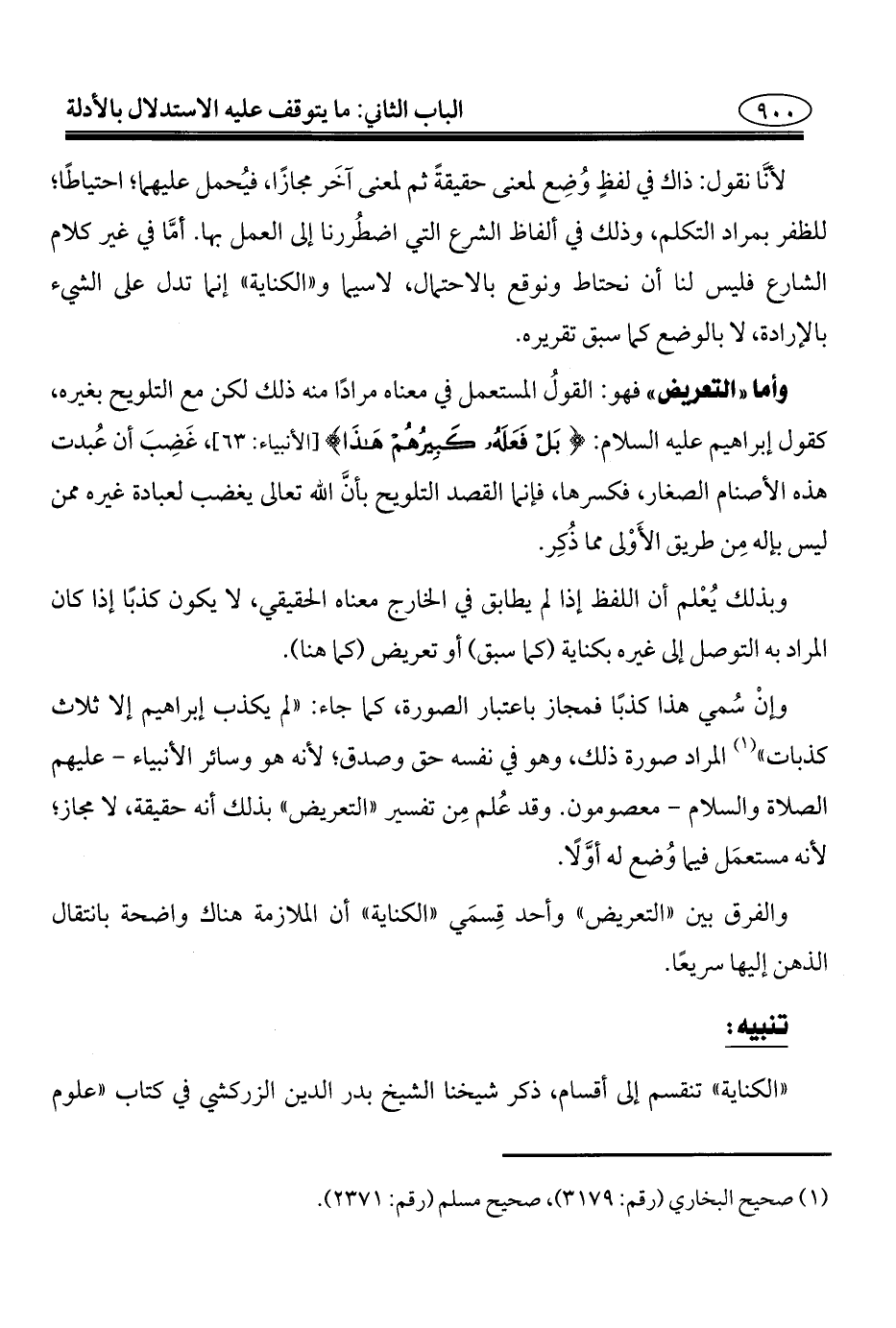
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)
لأنَّا نقول: ذاك في لفظٍ وُضِع لمعنى حقيقةً ثم لمعنى آخَر مجازًا، فيُحمل عليهما؛ احتياطًا؛ للظفر بمراد التكلم، وذلك في ألفاظ الشرع التي اضطُررنا إلى العمل بها. أمَّا في غير كلام الشارع فليس لنا أن نحتاط ونوقع بالاحتمال، لاسيما و"الكناية" إنما تدل على الشيء بالإرادة، لا بالوضع كما سبق تقريره.وأما "التعريض" فهو: القولُ المستعمل في معناه مرادًا منه ذلك لكن مع التلويح بغيره، كقول إبراهيم عليه السلام: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: ٦٣]، غَضِبَ أن عُبدت هذه الأصنام الصغار، فكسرها، فإنما القصد التلويح بأنَّ الله تعالى يغضب لعبادة غيره ممن ليس بإله مِن طريق الأَوْلى مما ذُكِر.
وبذلك يُعْلم أن اللفظ إذا لم يطابق في الخارج معناه الحقيقي، لا يكون كذبًا إذا كان المراد به التوصل إلى غيره بكناية (كما سبق) أو تعريض (كما هنا).
وإنْ سُمي هذا كذبًا فمجاز باعتبار الصورة، كما جاء: "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات" (¬١) المراد صورة ذلك، وهو في نفسه حق وصدق؛ لأنه هو وسائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- معصومون. وقد عُلم مِن تفسير "التعريض" بذلك أنه حقيقة، لا مجاز؛ لأنه مستعمَل فيما وُضع له أوَّلًا.
والفرق بين "التعريض" وأحد قِسمَي "الكناية" أن الملازمة هناك واضحة بانتقال الذهن إليها سريعًا.
تنبيه:
"الكناية" تنقسم إلى أقسام، ذكر شيخنا الشيخ بدر الدين الزركشي في كتاب "علوم
---------------
(¬١) صحيح البخاري (رقم: ٣١٧٩)، صحيح مسلم (رقم: ٢٣٧١).