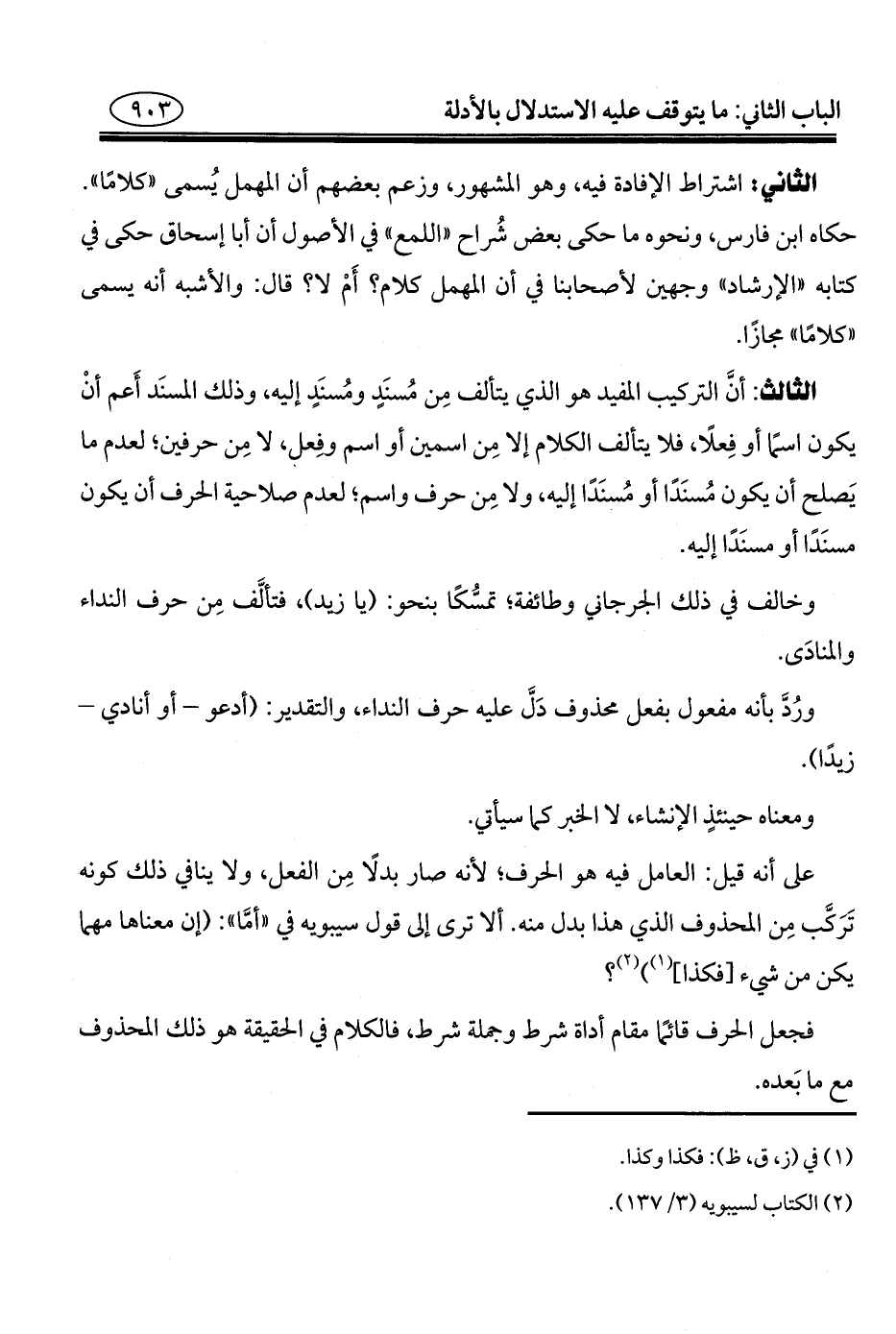
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)
الثاني: اشتراط الإفادة فيه، وهو المشهور، وزعم بعضهم أن المهمل يُسمى "كلامًا". حكاه ابن فارس، ونحوه ما حكى بعض شُراح "اللمع" في الأصول أن أبا إسحاق حكى في كتابه "الإرشاد" وجهين لأصحابنا في أن المهمل كلام؛ أَمْ لا؟ قال: والأشبه أنه يسمى "كلامًا" مجازًا.الثالث: أنَّ التركيب المفيد هو الذي يتألف مِن مُسنَدٍ ومُسنَدٍ إليه، وذلك المسنَد أَعم أنْ يكون اسمًا أو فِعلًا، فلا يتألف الكلام إلا مِن اسمين أو اسم وفِعل، لا مِن حرفين؛ لعدم ما يَصلح أن يكون مُسنَدًا أو مُسنَدًا إليه، ولا مِن حرف واسم؛ لعدم صلاحية الحرف أن يكون مسنَدًا أو مسنَدًا إليه.
وخالف في ذلك الجرجاني وطائفة؛ تمسُّكًا بنحو: (يا زيد)، فتألَّف مِن حرف النداء والمنادَى.
ورُدَّ بأنه مفعول بفعل محذوف دَلَّ عليه حرف النداء، والتقدير: (أدعو -أو أنادي- زيدًا).
ومعناه حينئذٍ الإنشاء، لا الخبر كما سيأتي.
على أنه قيل: العامل فيه هو الحرف؛ لأنه صار بدلًا مِن الفعل، ولا ينافي ذلك كونه تَرَكَّب مِن المحذوف الذي هذا بدل منه. ألا ترى إلى قول سيبويه في "أمَّا": (إن معناها مهما يكن من شيء [فكذا] (¬١) (¬٢)؟
فجعل الحرف قائمًا مقام أداة شرط وجملة شرط، فالكلام في الحقيقة هو ذلك المحذوف مع ما بَعده.
---------------
(¬١) في (ز، ق، ظ): فكذا وكذا.
(¬٢) الكتاب لسيبويه (٣/ ١٣٧).