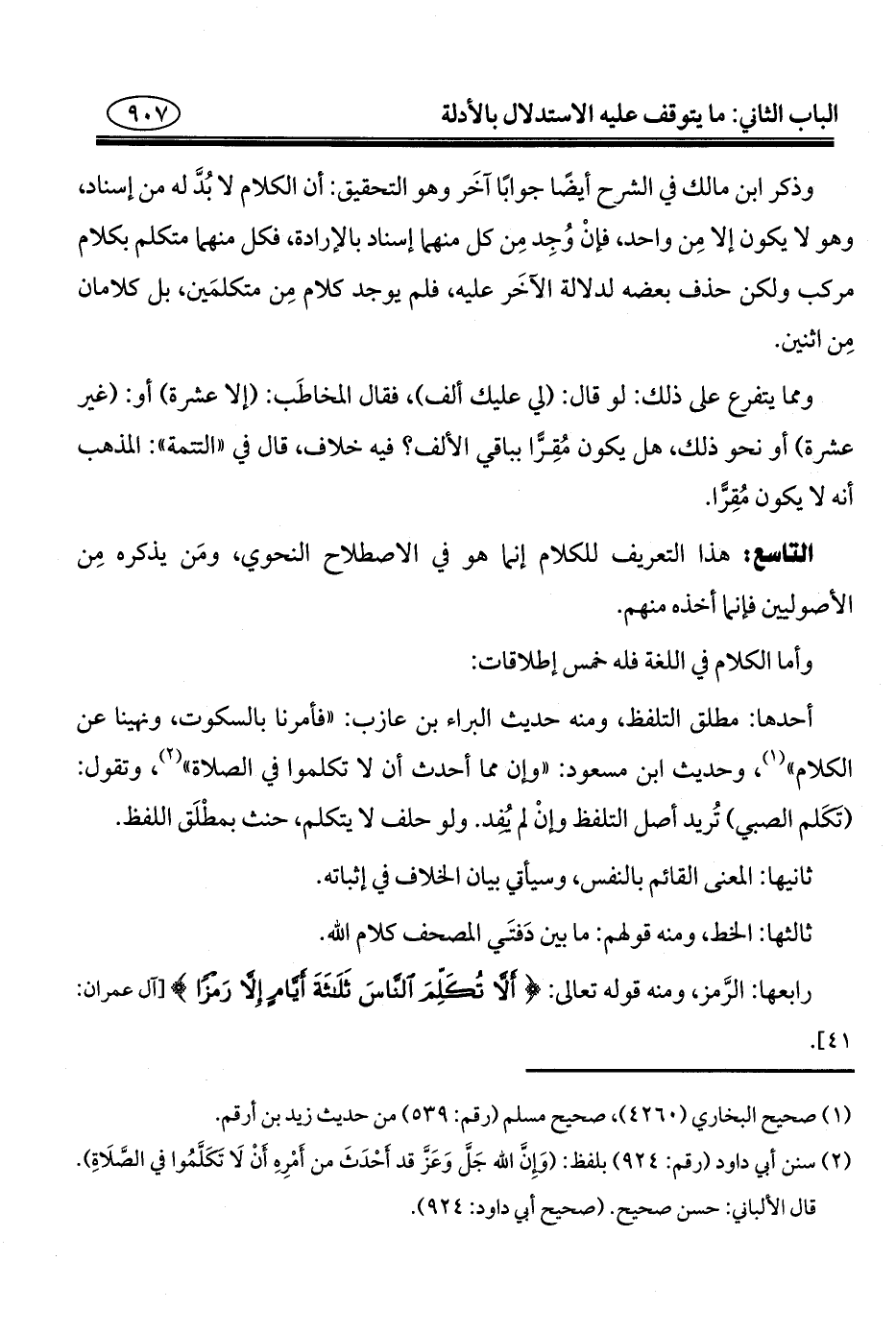
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)
وذكر ابن مالك في الشرح أيضًا جوابًا آخَر وهو التحقيق: أن الكلام لا بُدَّ له من إسناد، وهو لا يكون إلا مِن واحد، فإنْ وُجِد مِن كل منهما إسناد بالإرادة، فكل منهما متكلم بكلام مركب ولكن حذف بعضه لدلالة الآخَر عليه، فلم يوجد كلام مِن متكلمَين، بل كلامان مِن اثنين.ومما يتفرع على ذلك: لو قال: (لي عليك ألف)، فقال المخاطَب: (إلا عشرة) أو: (غير عشرة) أو نحو ذلك، هل يكون مُقِرًّا بباقي الألف؟ فيه خلاف، قال في "التتمة": المذهب أنه لا يكون مُقِرًّا.
التاسع: هذا التعريف للكلام إنما هو في الاصطلاح النحوي، ومَن يذكره مِن الأصوليين فإنما أخذه منهم.
وأما الكلام في اللغة فله خمس إطلاقات:
أحدها: مطلق التلفظ، ومنه حديث البراء بن عازب: "فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام" (¬١)، وحديث ابن مسعود: "وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة" (¬٢)، وتقول: (يَكَلم الصبي) تُريد أصل التلفظ وإنْ لم يُفِد. ولو حلف لا يتكلم، حنث بمطْلَق اللفظ.
ثانيها: المعنى القائم بالنفس، وسيأتي بيان الخلاف في إثباته.
ثالثها: الخط، ومنه قولهم: ما بين دَفتَي المصحف كلام الله.
رابعها: الرَّمز، ومنه قوله تعالى: {أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران: ٤١].
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٤٢٦٠)، صحيح مسلم (رقم: ٥٣٩) من حديث زيد بن أرقم.
(¬٢) سنن أبي داود (رقم: ٩٢٤) بلفظ: (وَإِنَّ الله جَلَّ وَعَزَّ قد أَحْدَثَ من أَمْرِهِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا في الصَّلَاةِ). قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح أبي داود: ٩٢٤).