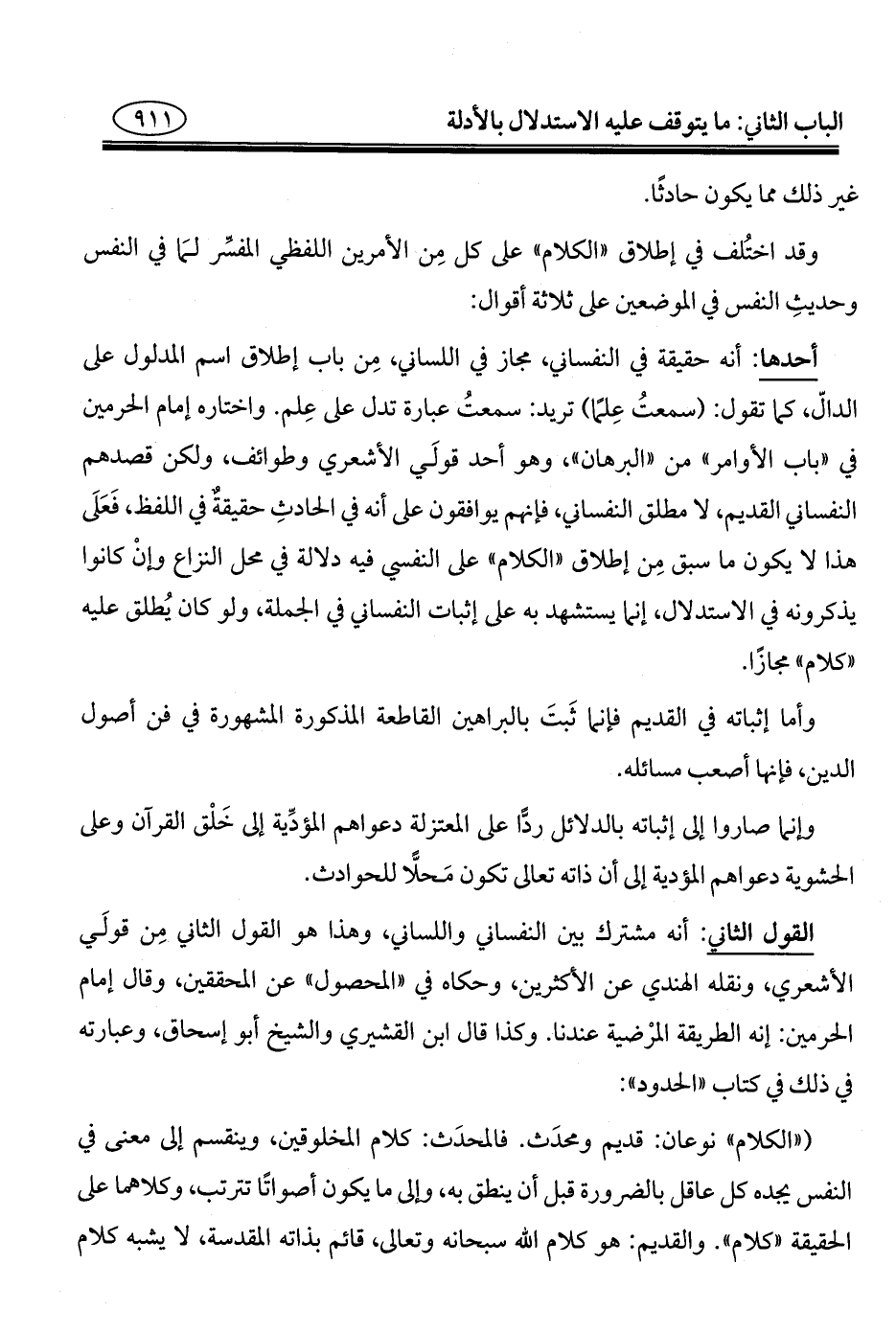
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)
غير ذلك مما يكون حادثًا.وقد اختُلف في إطلاق "الكلام" على كل مِن الأمرين اللفظي المفسِّر لمَا في النفس وحديثِ النفس في الموضعين على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه حقيقة في النفساني، مجاز في اللساني، مِن باب إطلاق اسم المدلول على الدالّ، كما تقول: (سمعتُ عِلمًا) تريد: سمعتُ عبارة تدل على عِلم. واختاره إمام الحرمين في "باب الأوامر" من "البرهان"، وهو أحد قولَي الأشعري وطوائف، ولكن قصدهم النفساني القديم، لا مطلق النفساني، فإنهم يوافقون على أنه في الحادثِ حقيقةٌ في اللفظ، فَعَلَى هذا لا يكون ما سبق مِن إطلاق "الكلام" على النفسي فيه دلالة في محل النزاع وإنْ كانوا يذكرونه في الاستدلال، إنما يستشهد به على إثبات النفساني في الجملة، ولو كان يُطلق عليه "كلام" مجازًا.
وأما إثباته في القديم فإنما ثَبتَ بالبراهين القاطعة المذكورة المشهورة في فن أصول الدين، فإنها أصعب مسائله.
وإنما صاروا إلى إثباته بالدلائل ردًّا على المعتزلة دعواهم المؤدِّية إلى خَلْق القرآن وعلى الحشوية دعواهم المؤدية إلى أن ذاته تعالى تكون مَحلًّا للحوادث.
القول الثاني: أنه مشترك بين النفساني واللساني، وهذا هو القول الثاني مِن قولَي الأشعري، ونقله الهندي عن الأكثرين، وحكاه في "المحصول" عن المحققين، وقال إمام الحرمين: إنه الطريقة المرْضية عندنا. وكذا قال ابن القشيري والشيخ أبو إسحاق، وعبارته في ذلك في كتاب "الحدود":
("الكلام" نوعان: قديم ومحدَث. فالمحدَث: كلام المخلوقين، وينقسم إلى معنى في النفس يجده كل عاقل بالضرورة قبل أن ينطق به، وإلى ما يكون أصواتًا تترتب، وكلاهما على الحقيقة "كلام". والقديم: هو كلام الله سبحانه وتعالى، قائم بذاته المقدسة، لا يشبه كلام