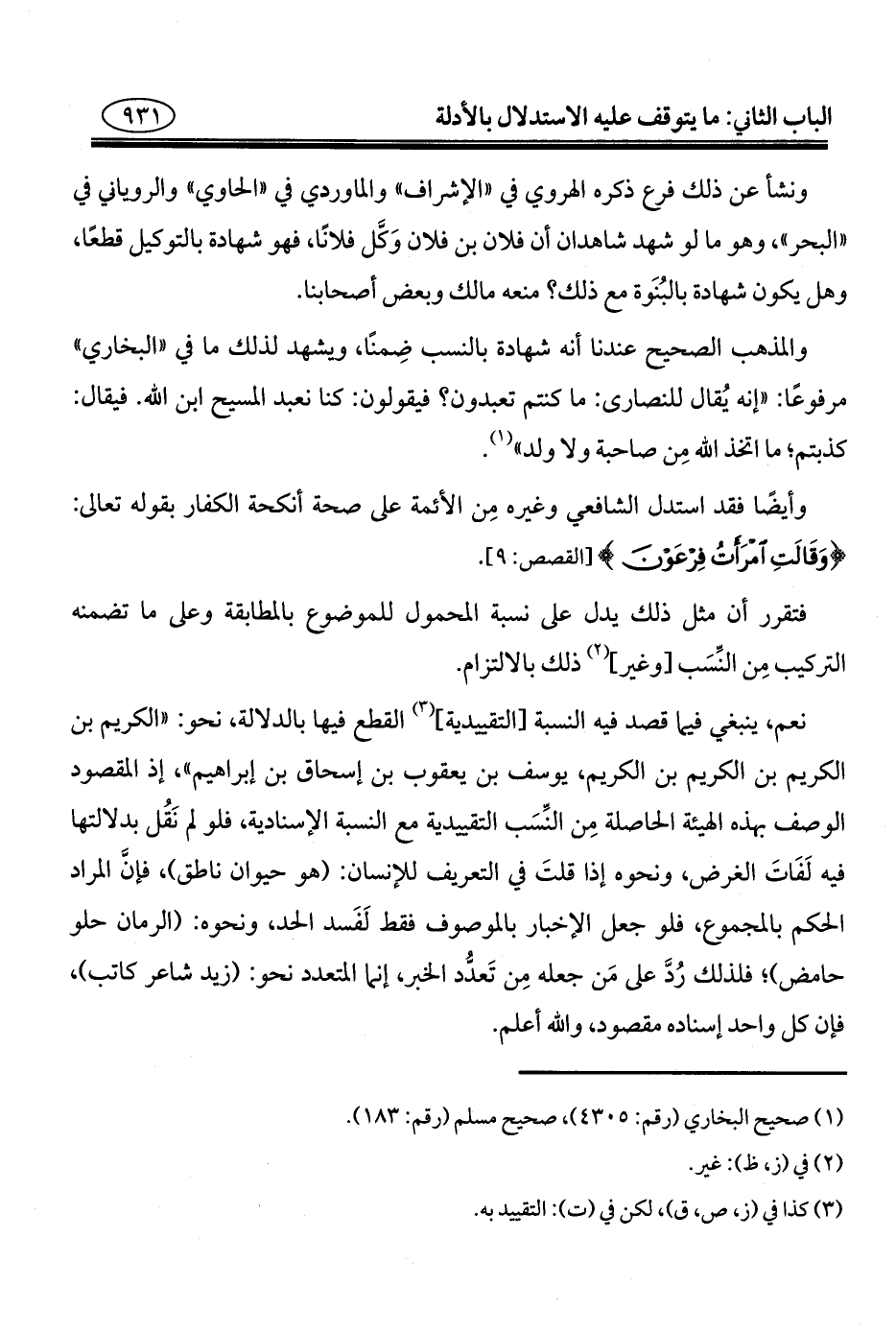
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)
ونشأ عن ذلك فرع ذكره الهروي في "الإشراف" والماوردي في "الحاوي" والروياني في "البحر"، وهو ما لو شهد شاهدان أن فلان بن فلان وَكَّل فلانًا، فهو شهادة بالتوكيل قطعًا، وهل يكون شهادة بالبُنَوة مع ذلك؟ منعه مالك وبعض أصحابنا.والمذهب الصحيح عندنا أنه شهادة بالنسب ضِمنًا، ويشهد لذلك ما في "البخاري" مرفوعًا: "إنه يُقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم؛ ما اتخذ الله مِن صاحبة ولا ولد" (¬١).
وأيضًا فقد استدل الشافعي وغيره مِن الأئمة على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى: {وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ} [القصص: ٩].
فتقرر أن مثل ذلك يدل على نسبة المحمول للموضوع بالمطابقة وعلى ما تضمنه التركيب مِن النِّسَب [وغير] (¬٢) ذلك بالالتزام.
نعم، ينبغي فيما قصد فيه النسبة [التقييدية] (¬٣) القطع فيها بالدلالة، نحو: "الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم"، إذ المقصود الوصف بهذه الهيئة الحاصلة مِن النِّسَب التقييدية مع النسبة الإسنادية، فلو لم نَقُل بدلالتها فيه لَفَاتَ الغرض، ونحوه إذا قلتَ في التعريف للإنسان: (هو حيوان ناطق)، فإنَّ المراد الحكم بالمجموع، فلو جعل الإخبار بالموصوف فقط لَفَسد الحد، ونحوه: (الرمان حلو حامض)؛ فلذلك رُدَّ على مَن جعله مِن تَعدُّد الخبر، إنما المتعدد نحو: (زيد شاعر كاتب)، فإن كل واحد إسناده مقصود، والله أعلم.
---------------
(¬١) صحيح البخاري (رقم: ٤٣٠٥)، صحيح مسلم (رقم: ١٨٣).
(¬٢) في (ز، ظ): غير.
(¬٣) كذا في (ز، ص، ق)، لكن في (ت): التقييد به.