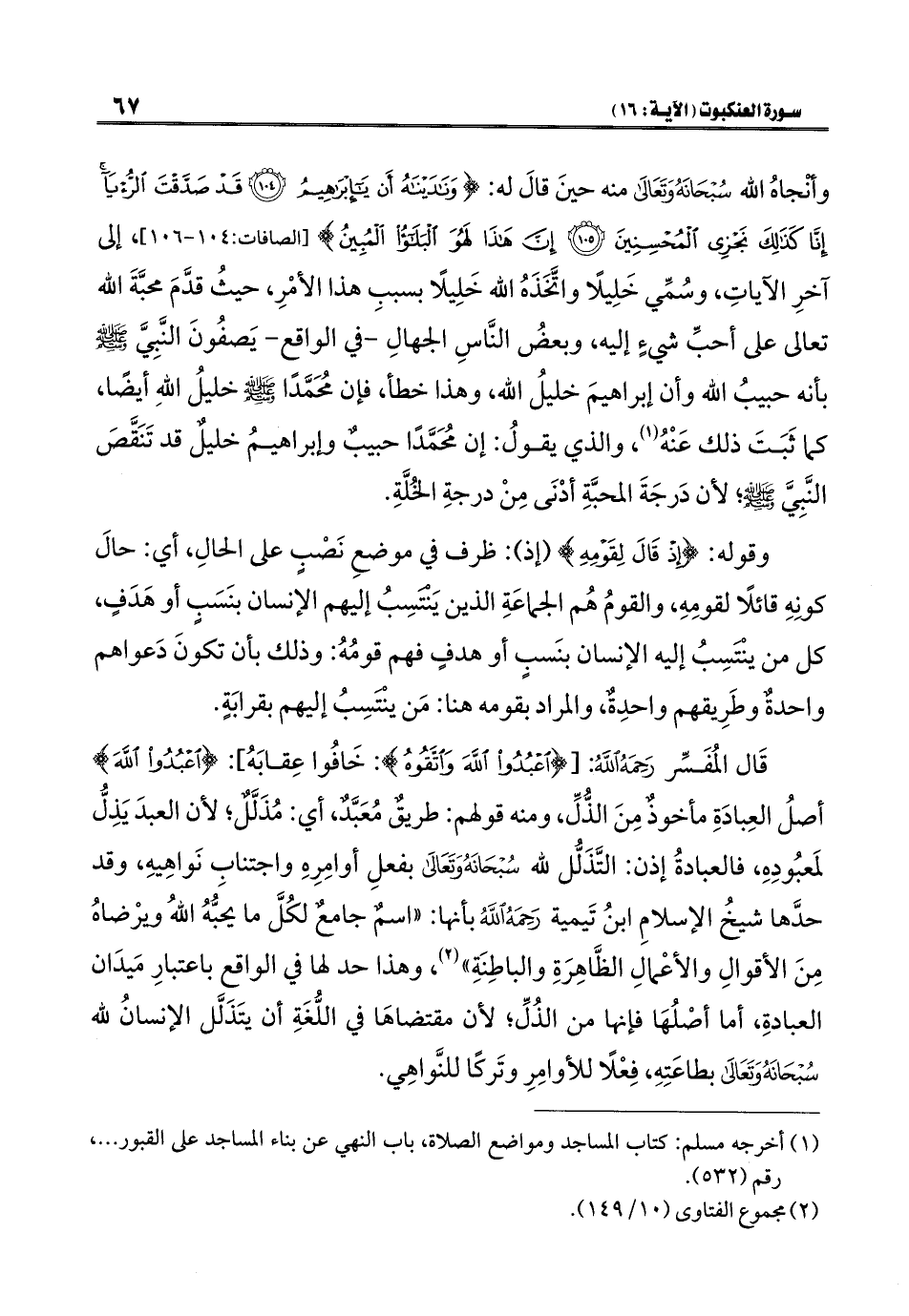
كتاب تفسير العثيمين: العنكبوت
وأنْجاهُ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى منه حينَ قالَ له: {وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ} [الصافات: ١٠٤ - ١٠٦]، إلى آخرِ الآياتِ، وسُمِّي خَلِيلًا واتَّخَذَهُ اللَّه خَلِيلًا بسببِ هذا الأمْرِ، حيثُ قدَّمَ محبَّةَ اللَّه تعالى على أحبِّ شيءٍ إليه، وبعضُ النَّاسِ الجهالِ -في الواقع- يَصفُونَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنه حبيبُ اللَّه وأن إبراهيمَ خليلُ اللَّه، وهذا خطأ، فإن مُحَمَّدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- خليلُ اللَّهِ أيضًا، كما ثَبَتَ ذلك عَنْهُ (¬١)، والذي يقولُ: إن مُحَمَّدًا حبيبٌ وإبراهيمُ خليلٌ قد تَنَقَّصَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن دَرجَةَ المحبَّةِ أدْنَى مِنْ درجةِ الخُلَّةِ.وقوله: {إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ} (إذ): ظرف في موضعِ نَصْبٍ على الحالِ، أي: حالَ كونِهِ قائلًا لقومِهِ، والقومُ هُم الجماعَةِ الذين يَنتسِبُ إليهم الإنسان بنَسَبٍ أو هَدَفٍ، كل من ينْتَسِبُ إليه الإنسان بنَسبٍ أو هدفٍ فهم قومُهُ: وذلك بأن تكونَ دَعواهم واحدةٌ وطَرِيقهم واحدِةٌ، والمراد بقومه هنا: مَن ينْتَسِبُ إليهم بقرابَةٍ.
قَال المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [{اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ}: خَافُوا عِقابَهُ]: {اعْبُدُوا اللَّهَ} أصلُ العِبادَةِ مأخوذٌ مِنَ الذُّلِّ، ومنه قولهم: طريقٌ مُعَبَّدٌ، أي: مُذَلَّلٌ؛ لأن العبدَ يَذِلُّ لمَعبُودِهِ، فالعبادةُ إذن: التَّذَلُّل للَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بفعلِ أوامِرِهِ واجتنابِ نَواهِيهِ، وقد حدَّها شيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيمية رَحِمَهُ اللَّهُ بأنها: "اسمٌ جامعٌ لكُلَّ ما يحبُّهُ اللَّهُ ويرْضاهُ مِنَ الأقوالِ والأعْمالِ الظَّاهِرَةِ والباطِنَةِ" (¬٢)، وهذا حد لها في الواقع باعتبارِ مَيدَان العبادةِ، أما أصْلُهَا فإنها من الذُلِّ؛ لأن مقتضاهَا في اللُّغَةِ أن يتَذَلَّل الإنسانُ للَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بطاعَتِهِ، فِعْلًا للأوامِرِ وتَركًا للنَّواهِي.
---------------
(¬١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور. . .، رقم (٥٣٢).
(¬٢) مجموع الفتاوى (١٠/ ١٤٩).