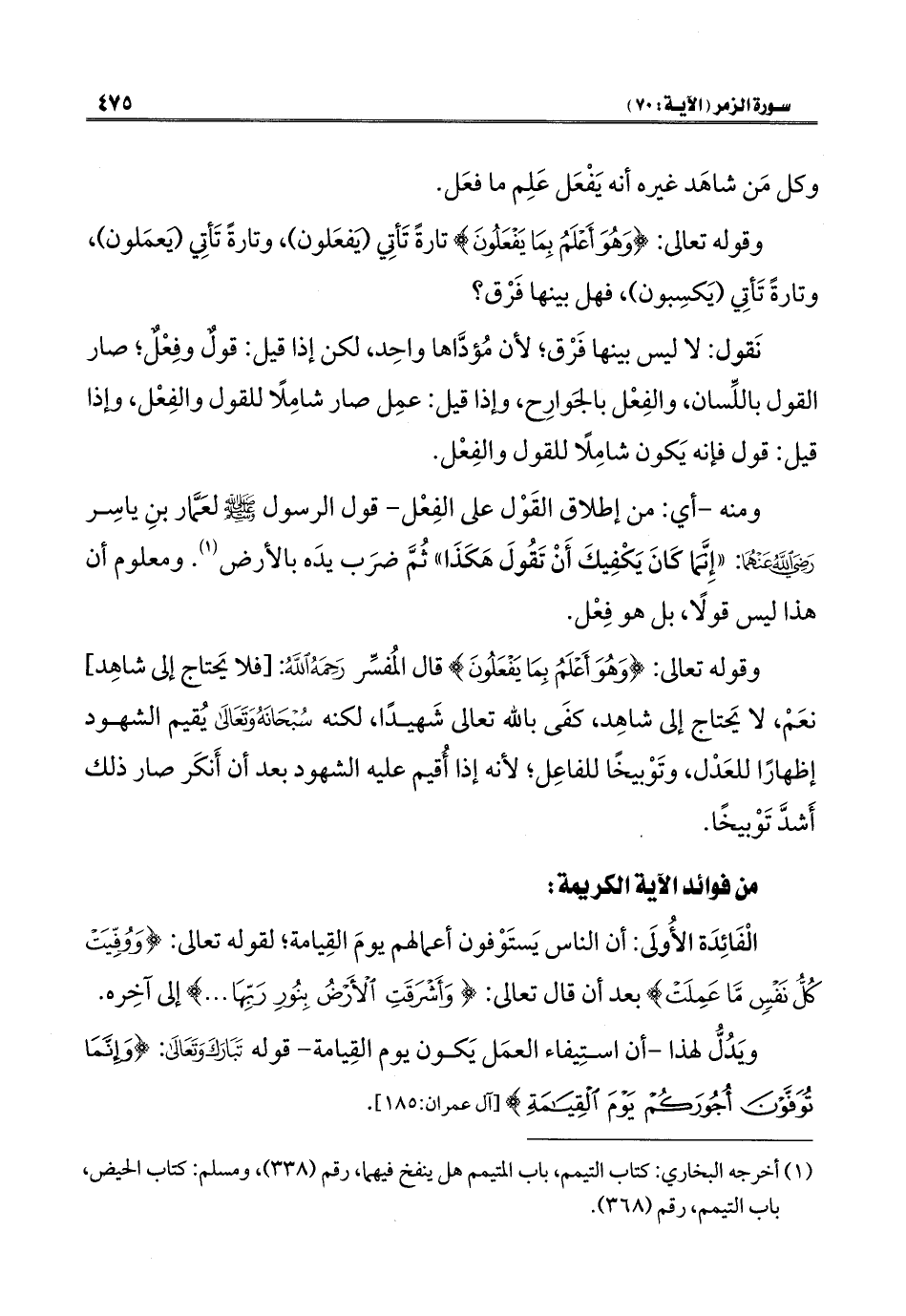
كتاب تفسير العثيمين: الزمر
وكل مَن شاهَد غيره أنه يَفْعَل عَلِم ما فعَل.وقوله تعالى: {وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ} تارةً تَأتِي (يفعَلون)، وتارةً تَأتِي (يعمَلون)، وتارةً تَأتِي (يَكسِبون)، فهل بينها فَرْق؟
نَقول: لا ليس بينها فَرْق؛ لأن مُؤدَّاها واحِد، لكن إذا قيل: قولٌ وفِعْلٌ؛ صار القول باللِّسان، والفِعْل بالجَوارِح، وإذا قيل: عمِل صار شامِلًا للقول والفِعْل، وإذا قيل: قول فإنه يَكون شامِلًا للقول والفِعْل.
ومنه - أي: من إطلاق القَوْل على الفِعْل - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعَمَّار بنِ ياسِر - رضي الله عنهما -: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا" ثُمَّ ضرَب يدَه بالأرض (١). ومعلوم أن هذا ليس قولًا، بل هو فِعْل.
وقوله تعالى: {وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ} قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [فلا يَحتاج إلى شاهِد] نعَمْ، لا يَحتاج إلى شاهِد، كفَى بالله تعالى شَهيدًا، لكنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُقيم الشهود إظهارًا للعَدْل، وتَوْبيخًا للفاعِل؛ لأنه إذا أُقيم عليه الشهود بعد أن أَنكَر صار ذلك أَشدَّ تَوْبيخًا.
من فوائد الآية الكريمة:
الْفَائِدَة الأُولَى: أن الناس يَستَوْفون أعمالهم يومَ القِيامة؛ لقوله تعالى: {وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ} هو بعد أن قال تعالى: {وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ... } إلى آخِره.
ويَدُلُّ لهذا - أن استِيفاء العمَل يَكون يوم القِيامة - قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: ١٨٥].
---------------
(١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، رقم (٣٣٨)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨).