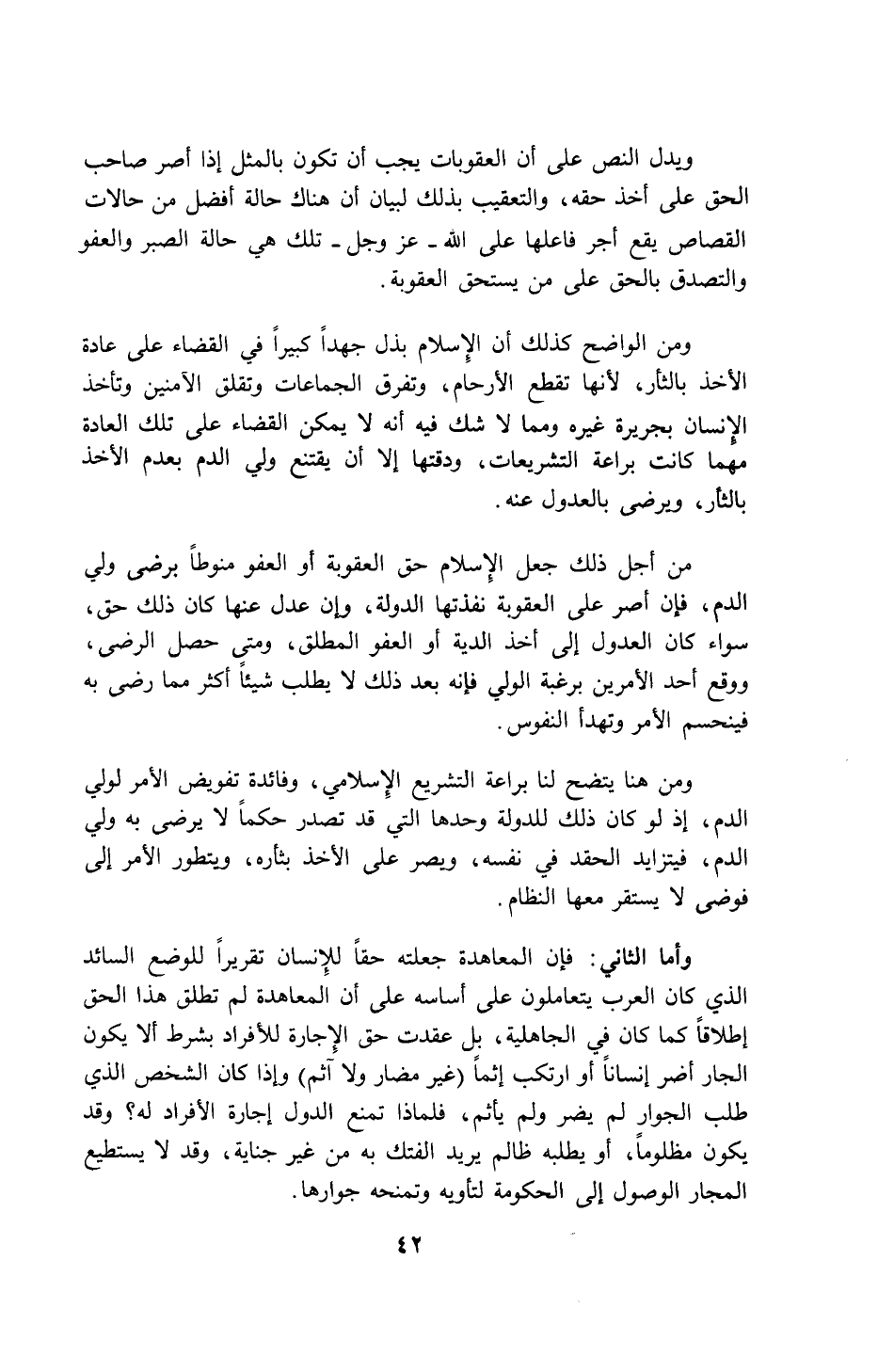
كتاب المدينة المنورة عاصمة الإسلام الأولى
ويدل النص على أن العقوبات يجب أن تكون بالمثل إذا أصر صاحبالحق على أخذ حقه، والتعقيب بذلك لبيان أن هناك حالة أفضل من حالات
القصاص يقع أجر فاعلها على الله - عز وجل - تلك هي حالة الصبر والعفو
والتصدق بالحق على من يستحق العقوبة.
ومن الواضح كذلك أن الإسلام بذل جهدا كبيرا في القفاء على عادة
الأخذ بالثأر، لأنها تقطع الأرحام، وتفرق الجماعات وتقلق الامنين وتأخذ
الإنسان بجريرة غيره ومما لا شك فيه أنه لا يمكن القفاء على تلك العادة
مهما كانت براعة التشريعات، ودقتها إلا أن يقتنع ولي الدم بعدم الأخذ
بالثار، ويرضى بالعدول عنه.
من أجل ذلك جعل الإسلام حق العقوبة أو العفو منوطا برضى ولي
الدم، فإن أصر على العقوبة نفذتها الدولة، وإن عدل عنها كان ذلك حق،
سواء كان العدول إلى أخذ الدية أو العفو المطلق، ومتى حصل الرضى،
ووقع أحد الأمرين برغبة الولي فإنه بعد ذلك لا يطلب شيئا أكثر مما رضى به
فينحسم الأمر وتهدأ النفوس.
ومن هنا يتضح لنا براعة التشريع الإسلامي، وفايدة تفويض الأمر لولي
الدم، إذ لو كان ذلك للدولة وحدها التي قد تصدر حكما لا يرضى به ولي
الدم، فيتزايد الحقد في نفسه، ويصر على الأخذ بثأره، ويتطور الأمر إلى
فوضى لا يستقر معها النظام.
واما الثاني: فإن المعاهدة جعلته حقا للإنسان تقريرا للوضع السائد
الذي كان العرب يتعاملون على أساسه على أن المعاهدة لم تطلق هذا الحق
إطلاقا كما كان في الجاهلية، بل عقدت حق الإجارة للأفراد بشرط ألا يكون
الجار أضر إنسانا أو ارتكب إثما (غير مضار ولا اثم) و (ذا كان الشخص الذي
طلب الجوار لم يضر ولم يأثم، فلماذا تمنع الدول إجارة الأفراد له؟ وقد
يكون مظلوما، أو يطلبه ظالم يريد الفتك به من غير جناية، وقد لا يستطيع
المجار الوصول إلى الحكومة لتأويه وتمنحه جوارها.
42