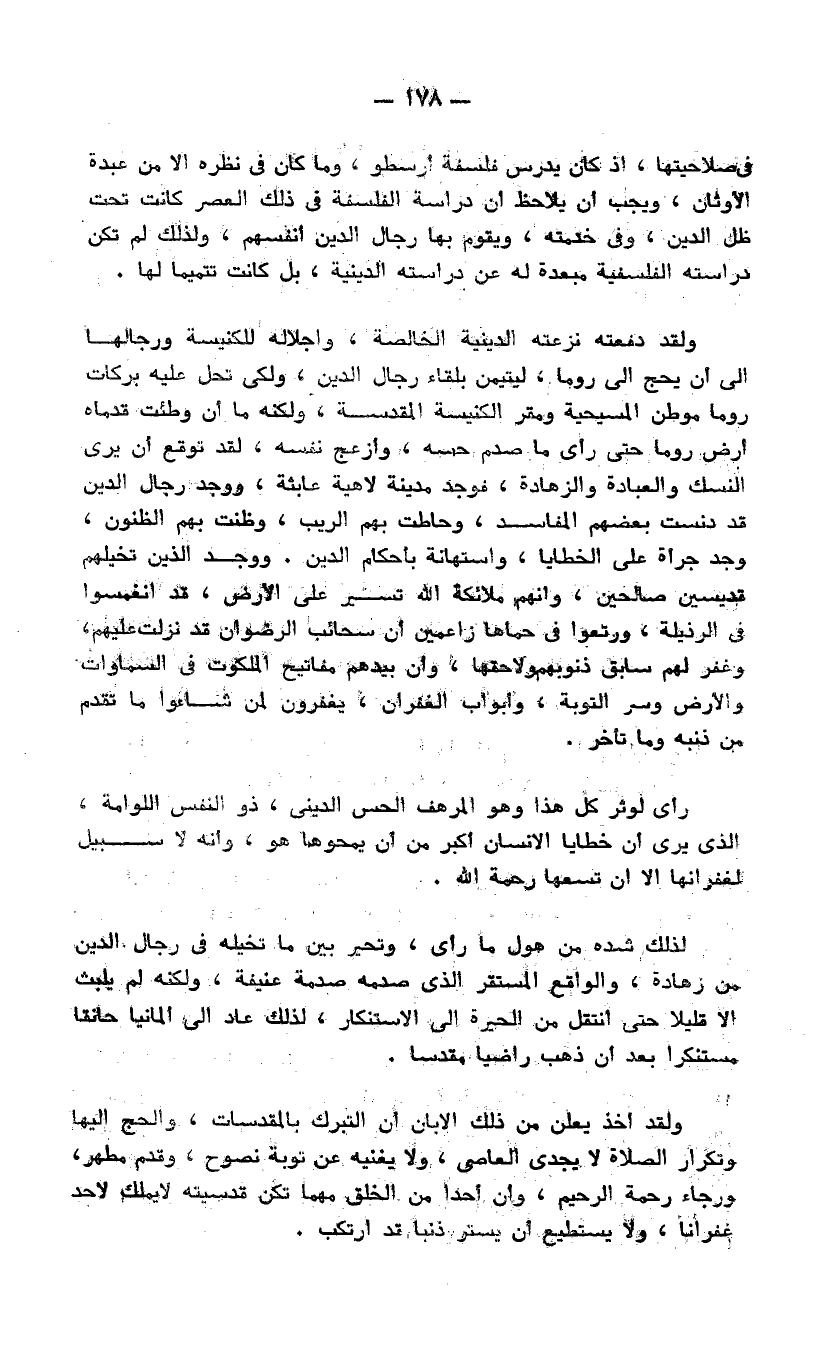
كتاب محاضرات في النصرانية
في صلاحيتها، إذ كان يدرس فلسفة أرسطو، وما كان في نظره إلا من عبدة الأوثان، ويجب أن يلاحظ أن دراسة الفلسفة في ذلك العصر كانت تحت ظل الدين، وفي خدمته، ويقوم بها رجال الدين أنفسهم، ولذلك لم تكن دراسته الفلسفية مبعدة عن دراسته الدينية، بل كانت تتميماً لها.ولقد دفعته نزعته الدينية الخالصة، وإجلاله للكنيسة ورجالها إلى أن يحج إلى روما، ليتيمن بلقاء رجال الدين، ولكي تحل عليه بركات روما موطن المسيحية ومقر الكنيسة المقدسة، ولكنه ما أن وطنت قدماه أرض روما حتى رأى ما صدم حسه، وأزعج نفسه، لقد توقع أن يرى النسك والعبادة والزهادة، فوجد مدينة لاهية عابثة، ووجد رجال الدين قد دنست بعضهم المفاسد، وحاطت بهم الريب، وظنت بهم الظنون، وجد جرأة على الخطايا، واستهانة بأحكام الدين. ووجد الذين تخيلهم قديسين صالحين، وإنهم ملائكة الله تسير على الأرض، قد انغمسوا في الرذيلة، ورتعوا في حماها زاعمين أن سحائب الرضوان قد نزلت عليهم، وغفر لهم سابق ذنوبهم ولاحقها، وأن بيدهم مفاتيح الملكوت في السماوات والأرض وسر التوبة، وأبواب الغفران، يغفرون لمن شاءوا ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
رأى لوثر كل هذا وه مرهف الحس الديني، ذو النفس اللوامة، الذي يرى أن خطايا الإنسان أكبر من أن يمحوها هو، وإنه لا سبيل لغفرانها ألا أن تسعها رحمة الله.
لذلك شدة من هول ما رأي، وتحير بين ما تخيله في رجال الدين من زهادة، والواقع المستقر الذي صدمه صدمة عنيفة، ولكنه لم يلبث إلا قليلاً حتى أنتقل من الحيرة إلى الاستنكار، لذلك عاد إلى ألمانيا حانقاً مستنكراً بعد أن ذهب راضياً مقدساً.
ولقد أخذ يعلن من ذلك الإبان أن التبرك بالمقدسات، والحج إليها وتكرار الصلاة لا يجدي العاصي، ولا يغنيه عن توبة نصوح، وقدم مطهر، ورجاء رحمة الرحيم، وأن أحداً من الخلق مهما تكن قدسيته لا يملك لأحد غفراناً، ولا يستطيع أن يستر ذنباً قد ارتكب.