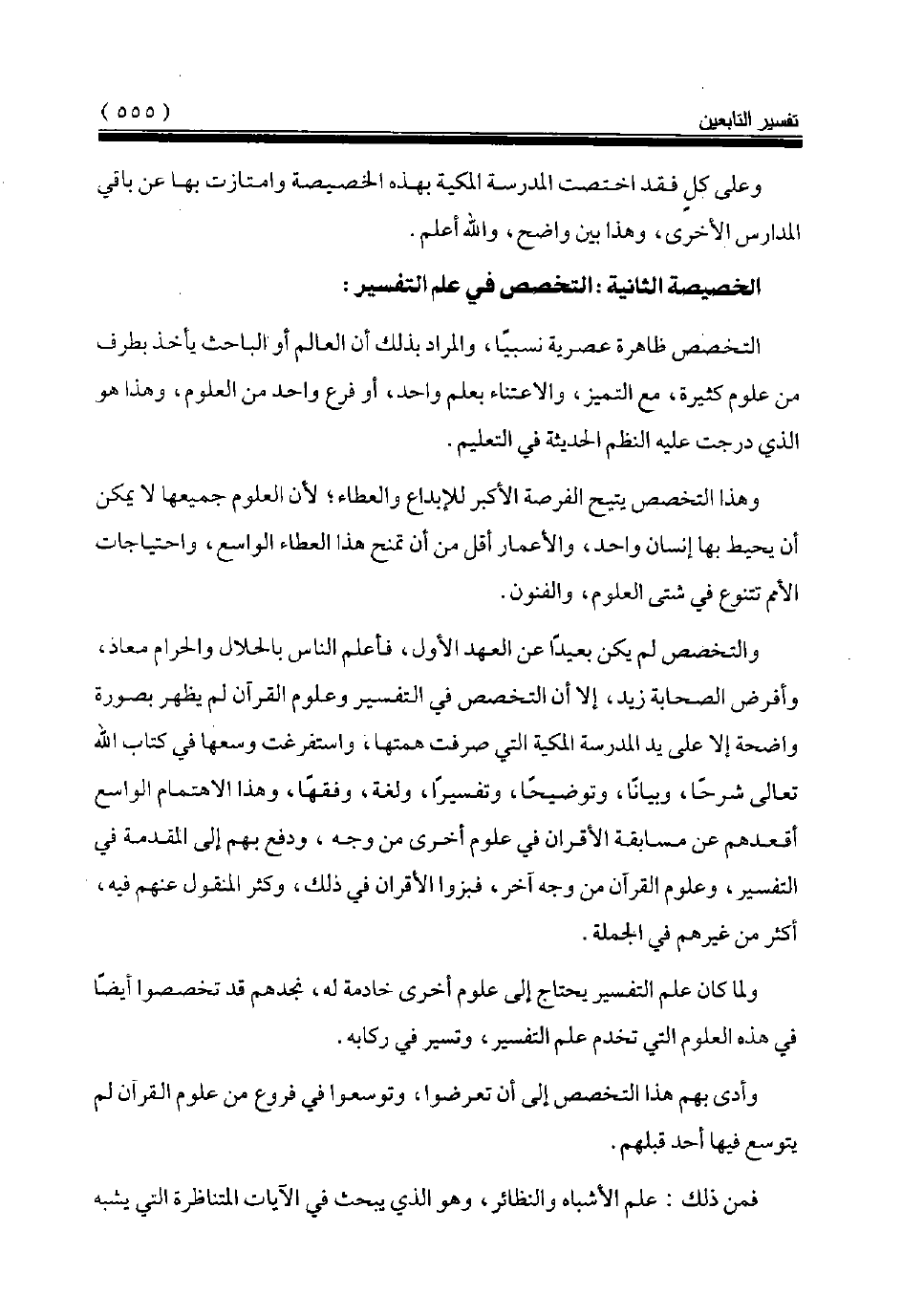
كتاب تفسير التابعين (اسم الجزء: 1)
وعلى كل فقد اختصت المدرسة المكية بهذه الخصيصة وامتازت بها عن باقي المدارس الأخرى، وهذا بين واضح، والله أعلم.الخصيصة الثانية: التخصص في علم التفسير:
التخصص ظاهرة عصرية نسبيا، والمراد بذلك أن العالم أو الباحث يأخذ بطرف من علوم كثيرة، مع التميز، والاعتناء بعلم واحد، أو فرع واحد من العلوم، وهذا هو الذي درجت عليه النظم الحديثة في التعليم.
وهذا التخصص يتيح الفرصة الأكبر للإبداع والعطاء لأن العلوم جميعها لا يمكن أن يحيط بها إنسان واحد، والأعمار أقل من أن تمنح هذا العطاء الواسع، واحتياجات الأمم تتنوع في شتى العلوم، والفنون.
والتخصص لم يكن بعيدا عن العهد الأول، فأعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، وأفرض الصحابة زيد، إلا أن التخصص في التفسير وعلوم القرآن لم يظهر بصورة واضحة إلا على يد المدرسة المكية التي صرفت همتها، واستفرغت وسعها في كتاب الله تعالى شرحا، وبيانا، وتوضيحا، وتفسيرا، ولغة، وفقها، وهذا الاهتمام الواسع أقعدهم عن مسابقة الأقران في علوم أخرى من وجه، ودفع بهم إلى المقدمة في التفسير، وعلوم القرآن من وجه آخر، فبزوا الأقران في ذلك، وكثر المنقول عنهم فيه، أكثر من غيرهم في الجملة.
ولما كان علم التفسير يحتاج إلى علوم أخرى خادمة له، نجدهم قد تخصصوا أيضا في هذه العلوم التي تخدم علم التفسير، وتسير في ركابه.
وأدى بهم هذا التخصص إلى أن تعرضوا، وتوسعوا في فروع من علوم القرآن لم يتوسع فيها أحد قبلهم.
فمن ذلك: علم الأشباه والنظائر، وهو الذي يبحث في الآيات المتناظرة التي يشبه
بعضها بعضا في دلالة الأحكام والبيان، وهذا لا يستغني عنه مفسر، حتى لا يختلف قوله في موضعين من باب واحد.