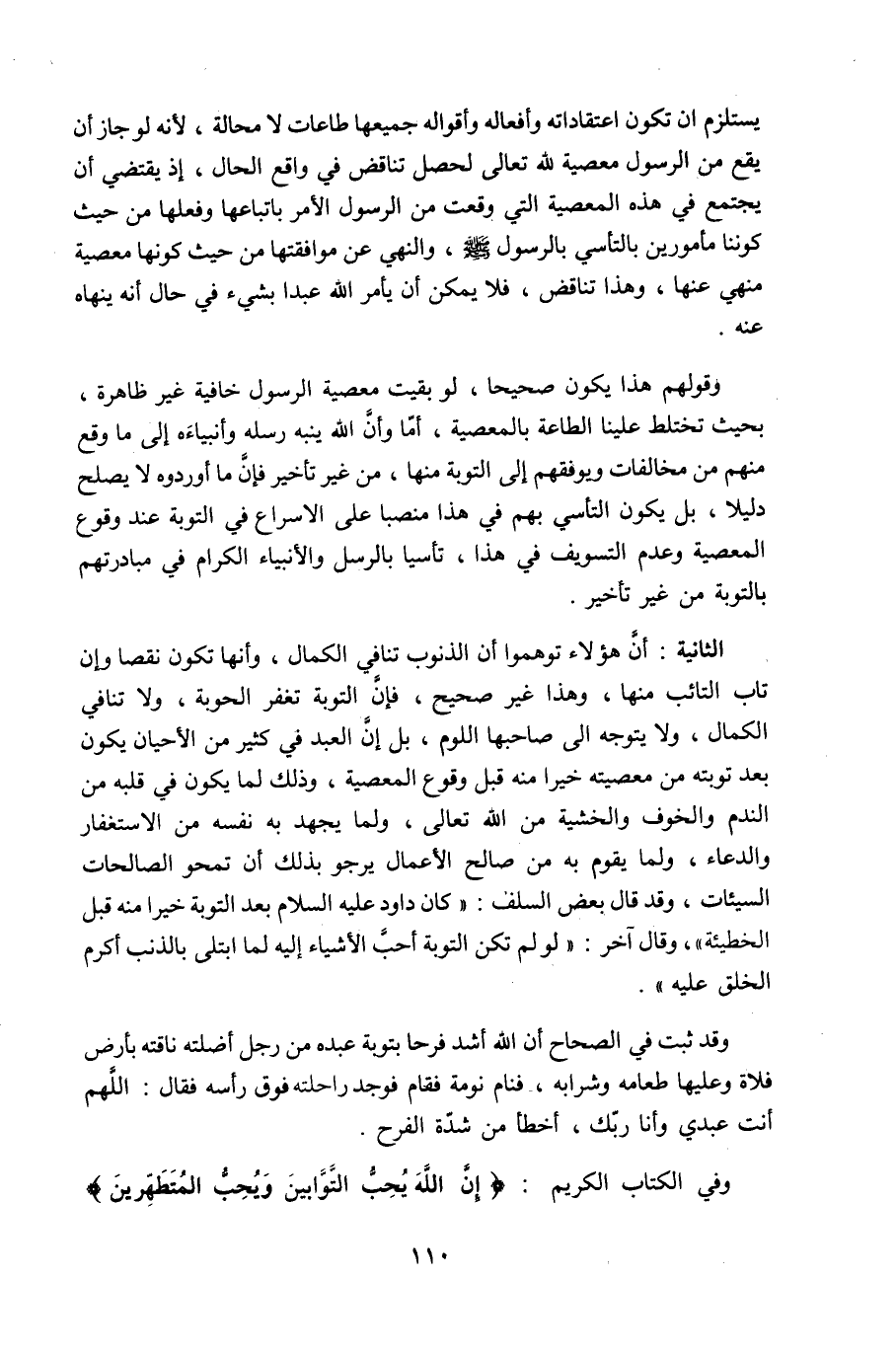
كتاب الرسل والرسالات
يستلزم أن تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة، لأنه لو جاز أن يقع من الرسول معصية لله تعالى لحصل تناقض في واقع الحال، إذ يقتضي أن يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث كوننا مأمورين بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والنهي عن موافقتها من حيث كونها معصية منهي عنها، وهذا تناقض، فلا يمكن أن يأمر الله عبداً بشيء في حال أنه ينهاه عنه.وقولهم هذا يكون صحيحاً، لو بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة، بحيث تختلط علينا الطاعة بالمعصية، أمّا وأنّ الله ينبه رسله وأنبياؤه إلى ما وقع منهم من مخالفات ويوفقهم إلى التوبة منها، من غير تأخير فإنّ ما أوردوه لا يصلح دليلاً بل يكون التأسي بهم في هذا منصباً على الإسراع في التوبة عند وقوع المعصية، وعدم التسويف في هذا، تأسياً بالرسل والأنبياء الكرام في مبادرتهم بالتوبة من غير تأخير.
الثانية: أنّ هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافي الكمال، وأنها تكون نقصاً وإن تاب التائب منها، وهذا غير صحيح، فإنّ التوبة تغفر الحوبة، ولا تنافي الكمال، ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم، بل إنّ العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصيته خيراً منه قبل وقوع المعصية، وذلك لما يكون في قلبه من الندم والخوف والخشية من الله تعالى، ولما يجهد به نفسه من الاستغفار والدعاء، ولما يقوم به من صالح الأعمال، يرجو بذلك أن تمحو الصالحات السيئات، وقد قال بعض السلف: " كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة "، وقال آخر: " لو لم تكن التوبة أحبّ الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه ".
وقد ثبت في الصحاح " أن الله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضلته ناقته بأرض فلاة، وعليها طعامه وشرابه، فنام نومة فقام فوجد راحلته فوق رأسه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح " (7) .
وفي الكتاب الكريم: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)