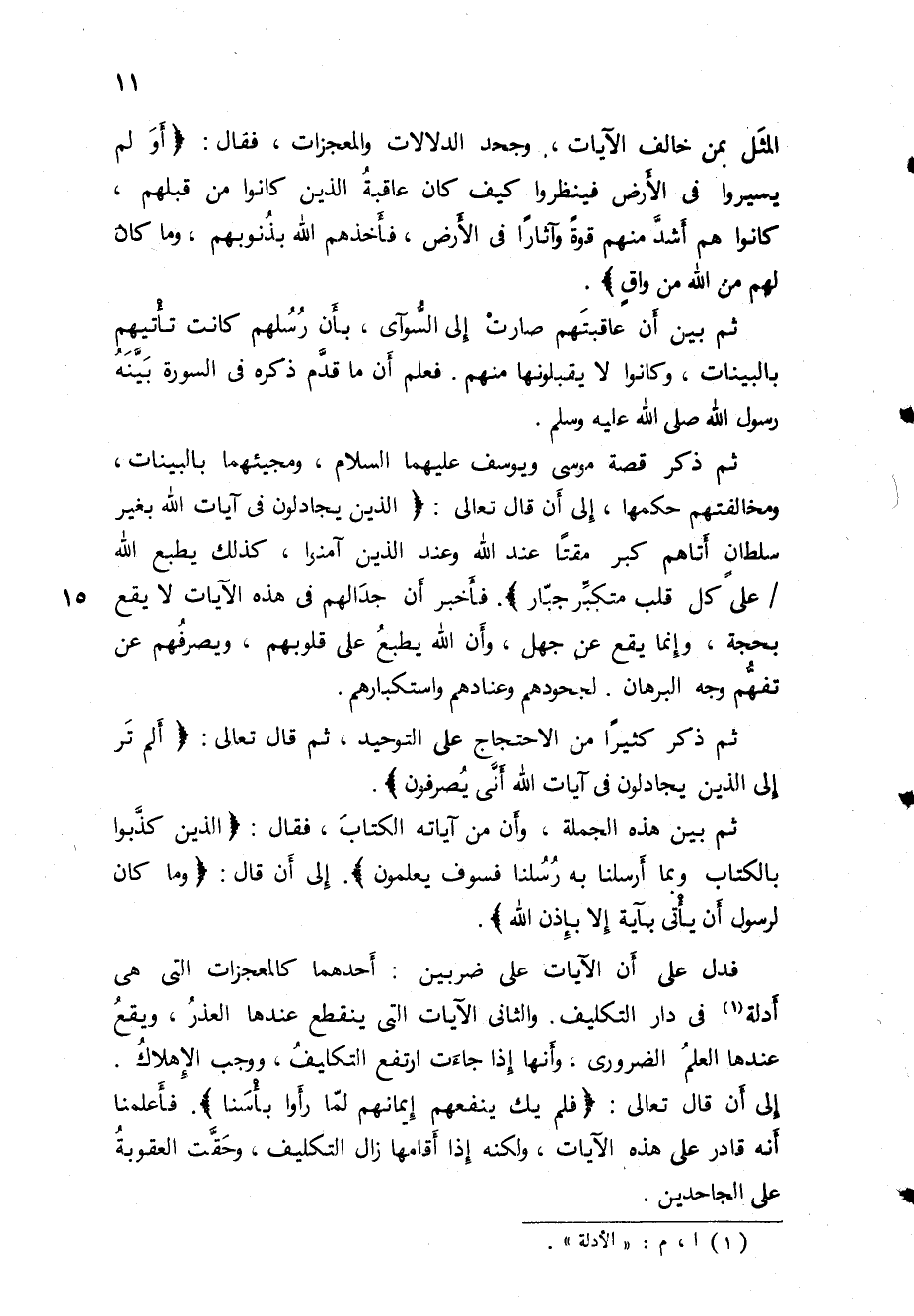
كتاب إعجاز القرآن للباقلاني
والكتاب النفيس الذى أشار التوحيدي إليه، هو كتاب: " الجامع لعلم القرآن " وقد ذكره الرماني في إعجاز القرآن.بدأ الرماني كتابه ببيان وجوه إعجاز القرآن، فقال: إنها تظهر من سبع جهات وهى: ترك المعارضة مع توفر الدواعى وشدة الحاجة، والتحدى للكافة والصرفة، والبلاغة، والاخبار الصادقة عن الامور المستقبلة، ونقض العادة وقياسه بكل معجزة.
ثم قسم البلاغة إلى ثلاث طبقات، وقال: إن ما كان في أعلاها معجز، وهو بلاغة القرآن.
ثم عرف البلاغة بأنها إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، وأعلاها طبقة في الحسن بلاغة القرآن.
ثم قسم البلاغة إلى عشرة أقسام، وهى: الإيجاز، والتشبيه، والاستعارة، والتلاؤم، والفواصل والتجانس والتصريف، والتضمين، والمبالغة، وحسن البيان.
ثم فسرها بابا بابا، على ترتيبها تفسيرا وافيا شافيا.
فهو - مثلا - عند ما عرض
لباب الاستعارة عرفها، وفرق بينها وبين التشبيه.
ثم بين أركانها، وقال: إن كل استعارة حسنة توجب بلاغة بيان لا تنوب منابة الحقيقة، وذلك أنه لو كان يقوم مقامه كانت الحقيقة أولى به، ولم تجز الاستعارة.
ثم ذكر ما جاء في القرآن من الاستعارة على جهة البلاغة، وبدأ بقول الله تعالى: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فجعلناه هباء منثورا) ، فقال: " حقيقة،، قدمنا،، هنا: عمدنا و " قدمنا " أبلغ منه لانه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفر، لانه من أجل إمهاله لهم كمعاملة الغائب عنهم، ثم قدم فرآهم على خلاف ما أمرهم.
وفى هذا تحذير من الاغترار بالامهال.
والمعنى الذى يجمعهما العدل، لان العمد إلى إبطال الفاسد عدل، والقدوم أبلغ لما بينا " وجملة الآيات التى ذكرها في هذا الباب على ذلك النحو العظيم - أربع وأربعون آية.
وبعد أن فرغ الرماني من تفسير أبواب البلاغة العشر، عاد إلى البيان عن الوجوه السبعة التى ذكرها في أول الكتاب، وقال: إنها مظاهر إعجاز القرآن.
المثل بمن خالف الآيات، وجحد الدلالات والمعجزات، فقال: (أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةُ الَّذينَ كَانُواْ مِنْ قَبْلهِمْ، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الارض، فأخذهم الله بذنوبهم، وما كان لهم من الله من واق) .
ثم بين أن عاقبتهم صارت إلى السوأى، بأن رسلهم كانت تأتيهم بالبينات، وكانوا لا يقبلونها منهم.
فعلم أن ما قدم ذكره في السورة بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر قصة موسى ويوسف عليهما السلام، ومجيئهما بالبينات، ومخالفتهم حكمها، إلى أن قال تعالى: (الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْر سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللهِ وَعِندَ الَّذينَ آمنُواْ، كَذَلِكَ يَطْبَعَ اللهُ / عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارِ) .
فأخبر أن جدالهم في هذه الآيات لا يقع بحجة، وإنما يقع عن جهل، وإن الله يطبع على قلوبهم، ويصرفهم عن تفهم وجه البرهان.
لجحودهم وعنادهم واستكبارهم.
ثم ذكر كثيراَ من الاحتجاج على التوحيد، ثم قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إلى الَّذينَ يُجَادِلُونَ في آياتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ) .
ثم بين هذه الجملة، وإن من آياته الكتاب، فقال: (الَّذِينَ كَذَّبَوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) .
إلى أن قال: (وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يأتي بآية إلا بإذن الله) .
فدل على أن الآيات على ضربين: أحدهما كالمعجزات التي هي أدلة (1) في دار التكليف، والثاني الآيات التي ينقطع عندها العذر، ويقع عندها العلم الضروري، وإنها إذا جاءت ارتفع التكليف، ووجب الاهلاك.
إلى أن قال تعالى: (فلم يك ينفعهم إيمانهم لَمَّا رَأَوْا بَأسَنَا) .
فأعلمنا أنه قادر على هذه الآيات، ولكنه إذا أقامها زال التكليف، وحقت العقوبة على الجاحدين.
__________
(1) ا، م: " الادلة ".
(*)