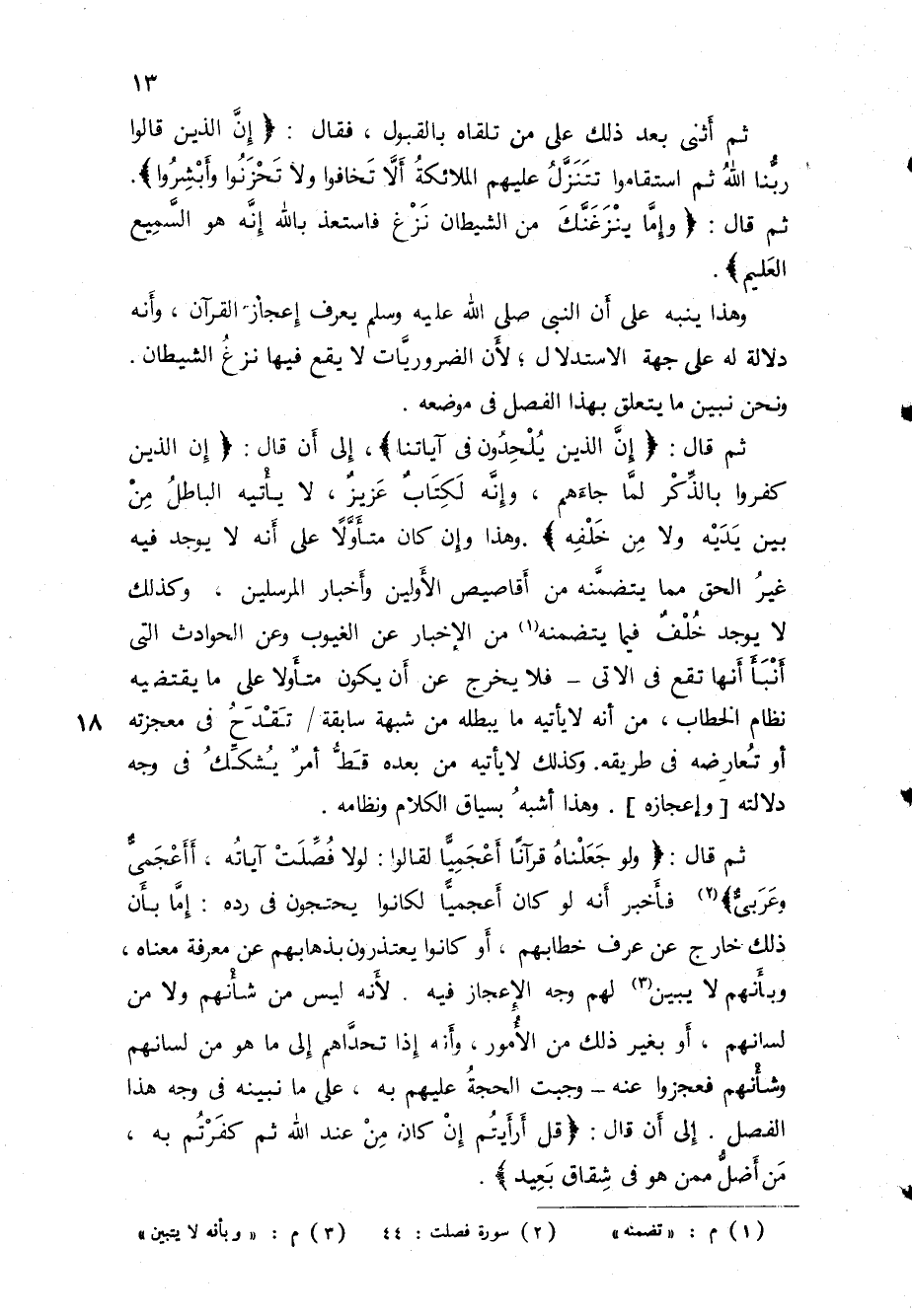
كتاب إعجاز القرآن للباقلاني
بغزارة المادة، وعمق الفكرة، ودقة الاستنباط وروعة البيان، وظهرت فيها شخصيتهم واضحة المعالم، بينة القسمات.ومن كتب الخطابى الجليلة: كتاب " غريب الحديث " و " معالم السنن في شرح سنن أبى داود " و " أعلام السنن في شرح البخاري " وإعجاز القرآن " وهو أصغرها حجما.
بدأ الخطابى كتابه بقوله: " قد أكثر الناس الكلام في هذا الباب قديما
وحديثا، وذهبوا فيه كل مذهب من القول، وما وجدناهم - بعد - صدروا عن رى، وذلك لتعذر معرفة وجه الاعجاز في القرآن، ومعرفة الامر في الوقوف على كيفيته " ثم عرض للاقوال التى قيلت قبله في وجوه الاعجاز، وبدأ برأى القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم، قد تحدى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عنه، وانقطعوا دونه.
وعقب عليه بقوله: " وهذا - من وجوه ما قيل فيه - أبينها دلالة، وأيسرها مؤونة، وهو مقنع لمن لم تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الاعجاز فيه.
ثم ثنى برأى القائلين بأن العلة في إعجازه " الصرفة " أي صرف الهمم عن المعارضة، وإن كانت مقدورا عليها، غير معجوز عنها، إلا أن العائق من حيث كان أمرا خارجا عن مجارى العادات - صار كسائر المعجزات.
وعلق عليه بقوله: " وهذا أيضا وجه قريب، إلا أن دلالة الآية تشهد بخلافه، وهى قوله سبحانه: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) .
فأشار في ذلك إلى أمر طريقه التكلف والاجتهاد، وسبيله التأهب والاحتشاد، والمعنى في الصرفة التى وصفوها لا يلائم هذه الصفة فدل على أن المراد غيرها " ثم ذكر رأى الطائفة التى زعمت أن إعجازه إنما هو فيما تضمنه من الاخبار عن الكوائن في مستقبل الزمان، وصدقت أقوالها مواقع أكوانها.
ثم نقده بقوله: " ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره، نوع من أنواع إعجازه، ولكنه ليس بالامر العام الموجود في كل سورة من سور القرآن.
وقد جعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها، لا يقدر أحد من الخلق أن يأتي بمثلها،
ثم أثنى بعد ذلك على من تلقاه بالقبول، فقال: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُ الملائِكَةُ ألاَّ تَخَافُوا ولا تَحْزَنُوا وَأَبشِروا) .
ثم قال: (وَإمَّا ينزغنك من الشيطان نزع فاستعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَليمُ) .
وهذا ينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إعجاز القرآن، وأنه دلالة له على جهة الاستدلال، لأن الضروريات لا يقع فيها نزع الشيطان.
ونحن نبين ما يتعلق بهذا الفصل في موضعه.
ثم قال: (إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنَا) ، إلى أن قال: (إَنَّ الَّذِينَ كفرا بِالذِّكْرِ لّمَّا جَاءَهُمْ، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، لاَّ يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفِهِ) .
وهذا وإن كان متأولاً على أنه لا يوجد فيه غير الحق مما يتضمنه من أقاصيص الأولين وأخبار المرسلين، وكذلك لا يوجد خلف فيما يتضمنه (1) من الأخبار عن الغيوب وعن الحوادث التي أنبأ أنها تقع في الاتى - فلا يخرج عن أن يكون متأولاً على ما يقتضيه نظام الخطاب، مع أنه لا يأتيه ما يبطله من شبهة سابقة / تقدح في معجزته أو تعارضه في طريقه.
وكذلك لا يأتيه من بعده قط أمر يشكك في وجه دلالته [وإعجازه] .
وهذا أشبه بسياق الكلام ونظامه.
ثم قال: (وَلَوْ جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا: لولا فصلت آياته، أأَعْجمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ) (2) فأخبر أنه لو كان أعجمياً لكانوا يحتجون في رده: إما بأن ذلك خارج عن عرف خطابهم، أو كانوا يعتذرون بذهابهم عن معرفة معناه وبأنهم لا يبين (3) لهم وجه الإعجاز فيه.
لأنه ليس من شأنهم ولا من لسانهم، أو بغير ذلك من الأمور، وأنه إذا تحداهم إلى ما هو من لسانهم وشأنهم فعجزوا عنه - وجبت الحجة عليهم به، على ما نبينه في وجه هذا الفصل.
إلى أن قال: (قُلْ أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد) .
__________
(1) م: " تضمنه " (2) سورة فصلت: 44 (3) م، " وبأنه لا يتبين " (*)