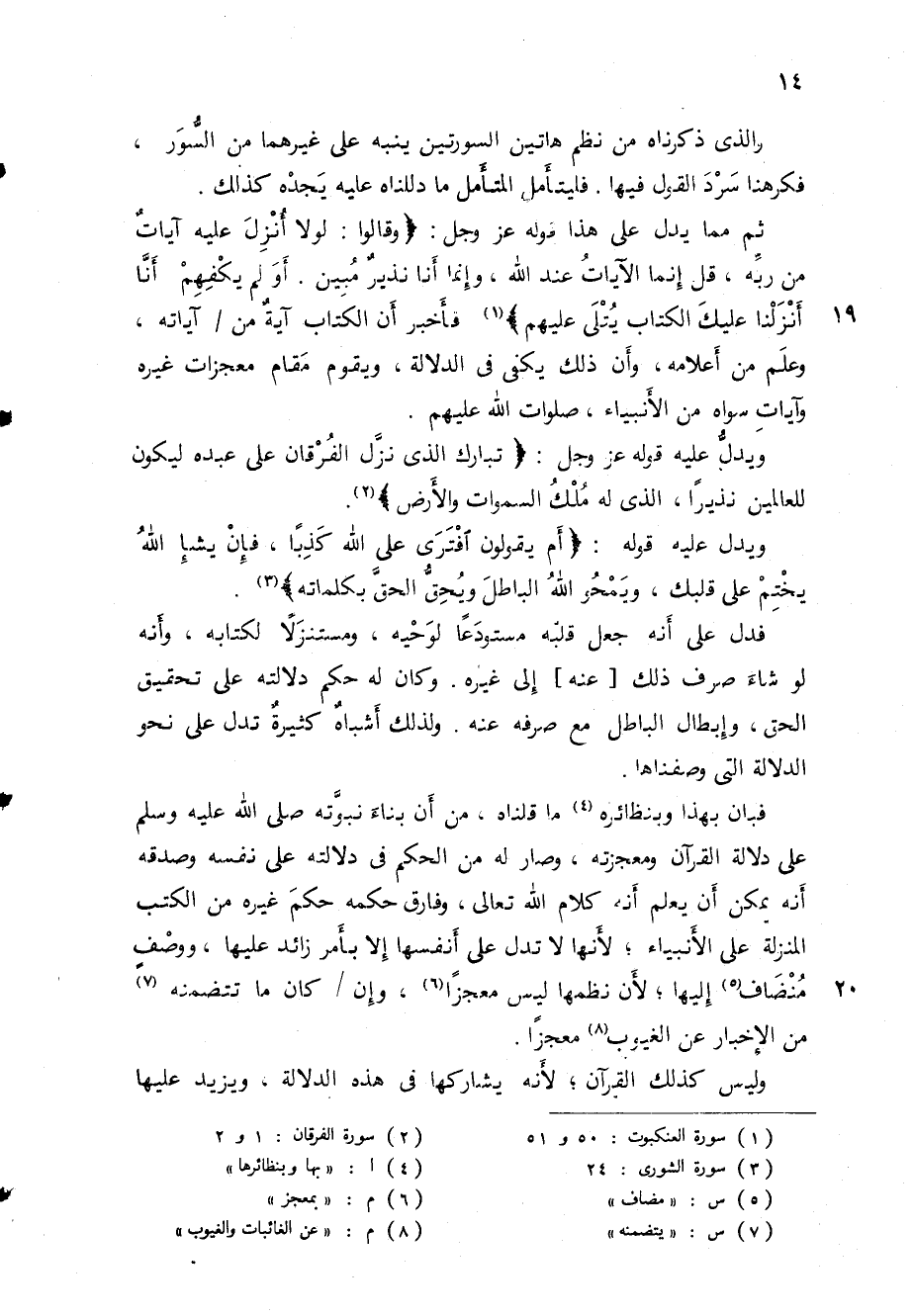
كتاب إعجاز القرآن للباقلاني
فقال: (فَأتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ، وَادْعُواْ شَهدَاءَكُمِ مِنْ دون الله إن كنتم صادقين) من غير تعيين.فدل على أن المعنى فيه غير ما ذهبوا إليه " ثم ذكر الرأى الرابع الذى ذهب إليه الاكثرون من علماء أهل النظر، وهو أن إعجازه من جهة " البلاغة " وقال: " ووجدت عامة أهل هذه المقالة، قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من التقليد، وضرب من غلبة الظن، دون التحقيق له، وإحاطة العلم به.
ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التى اختص بها القرآن، وعن المعنى الذى يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة - قالوا: لا يمكننا تصويره، ولا تحديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة القرآن غيره من الكلام: وإنما يعرفه العالمون به عند سماعه ضربا من المعرفة، لا يمكن تحديده.
وأحالوا على سائر أجناس الكلام الذى يقع فيه التفاضل، فتقع في نفوس العلماء به - عند سماعه - معرفة ذلك، ويتميز في أفهامهم قبيل الفاضل من المفضول منه.
وقد يخفى سببه عند البحث، ويظهر أثره في النفس، حتى لا يلتبس على ذوى العلم والمعرفة به.
وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في السمع، وهشاشة في النفس، لا يوجد مثلها لغيره، والكلامان معا فصيحان، ثم لا يوقف لشئ من ذلك على علة " ثم عقب الخطابى على ذلك بقوله: " وهذا لا يقنع في مثل هذا العلم، ولا يشفى من داء الجهل به، وإنما هو إشكال أحيل به على إبهام " ثم ذكر أن دقيق النظر، وشاهد العبر، قد دلاه على ما يباين به القرآن سائر الكلام، وأن العلة في ذلك: " أن أجناس الكلام مختلفة، ومراتبها في نسبة التبيان متفاوتة، ودرجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية.
فمنها البليغ الرصين الجزل، ومنها الفصيح القريب السهل، ومنها الجائز المطلق الرسل.
وهذه أقسام الكلام الفاضل.
فالقسم الاول أعلى طبقات الكلام وأرفعه، والقسم الثاني أوسطه وأقصده،
والقسم الثالث أدناه وأقربه.
فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الاقسام حصة، وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة، فانتظم لها بامتزاج هذه الاوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة.
وهما على الانفراد في نعوتهما
والذى ذكرناه من نظم هاتين السورتين ينبه على غيرهما من السور، فكر هنا سرد القول فيها.
فليتأمل المتأمل ما دللناه عليه يجده كذلك.
ثم مما يدل على هذا قوله عز وجل: (وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين.
أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) (1) فأخبر أن الكتاب آية من / آياته، وعلم من أعلامه، وإن ذلك يكفي في الدلالة، ويقوم مقام معجزات غيره وآيات سواه من الأنبياء، صلوات الله عليهم.
ويدل عليه قوله عز وجل: (تبارك الذي نزل الفرقان عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً، الَّذِي لَهُ ملك السموات والارض) (2) .
ويدل عليه قوله: (أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشإ الله يختم على قلبك، ويمحوا الله الباطل ويحق الحق بكلماته) (3) .
فدل على أنه جعل قلبه مستودعاً لوحيه، ومستنزلاً لكتابه، وأنه لو شاء صرف ذلك [عنه} إلى غيره.
وكان له حكم دلالته على تحقيق الحق، وإبطال الباطل مع صرفه عنه.
ولذلك أشباه كثيرة تدل على نحو الدلالة التي وصفناها.
فبان بهذا وبنظائره (4) ما قلناه، من أن بناء نبوته صلى الله عليه وسلم على دلالة القرآن ومعجزته، وصار له من الحكم في دلالته على نفسه وصدقه أنه يمكن أن يعلم أنه كلام الله تعالى، وفارق حكمه حكم غيره من الكتب المنزلة على الأنبياء، لأنها لا تدل على أنفسها إلا بأمر زائد عليها، ووصف منضاف (5) إليها، لأن نظمها ليس معجزاً (6) ، وإن / كان ما تتضمنه (7) من الأخبار عن الغيوب (8) معجزاً.
وليس كذلك القرآن، لأنه يشاركها في هذه الدلالة، ويزيد عليها
__________
(1) سورة العنكبوت: 50 و 51 (2) سورة الفرقان: 1 و 2 (3) سورة الشورى: 24 (4) ا: " بها وبنظائرها " (5) س: " مضاف " (6) م: " معجز " (7) س: " يتضمنه " (8) م: " عن الغائبات والغيوب " (*)