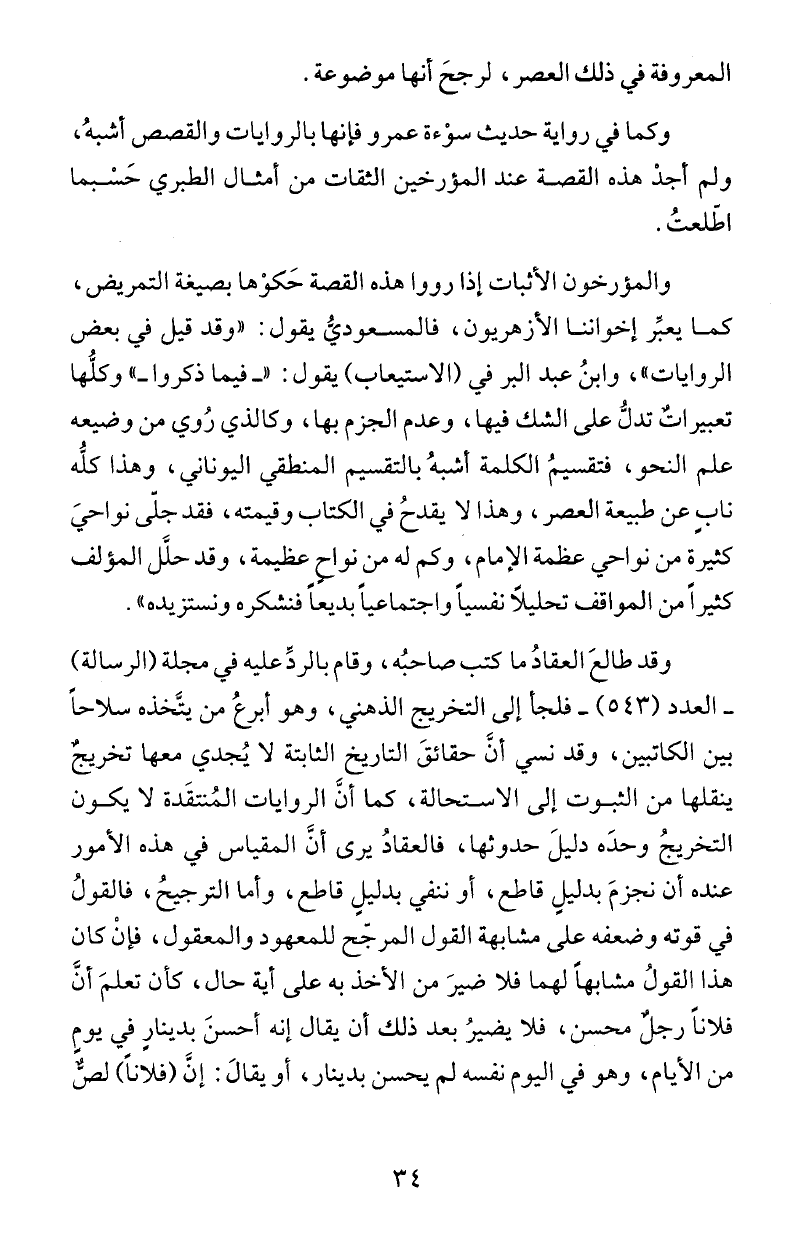
كتاب أحمد أمين مؤرخ الفكر الإسلامي
المعروفة في ذلك العصر، لرجحَ أنها موضوعة.وكما في رواية حديث سوْءة عمرو فإنها بالروايات والقصص اشبهُ،
ولم أجدْ هذه القصة عند المؤرخين الثقات من أمثال الطبري حَسْبما
اطلعتُ.
والمؤرخون الاثبات إذا رووا هذه القصة حَكوْها بصيغة التمريض،
كما يعتر إخواننا الارهريون، فالمسعودقيُ يقول: " وقد قيل في بعض
الروايات "، وابنُ عبد البر في (الاستيعاب) يقول: "- فيما ذكروا -" وكقُها
تعبيراتٌ تدلّ على الشك فيها، وعدم الجزم بها، وكالذي رُوي من وضيعه
علم النحو، فتقسيمُ الكلمة أشبهُ بالتقسيم المنطقي اليوناني، وهذا كفُه
نابٍ عن طبيعة العصر، وهذا لا يقدحُ في الكتاب وقيمته، فقد جلّى نواحيَ
كثيرة من نواحي عظمة الإمام، وكم له من نواح عظيمة، وقد حقَل المؤلف
كثيراً من المواقف تحليلاً نفسياً واجتماعياً بديعاً فنشكره ونستزيده ".
وقد طالعَ العقادُ ما كتب صاحئه، وقام بالردَ عليه في مجلة (الرسالة)
- العدد (543) - فلجأ إلى التخريج الذهني، وهو أبرعُ من يتَخذه سلاحاً
بين الكاتبين، وقد نسي أن حقائقَ التاريخ الثابتة لا يُجدي معها تخريجٌ
ينقلها من الثبوت إلى الاستحالة، كما أن الروايات المُنتقَدة لا يكون
التخريجُ وحدَه دليلَ حدوثها، فالعقادُ يرى أن المقياس في هذه الامور
عنده ان نجزمَ بدليلٍ قاطع، أو ننفي بدليلٍ قاطع، وأما الترجيح، فالقولُ
في قوته وضعفه على مشابهة القول المرجّح للمعهود والمعقول، فإنْ كان
هذا القولُ مشابهاً لهما فلا ضيرَ من الأخذ به على أية حال، كأن تعلمَ ا ن
فلاناً رجلٌ محسن، فلا يضيرُ بعد ذلك أن يقال إنه أحسنَ بدينارٍ في يومٍ
من الأيام، وهو في اليوم نفسه لم يحسن بدينار، أو يقالَ: إن (فلاناً) لصن
34