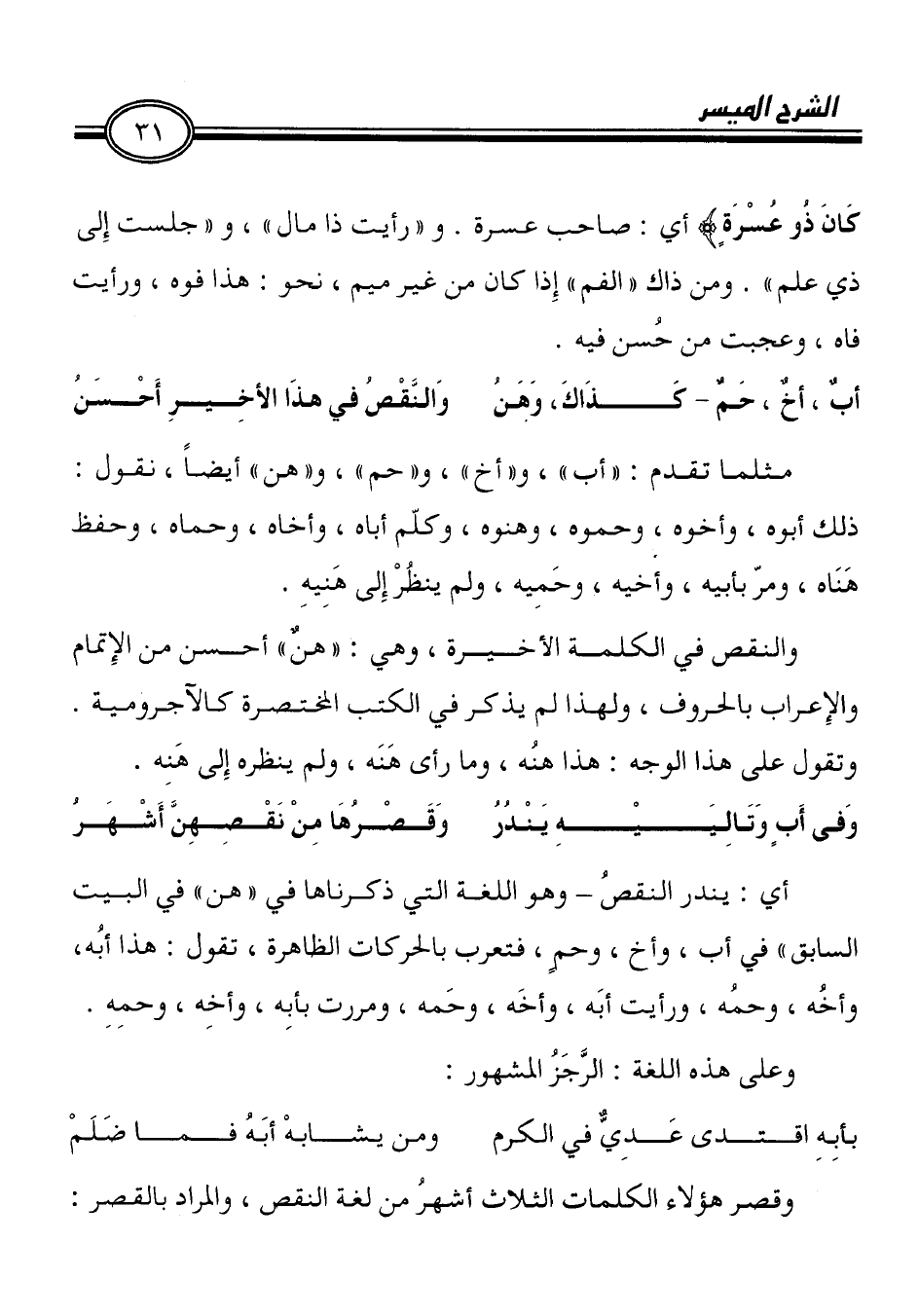
كتاب الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرف
كَطنَ ذُو عُسْرَةٍ! أي: صاحب عسرة. و " رأيت ذا مال "، و " جل! ست إِلىذي علم ". ومن ذاك " الفم " إِذا كان من غير ميم، نحو: هذا فوه، ورا يت
فاه، وعجبت من حُسن فيه.
أبٌ، أخٌ، حَمٌ - كَذَاكَ، وَهَنُ وَالنَّقْصُ في هذَا الأخِيرِ أَحْسَنُ
مثلما تقدم: " أب "، و" أخ "، و" حم "، و" هن " أ يضاً، نقول:
ذلك أبوه، وأخوه، وحموه، وهنوه، وكلّم أباه، وأخاه، وحماه، وحفظ
هَنَاه، ومرّ بأبيه، وأخيه، وحَمِيه، ولم ينطُرْ إِلى هَنِيهِ.
والنقص في الكلمة الأ خيرة، وهي: " هنٌ " أحسن من الإِتمام
والإِعراب بالحروف، ولهذا لم يذكر في الكتب الختصرة كالاَجرومية.
وتقول على هذا الوجه: هذا هنُه، وما رأى هَنَه، ولم ينطره إِلى هَنِه.
وَفى أَبٍ وَتَالِيَيْهِ يَنْدُرُ وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ
أي: يندر النقصُ - وهو اللغة التي ذكرناها في " هن)) في البيت
السابق " في أب، وأخ، وحيِ، فتعرب بالحركات الظاهرة، تقول: هذا أبُه،
وأخُه، وحمُه، ورأ يت أبَه، وأخَه، وحَمه، ومررت بأبِه، وأخِه، وحمِهِ.
وعلى هذه اللغة: الرَّجَزُ المشهور:
بائهِ اقتدى عَدِيّ في الكرم ومن يشابهْ أبَهُ فما ضَلَمْ
وقصر هؤلاء الكلمات الثلاث أشهرُ من لغة النقص، والمراد بالقصر: