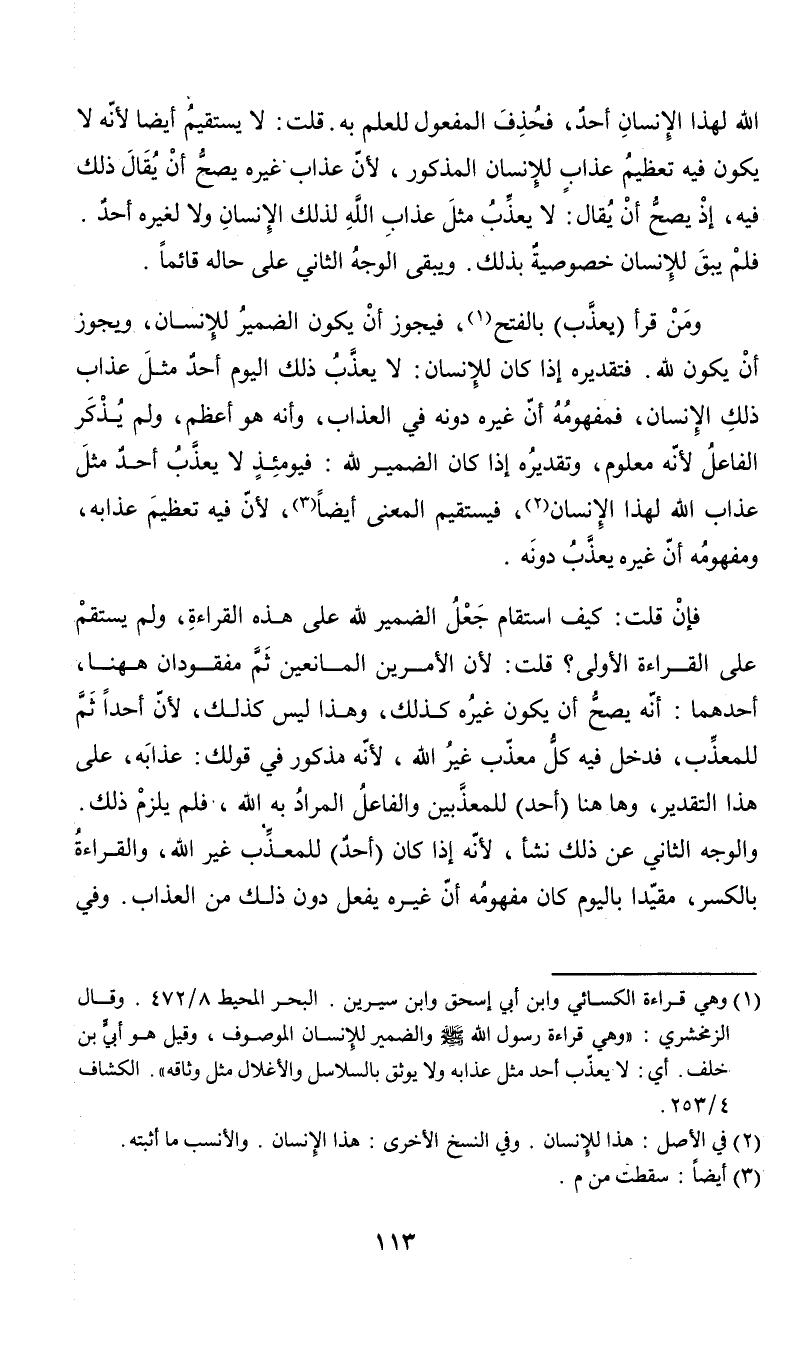
كتاب أمالي ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)
الله لهذا الإنسان أحدٌ، فحُذِفَ المفعول للعلم به. قلت: لا يستقيمُ أيضا لأنه لا يكون فيه تعظيمُ عذاب للإنسان المذكور، لأن عذاب غيره يصح أن يقال ذلك فيه، إذ يصح أن يقال: لا يعذب مثل عذاب الله لذلك الإنسان ولا لغيره أحد. فلم يبق للإنسان خصوصية بذلك. ويبقى الوجه الثاني على حاله قائماً.ومن قرأ (يعذب) بالفتح (¬1)، فيجوز أن يكون الضمير للإنسن، ويجوز أن يكون لله. فتقديره إذا كان للإنسان: لا يعذب ذلك اليوم أحد مثل عذاب ذلكِ الإنسان، فمهومه أن غيره دونه في العذاب، وأنه هو أعظم، ولم يذكر الفاعل لأنه معلوم، وتقديره إذا كان الضمير لله: فيومئذ لا يعذب أحد مثل عذاب الله لهذا الإنسان (¬2)، فيستقيم المعنى أيضاً (¬3)، لأن فيه تعظيم عذابه، ومفهومه أن غيره يعذب دونه.
فإن قلت: كيف استقام جعل الضمير لله على هذه القراءة، ولم يستقم على القراءة الأولى؟ قلت: لأن الأمرين المانعين ثَمَّ مفقودان ههنا، أحدهما: أنّه يصحُّ أن يكون غيرهُ كذلك، وهذا ليس كذلك، لأنّ أحداً ثَمَّ للمعذَّب، فدخل فيه كل معذب غير الله، لأنه مذكور في قولك: عذابه، على هذا التقدير، وها هنا (أحد) للمعذبين والفاعل المراد به الله، فلم يلزم ذلك. والوجه الثاني عن ذلك نشأ، لأنه إذا كان (أحد) للمعذب غير الله، والقراءة بالكسر، مقيّدا باليوم كان مفهومه أن غيره يفعل دون ذلك من العذاب. وفي
¬__________
(¬1) وهي قراءة الكسائي وابن أبي إسحق وابن سيرين. البحر المحيط 8/ 472. وقال الزمخشري: "وهي قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والضمير للإنسان الموصوف، وقيل هو أبي بن خلف. أي: لا يعذب أحد مثل عذابه ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه". الكشاف 4/ 253.
(¬2) في الأصل: هذا للإنسان. وفي النسخ الأخرى: هذا الإنسان. والأنسب ما أثبته.
(¬3) أيضاً: سقطت من م.