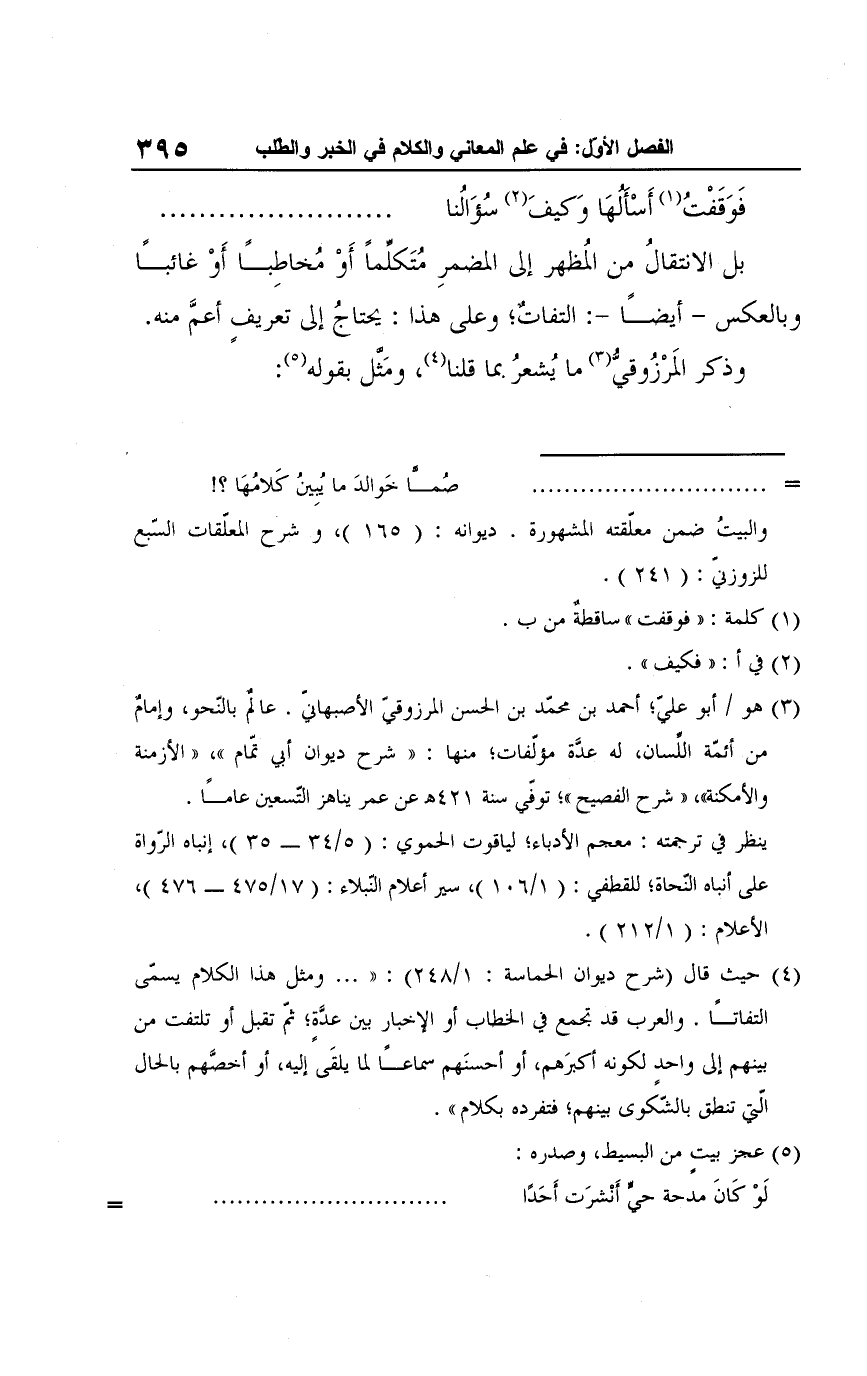
كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
فَوَقَفْتُ (¬1) أَسْأَلُهَا وَكيفَ (¬2) سُؤَالُنا ... ........................بل الانتقالُ من المُظهر إلى المضمرِ مُتَكلِّمًا أَوْ مُخاطِبًا أَوْ غائبًا وبالعكس -أيضًا-: التفاتٌ؛ وعلى هذا: يحتاجُ إلى تعريفٍ أعمَّ منه.
وذكر المَرْزُوقيُّ (¬3) ما يُشعرُ بما قلنا (¬4)، ومَثَّل بقوله (¬5):
¬__________
= ..................... ... صُمًّا خَوالدَ ما يُبِينُ كَلامُهَا؟!
والبيتُ ضمن معلّقته المشهورة. ديوانه: (165)، وشرح المعلّقات السّبع للزوزني: (241).
(¬1) كلمة: "فوقفت" ساقطةٌ من ب.
(¬2) في أ: "فكيف".
(¬3) هو أبو عليّ؛ أحمد بن محمّد بن الحسن المرزوقيّ الأصبهانيّ. عالمٌ بالنّحو، وإمامٌ من أئمّة اللِّسان، له عدَّة مؤلّفات؛ منها: "شرح ديوان أبي تمام"، "الأزمنة والأمكنة"، "شرح الفصيح"؛ توفي سنة 421 هـ عن عمر يناهز التّسعين عامًا.
ينظر في ترجمته: معجم الأدباء؛ لياقوت الحموي: (5/ 34 - 35)، إنباه الرّواة على أنباه النّحاة؛ للقطفي: (1/ 106)، سير أعلام النّبلاء: (17/ 475 - 476)، الأعلام: (1/ 212).
(¬4) حيث قال (شرح ديوان الحماسة: 1/ 248): " ... ومثل هذا الكلام يسمّى التفاتًا. والعرب قد تجمع في الخطاب أو الأخبار بين عدَّةٍ؛ ثمّ تقبل أو تلتفت من بينهم إلى واحدٍ لكونه أكبرَهم، أو أحسنَهم سماعًا لما يلقَى إليه، أو أخصَّهم بالحال الّتي تنطق بالشّكوى بينهم؛ فتفرده بكلام".
(¬5) عجز بيتٍ من البسيط، وصدره:
لَوْ كَانَ مدحة حيٍّ أَنْشرَت أَحَدًا ... ...................... =