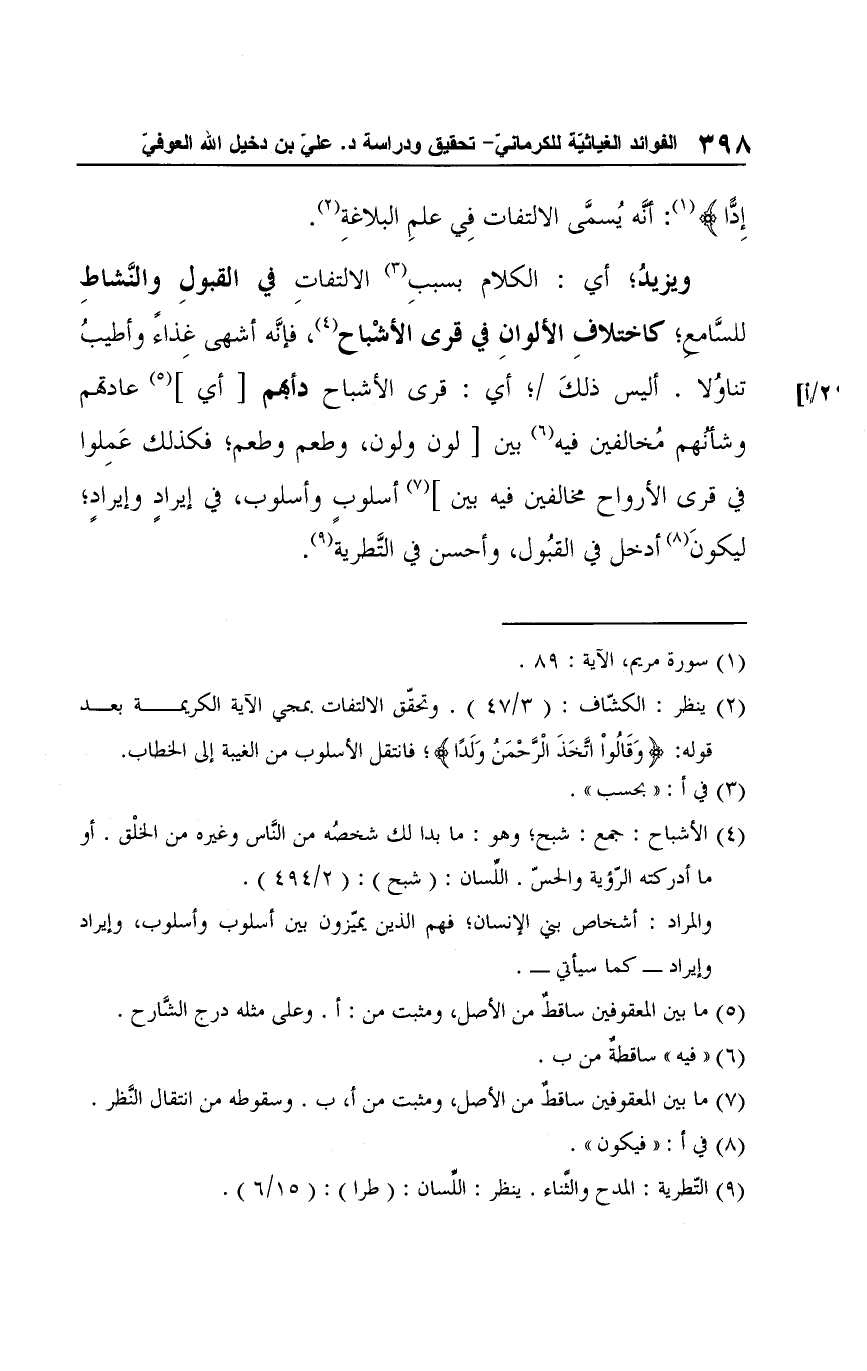
كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
إِدًّا} ـ (¬1): أنَّه يُسمَّى الالتفات في علمِ البلاغةِ (¬2).ويزيدُ، أي: الكلام بسببِ (¬3) الالتفاتِ في القبولِ والنَّشاطِ للسَّامعِ؛ كاختلافِ الألوانِ في قرى الأشْباح (¬4)، فإنَّه أشهى غِذاءً وأطيبُ تناوُلا. أليس ذلكَ؛ أي: قرى الأشباح دأبهم [أي] (¬5) عادتهم وشأنُهم مُخالفين فيه (¬6) بين [لون ولون، وطعم وطعم؛ فكذلك عَمِلوا في قرى الأرواح مخالفين فيه بين] (¬7) أسلوبٍ وأسلوب، في إيرادٍ وإيرادٍ؛ ليكونَ (¬8) أدخل في القبُول، وأحسن في التَّطرية (¬9).
¬__________
(¬1) سورة مريم، الآية: 89.
(¬2) ينظر: الكشّاف: (3/ 47). وتحقّق الالتفات بمجي الآية الكريمة بعد قوله: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا}؛ فانتقل الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب.
(¬3) في أ: "بحسب".
(¬4) الأشباح: جمع: شبح، وهو: ما بدا لك شخصُه من الناس وغيره من الخلْق. أو ما أدركته الرّؤية والحسّ. اللّسان: (شبح): (2/ 494).
والمراد: أشخاص بني الإنسان؛ فهم الذين يميّزون بين أسلوب وأسلوب، وإيراد وإيراد -كما سيأتي-.
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من: أ. وعلى مثله درج الشَّارح.
(¬6) "فيه" ساقطةٌ من ب.
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ب. وسقوطه من انتقال النَّظر.
(¬8) في أ: "فيكون".
(¬9) التّطرية: المدح والثَّناء. ينظر: اللِّسان: (طرا): (15/ 6).