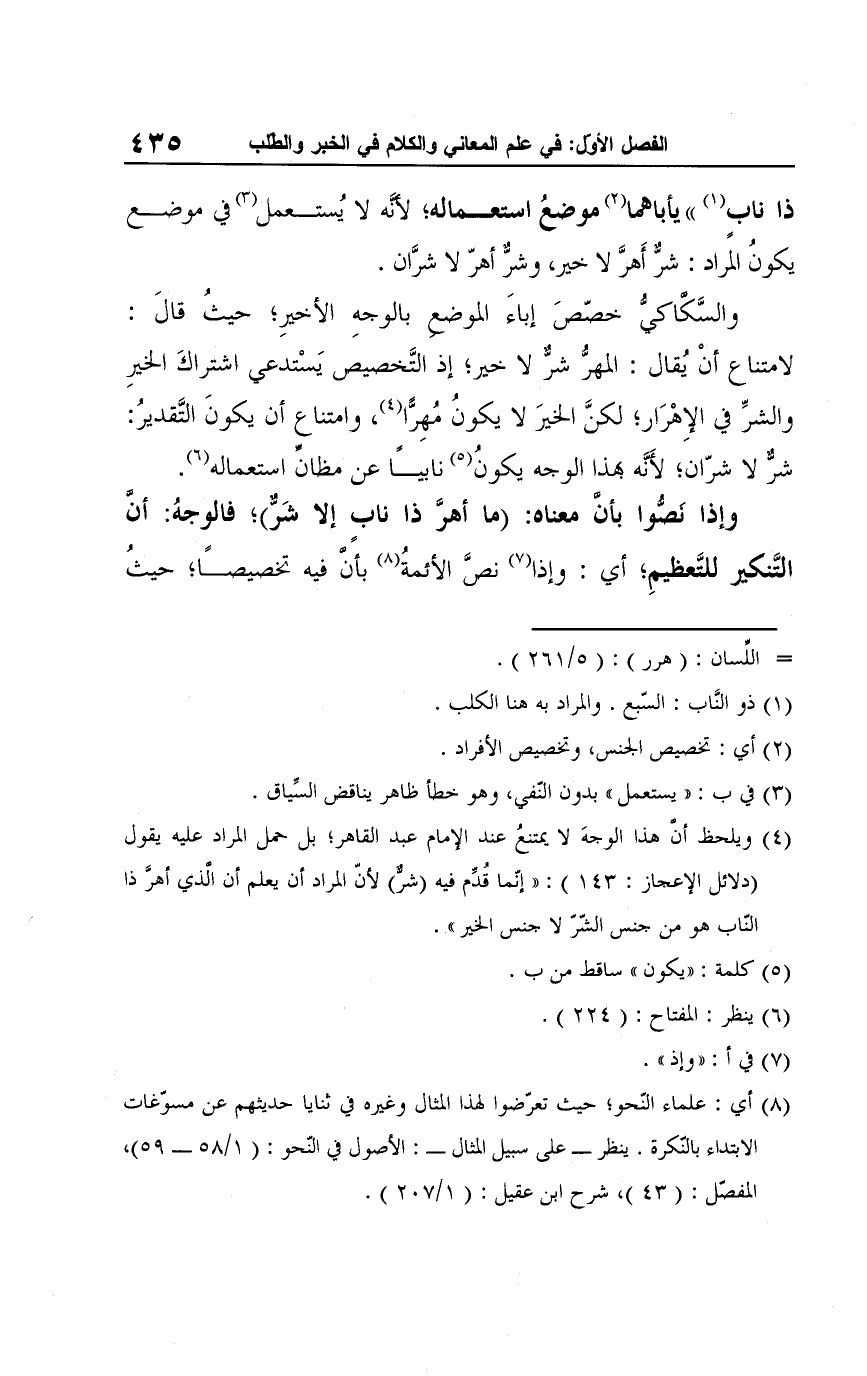
كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
ذا نابٍ (¬1) "يأباهما (¬2) موضعُ استعماله، لأَنَّه لا يُستعمل (¬3) في موضع يكونُ المراد: شرٌّ أَهرَّ لا خير، وشرٌّ أهرّ لا شرَّان.والسَّكَّاكيُّ خصّصَ إباءَ الموضع بالوجهِ الأخيرِ؛ حيثُ قال: لامتناع أنْ يُقال: المهرُّ شرٌّ لا خير؛؛ إذ التَّخصيص يَسْتدعي اشتراكَ الخيرِ والشرِّ في الإِهْرَار، لكنَّ الخيرَ لا يكونُ مُهِرًّا (¬4)، وامتناع أن يكونَ التَّقديرُ: شرٌّ لا شرّان؛ لأنَّه بهذا الوجه يكونُ (¬5) نابيًّا عن مظانِّ استعماله (¬6).
وإذا نَصُّوا بأن معناه: (ما أهرَّ ذا نابٍ إلا شَرٌّ)، فالوجهُ: أنَّ التَّننكر للتَّعظيمِ، أي: وإذا (¬7) نصَّ الأئمةُ (¬8) بأنَّ فيه تخصيصًا؛ حيثُ
¬__________
= اللِّسان: (هرر): (5/ 261).
(¬1) ذو النَّاب: السّبع. والمراد به هنا الكلب.
(¬2) أي: تخصيص الجنس، وتخصيص الأفراد.
(¬3) في ب: "يستعمل" بدون النّفي، وهو خطأ ظاهر يناقض السِّياق.
(¬4) ويلحظ أنَّ هذا الوجهَ لا يمتنعُ عند الإمام عبد القاهر؛ بل حمل المراد عليه يقول (دلائل الإعجاز: 143): "إنّما قُدِّم فيه (شرٌّ) لأنّ المراد أن يعلم أن الَّذي أهرَّ ذا النّاب هو من جنس الشّرّ لا جنس الخير".
(¬5) كلمة: "يكون" ساقط من ب.
(¬6) ينظر: المفتاح: (224).
(¬7) في أ: "وإذ".
(¬8) أي: علماء النّحو؛ حيث تعرّضوا لهذا المثال وغيره في ثنايا حديثهم عن مسوّغات الابتداء بالنّكرة. ينظر -على سبيل المثال-: الأصول في النّحو: (1/ 58 - 59)، المفصّل: (43)، شرح ابن عقيل: (1/ 207).