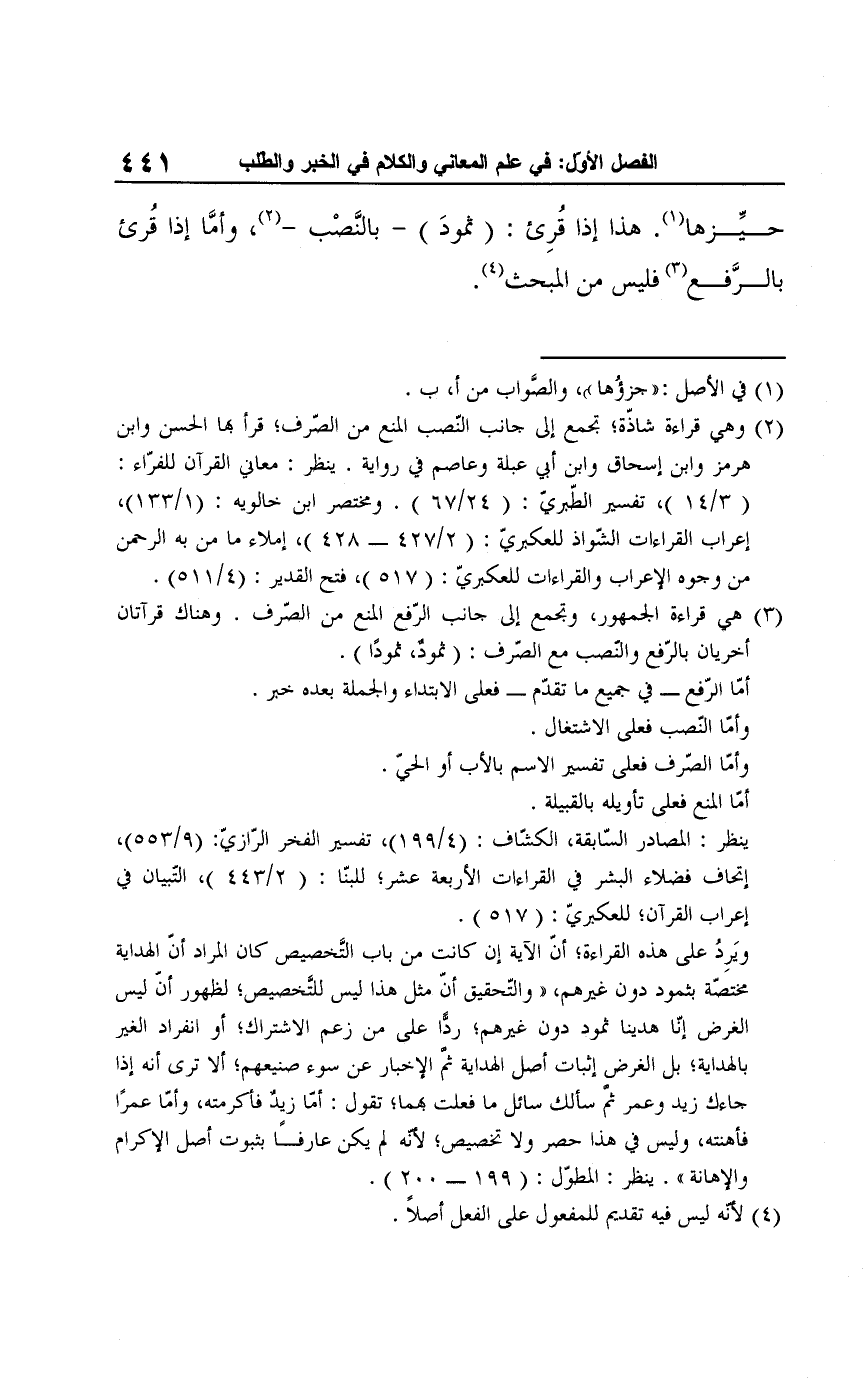
كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
حيِّزها (¬1). هذا إذا قُرِئ: (ثمودَ) -بالنَّصْب- (¬2)، وأمَّا إذا قُرئ بالرَّفع (¬3) فليس من المبحث (¬4).¬__________
(¬1) في الأصل: "جزؤُها"، والصَّواب من أ، ب.
(¬2) وهي قراءة شاذّة؛ تجمع إلى جانب النّصب المنع من الصّرف؛ قرأ بها الحسن وابن هرمز وابن إسحاق وابن أبي عبلة وعاصم في رواية. ينظر: معاني القرآن للفرّاء: (3/ 14)، تفسير الطّبريّ: (24/ 67). ومختصر ابن خالويه: (1/ 133)، إعراب القراءات الشّواذ للعكبريّ: (2/ 427 - 428)، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات للعكبريّ: (517)، فتح القدير: (4/ 511).
(¬3) هي قراءة الجمهور، وتجمع إلى جانب الرّفع المنع من الصّرف. وهناك قرآتان أخريان بالرّفع والنّصب مع الصّرف: (ثمودٌ، ثمودًا).
أمّا الرّفع -في جميع ما تقدّم- فعلى الابتداء والجملة بعده خبر.
وأمّا النّصب فعلى الاشتغال.
وأمّا الصّرف فعلى تفسير الاسم بالأب أو الحيّ.
أمّا المنع فعلى تأويله بالقبيلة.
ينظر: المصادر السّابقة، الكشّاف: (4/ 199)، تفسير الفخر الرّازيّ: (9/ 553)، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر؛ للبنّا: (2/ 443)، التبيان في إعراب القرآن؛ للعكبريّ: (517).
ويَرِدُ على هذه القراءة؛ أن الآية إن كانت من باب التَّخصيص كان المراد أنّ الهداية مختصّة بثمود دون غيرهم، "والتّحقيق أنّ مثل هذا ليس للتَّخصيص؛ لظهور أنّ ليس الغرض إنّا هدينا ثمود دون غيرهم؛ ردًّا على من زعم الاشتراك؛ أو انفراد الغير بالهداية؛ بل الغرض إثبات أصل الهداية ثم الإخبار عن سوء صنيعهم؛ ألا ترى أنه إذا جاءك زيد وعمر ثم سألك سائل ما فعلت بهما؛ تقول: أما زيدٌ فأكرمته، وأمّا عمرًا فأهنته، وليس في هذا حصر ولا تخصيص؛ لأنّه لم يكن عارفًا بثبوت أصل الإكرام والإهانة". ينظر: المطوّل: (199 - 200).
(¬4) لأنّه ليس فيه تقديم للمفعول على الفعل أصلًا.