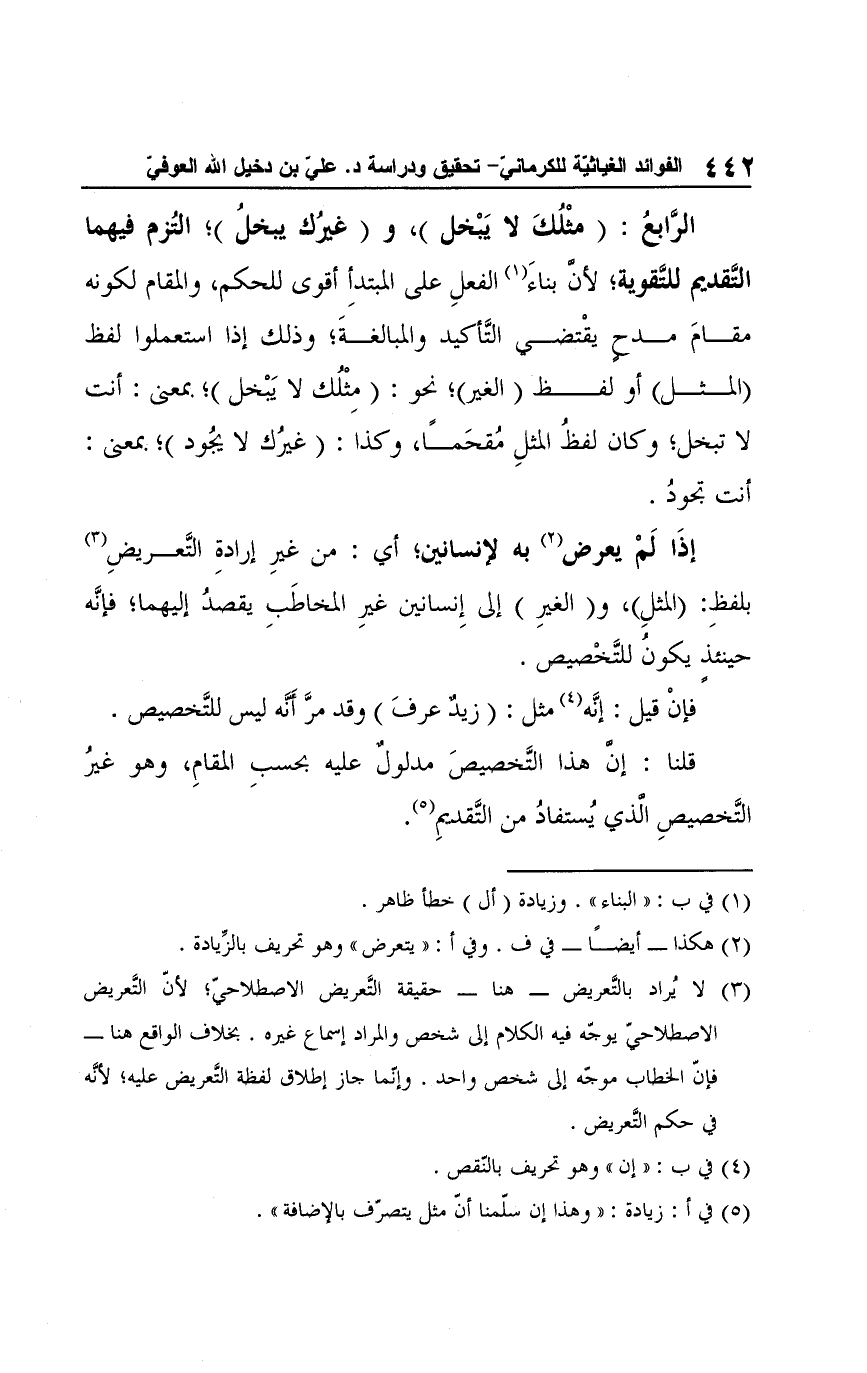
كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
الرَّابعُ: (مثْلُكَ لا يَبْخل)، و (غيرُك يبخلُ)؛ التُزم فيهما التَّقديم للتَّقوية؛ لأنَّ بناءَ (¬1) الفعلِ على المبتدأ أقوى للحكم، والمقام لكونه مقامَ مدحٍ يقْتضي التَّأكيد والمبالغةَ؛ وذلك إذا استعملوا لفظ (المثل) أو لفظ (الغير)؛ نحو: (مِثْلُك لا يَبْخل)؛ بمعنى: أنت لا تبخل؛ وكان لفظُ المثلِ مُقحَمًا، وكذا: (غيرُك لا يجُود)؛ بمعنى: أنت تجودُ.إذَا لَمْ يعرض (¬2) به لإنسانين؛ أي: من غيرِ إرادةِ التَّعريضِ (¬3) بلفظِ: (المثلِ)، و (الغيرِ) إلى إِنسانين غيرِ المخاطَبِ يقصدُ إليهما؛ فإنَّه حينئذٍ يكونُ للتَّخْصيص.
فإنْ قيل: إنَّه (¬4) مثل: (زيدٌ عرفَ) وقد مرَّ أَنَّه ليس للتَّخصيص.
قلنا: إنَّ هذا التَّخصيصَ مدلولٌ عليه بحسبِ المقامِ، وهو غيرُ التَّخصيصِ الَّذي يُستفادُ من التَّقديمِ (¬5).
¬__________
(¬1) في ب: "البناء". وزيادة (أل) خطأ ظاهر.
(¬2) هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ: "يتعرض" وهو تحريف بالزِّيادة.
(¬3) لا يُراد بالتَّعريض -هنا- حقيقة التَّعريض الاصطلاحيّ؛ لأنّ التَّعريض الاصطلاحيّ يوجّه فيه الكلام إلى شخص والمراد إسماع غيره. بخلاف الواقع هنا - فإنّ الخطاب موجّه إلى شخص واحد. وإنّما جاز إطلاق لفظة التَّعريض عليه؛ لأَنَّه في حكم التَّعريض.
(¬4) في ب: "إن" وهو تحريف بالنّقص.
(¬5) في أ: زيادة: "وهذا إن سلّمنا أنّ مثل يتصرّف بالإضافة".