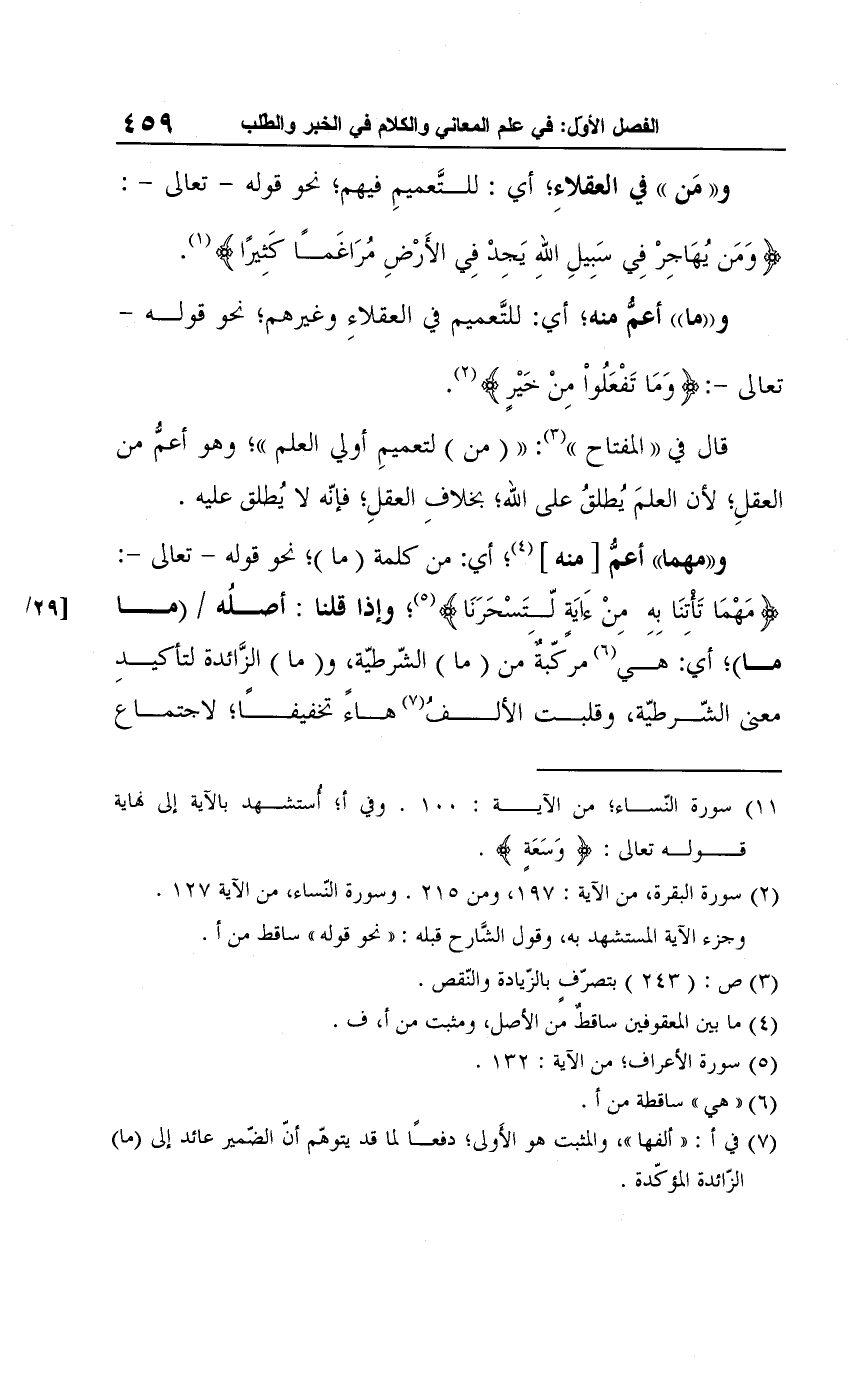
كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
و "مَن" في العقلاء؛ أي: للتَّعميمِ فيهم؛ نحو قوله -تعالى-: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا} (¬1).و"ما" أعمُّ منه؛ أي: للتعيم في العقلاءِ وغيرهم؛ نحو قوله -تعالى-: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ} (¬2).
قال في "المفتاح" (¬3): " (من) لتعميمِ أولي العلم"؛ وهو أعمُّ من العقلِ؛ لأنَّ العلمَ يُطلقُ على الله؛ بخلافِ العقلِ؛ فإنَّه لا يُطلق عليه.
و"مهما" أعمُّ [منه] (¬4)؛ أي: من كلمة (ما)؛ نحو قوله -تعالى-: {مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا} (¬5)، وإذا قلنا: أصلُه (ما ما)؛ أي: هي (¬6) مرّكّبةٌ من (ما) الشّرطيّة، و (ما) الزَّائدة لتأكيدِ معنى الشّرطيّة، وقلبت الألفُ (¬7) هاءً تخفيفًا؛ لاجتماع
¬__________
(¬1) سورة النّساء؛ من الآية: 100. وفي أ؛ استشهد بالآية إلى نهاية قوله تعالى: {وَسَعَةٍ}.
(¬2) سورة البقرة، من الآية: 197، ومن 215. وسورة النّساء، من الآية 127.
وجزء الآية المستشهد به، وقول الشَّارح قبله: "نحو قوله" ساقط من أ.
(¬3) ص: (243) بتصرفٍ بالزّيادة والنّقص.
(¬4) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ف.
(¬5) سورة الأعراف؛ من الآية: 132.
(¬6) "هي" ساقطة من أ.
(¬7) في أ: "ألفها"، والمثبت هو الأَولى؛ دفعًا لما قد يتوهّم أنّ الضمير عائد إلى (ما) الزّائدة المؤكّدة.