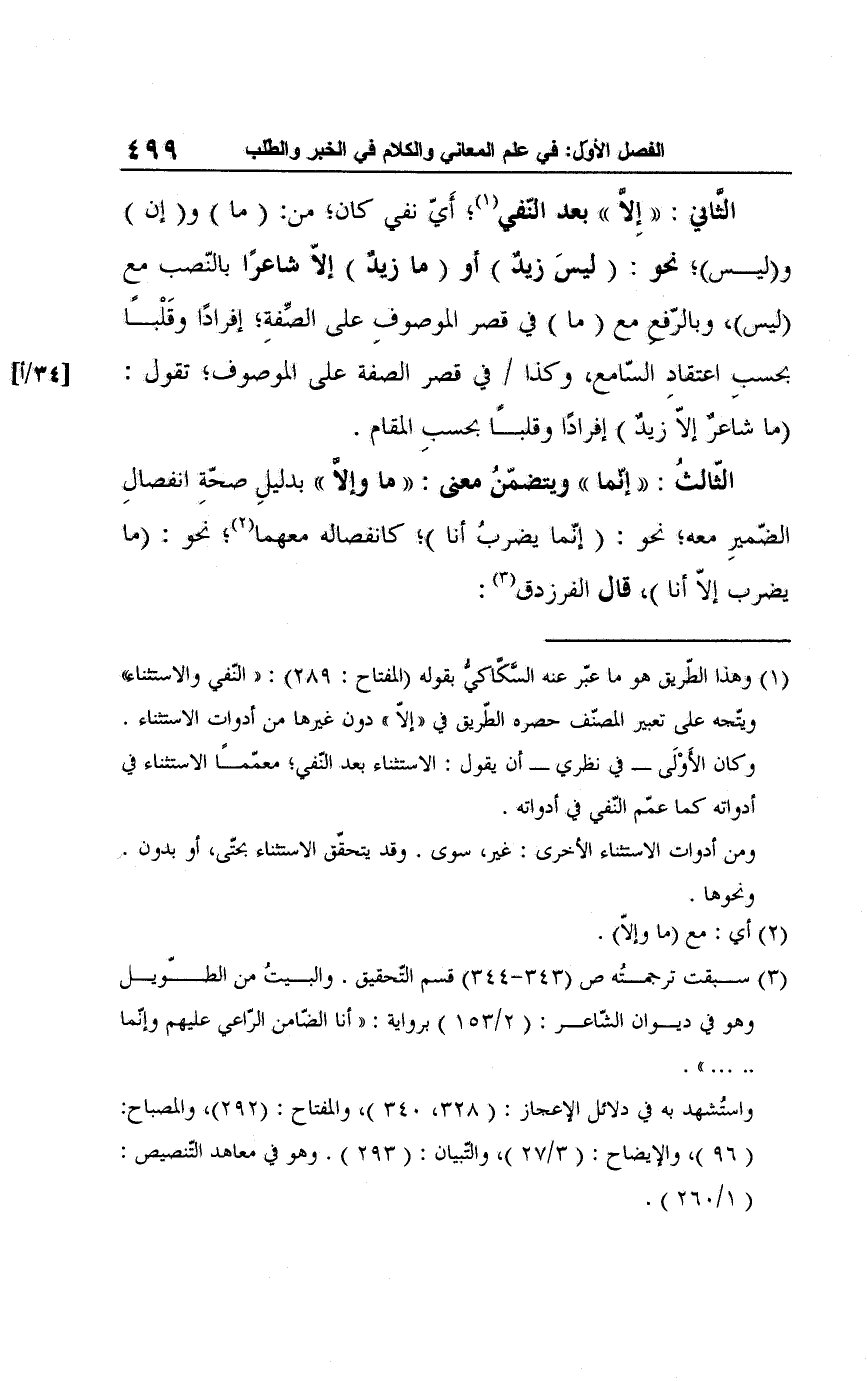
كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
الثَّاني: "إلَّا" بعد النّفي (¬1)؛ أَيّ نفي كان: من: (ما) و (إن) و (ليس)؛ نحو: (ليسَ زيدٌ) أو (ما زيدٌ) إلَّا شاعرًا بالنّصب مع (ليس)، وبالرّفع مع (ما) في قصر الموصوف على الصِّفةِ، إفرادًا وقلْبًا بحسب اعتقاد السّامع، وكذا في قصر الصفة على الموصوف؛ تقول: (ما شاعرٌ إلّا زيدُ) إفرادًا وقلبًا بحسبِ المقام.الثالث: "إنّما" ويتضمّنُ معنى: "ما وإلَّا" بدليلِ صحّةِ انفصالِ الضّميرِ معه؛ نحو: (إنَّما يضرب أنا)؛ كانفصاله معهما (¬2)؛ نحو: إما يضرب إلّا أنا)، ققال الفرزدق (¬3):
¬__________
(¬1) وهذا الطّريق هو ما عبّر عنه السَّكاكيُّ بقوله (المفتاح: 289): "النَّفي والاستثناء" ويتجه على تعبير المصنّف حصره الطَّريق في "إلّا" دون غيرها من أدوات الاستثناء.
وكان الأوْلَى -في نظري- أن يقول: الاستثناء بعد النَّفي؛ معمّمًا الاستثناء في أدواته كما عمّم النَّفي في أدواته.
ومن أدوات الاستثناء الأخرى: غير، سوى. وقد يتحقّق الاستثناء بحتى، أو بدون. ونحوها.
(¬2) أي: مع (ما وإلا).
(¬3) سبقت ترجمتُه ص (343 - 344) قسم التّحقيق. والبيتُ من الطَّويل وهو في ديوان الشّاعر: (2/ 153) برواية: "أنا الضّامن الراعي عليهم وإنّما ... ... ".
واستُشهد به في دلائل الإعجاز: (328، 340)، والمفتاح: (292)، والمصباح: (96)، والإيضاح: (2713)، والتّبيان: (293). وهو في معاهد التّنصيص: (1/ 260).