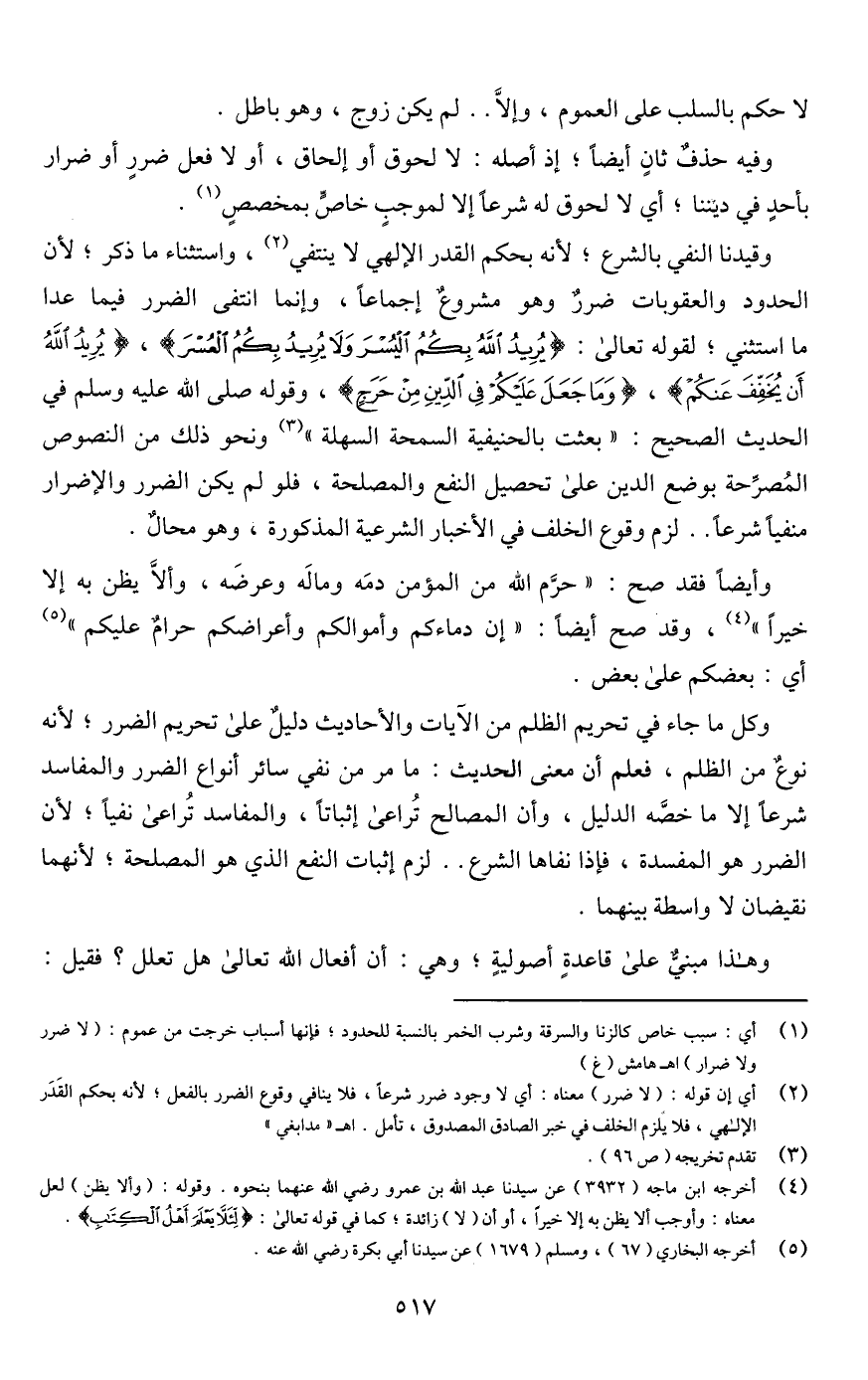
كتاب الفتح المبين بشرح الأربعين
لا حكم بالسلب على العموم، وإلَّا. . لم يكن زوج، وهو باطل.وفيه حذفٌ ثانٍ أيضًا، إذ أصله: لا لحوق أو إلحاق، أو لا فعل ضررٍ أو ضرار بأحدٍ في ديننا؛ أي لا لحوق له شرعًا إلا لموجبٍ خاصٍّ بمخصصٍ (¬1).
وقيدنا النفي بالشرع؛ لأنه بحكم القدر الإلهي لا ينتفي (¬2)، واستثناء ما ذكر؛ لأن الحدود والعقوبات ضررٌ وهو مشروعٌ إجماعًا، وإنما انتفى الضرر فيما عدا ما استثني، لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ}، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، وقوله صلى اللَّه عليه وسلم في الحديث الصحيح: "بعثت بالحنيفية السمحة السهلة" (¬3) ونحو ذلك من النصوص المُصرِّحة بوضع الدين على تحصيل النفع والمصلحة، فلو لم يكن الضرر والإضرار منفيًا شرعًا. . لزم وقوع الخلف في الأخبار الشرعية المذكورة، وهو محالٌ.
وأيضًا فقد صحح: "حرَّم اللَّه من المؤمن دمَه ومالَه وعرضَه، وألَّا يظن به إلا خيرًا" (¬4)، وقد صحح أيضًا: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم" (¬5) أي: بعضكم على بعض.
وكل ما جاء في تحريم الظلم من الآيات والأحاديث دليلٌ على تحريم الضرر؛ لأنه نوعٌ من الظلم، فعلم أن معنى الحديث: ما مر من نفي سائر أنواع الضرر والمفاسد شرعًا إلا ما خصَّه الدليل، وأن المصالح تُراعى إثباتًا، والمفاسد تُراعى نفيًا؛ لأن الضرر هو المفسدة، فإذا نفاها الشرع. . لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما.
وهذا مبنيٌّ على قاعدة أصوليةٍ، وهي: أن أفعال اللَّه تعالى هل تعلل؟ فقيل:
¬__________
(¬1) أي: سبب خاص كالزنا والسرقة وشرب الخمر بالنسبة للحدود؛ فإنها أسباب خرجت من عموم: (لا ضرر ولا ضرار) اهـ هامش (غ)
(¬2) أي إن قوله: (لا ضرر) معناه: أي لا وجود ضرر شرعًا، فلا ينافي وقوع الضرر بالفعل؛ لأنه بحكم القَدَر الإلهي، فلا يلزم الخلف في خبر الصادق المصدوق، تأمل. اهـ "مدابغي"
(¬3) تقدم تخريجه (ص 96).
(¬4) أخرجه ابن ماجه (3932) عن سيدنا عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما بنحوه. وقوله: (وألا يظن) لعل معناه: وأوجب ألا يظن به إلا خيرًا، أو أن (لا) زائدة، كما في قوله تعالى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ}.
(¬5) أخرجه البخاري (67)، ومسلم (1679) عن سيدنا أبي بكرة رضي اللَّه عنه.