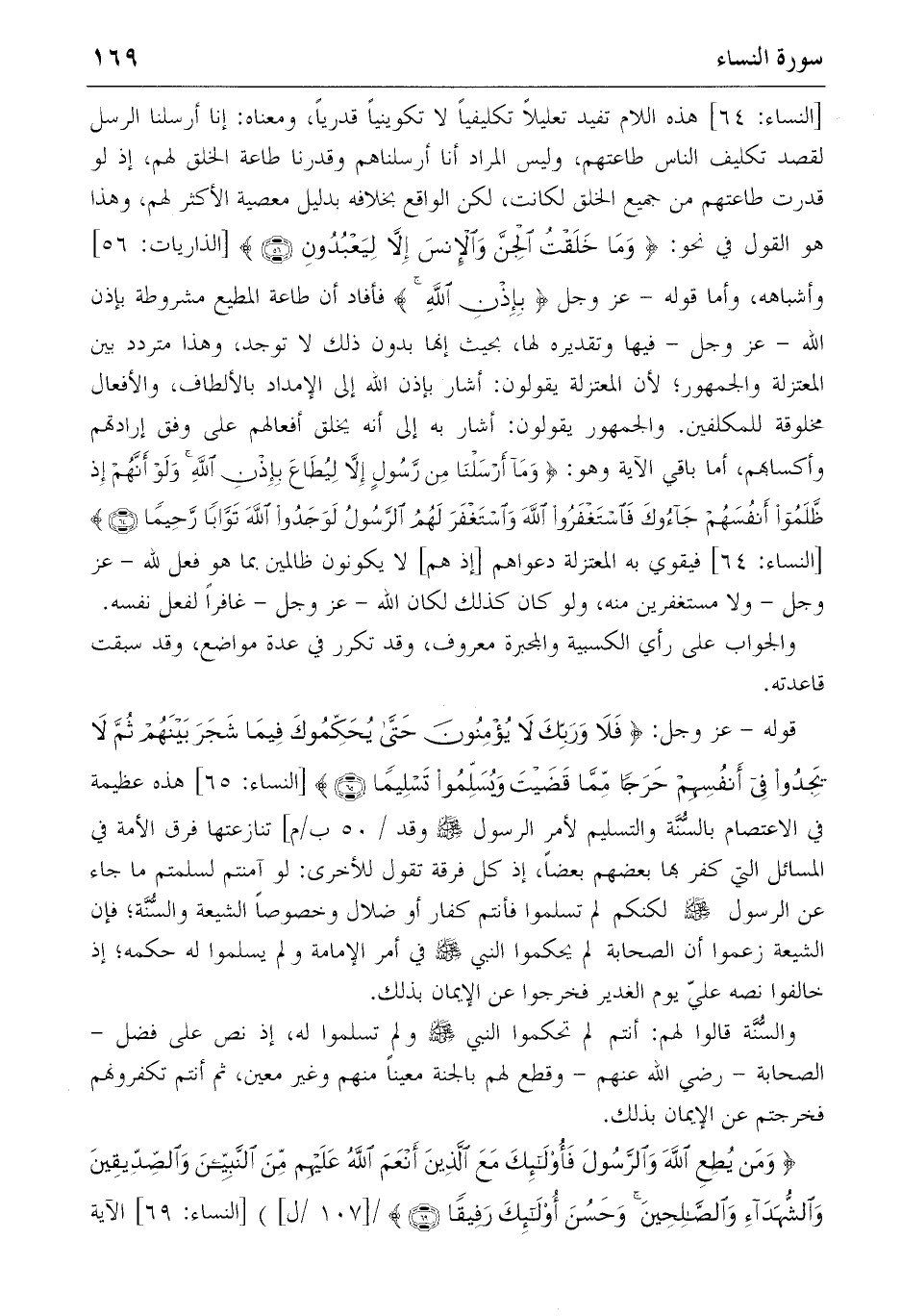
كتاب الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية
[النساء: ٦٤] هذه اللام تفيد تعليلا تكليفيا لا تكوينيا قدريا، ومعناه: إنا أرسلنا الرسل لقصد تكليف الناس طاعتهم، وليس المراد أنا أرسلناهم وقدرنا طاعة الخلق لهم، إذ لو قدرت طاعتهم من جميع الخلق لكانت، لكن الواقع بخلافه بدليل معصية الأكثر لهم، وهذا هو القول في نحو: {وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ} (٥٦) [الذاريات: ٥٦] وأشباهه، وأما قوله-عز وجل {بِإِذْنِ اللهِ} فأفاد أن طاعة المطيع مشروطة بإذن الله-عز وجل-فيها وتقديره لها، بحيث إنها بدون ذلك لا توجد، وهذا متردد بين المعتزلة والجمهور؛ لأن المعتزلة يقولون: أشار بإذن الله إلى الإمداد بالألطاف، والأفعال مخلوقة للمكلفين. والجمهور يقولون: أشار به إلى أنه يخلق أفعالهم على وفق إرادتهم وأكسابهم، أما باقي الآية وهو: {وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاِسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوّاباً رَحِيماً} (٦٤) [النساء: ٦٤] فيقوي به المعتزلة دعواهم [إذ هم] لا يكونون ظالمين بما هو فعل لله-عز وجل-ولا مستغفرين منه، ولو كان كذلك لكان الله-عز وجل-غافرا لفعل نفسه.والجواب على رأي الكسبية والمجبرة معروف، وقد تكرر في عدة مواضع، وقد سبقت قاعدته.
قوله-عز وجل: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} (٦٥) [النساء: ٦٥] هذه عظيمة في الاعتصام بالسّنّة والتسليم لأمر الرسول صلّى الله عليه وسلّم وقد/٥٠ ب/م] تنازعتها فرق الأمة في المسائل التي كفر بها بعضهم بعضا، إذ كل فرقة تقول للأخرى: لو آمنتم لسلمتم ما جاء عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم لكنكم لم تسلموا فأنتم كفار أو ضلال وخصوصا الشيعة والسّنّة؛ فإن الشيعة زعموا أن الصحابة لم يحكموا النبي صلّى الله عليه وسلّم في أمر الإمامة ولم يسلموا له حكمه؛ إذ خالفوا نصه عليّ يوم الغدير فخرجوا عن الإيمان بذلك.
والسّنّة قالوا لهم: أنتم لم تحكموا النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم تسلموا له، إذ نص على فضل- الصحابة-رضي الله عنهم-وقطع لهم بالجنة معينا منهم وغير معين، ثم أنتم تكفرونهم فخرجتم عن الإيمان بذلك.