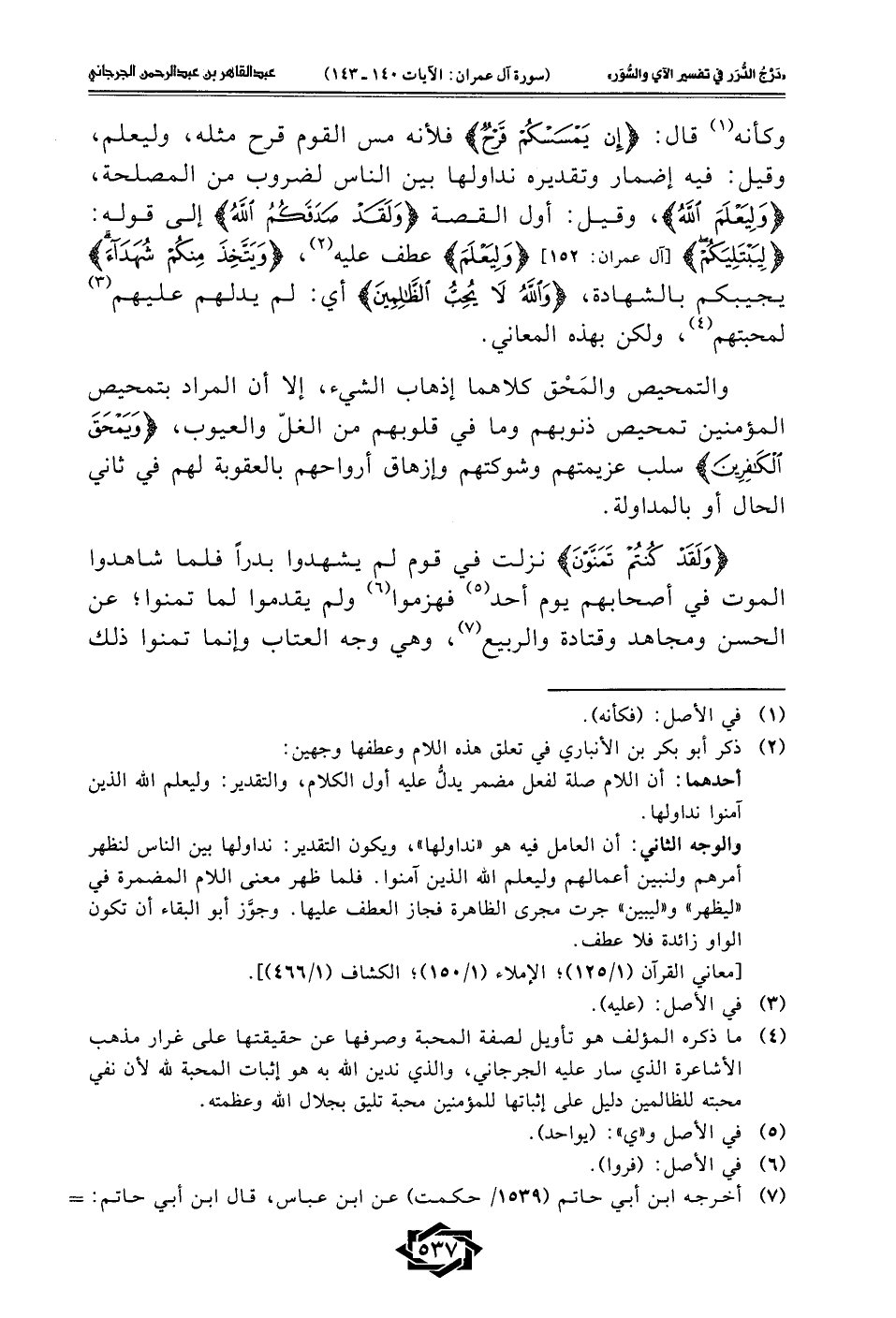
كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 2)
وكأنه (¬1) قال: {إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ} فلأنه مس القوم قرح مثله، وليعلم، وقيل: فيه إضمار وتقديره نداولها بين الناس لضروب من المصلحة، {وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ}، وقيل: أول القصة {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ} إلى قوله: {لِيَبْتَلِيَكُمْ} [آل عِمرَان: 152] {وَلِيَعْلَمَ} عطف عليه (¬2)، {وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ} يجيبكم بالشهادة، {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} أي: لم يدلهم عليهم (¬3) لمحبتهم (¬4)، ولكن بهذه المعاني.والتمحيص والمَحْق كلاهما إذهاب الشيء، إلا أن المراد بتمحيص المؤمنين تمحيص ذنوبهم وما في قلوبهم من الغلّ والعيوب، {وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ} سلب عزيمتهم وشوكتهم وإزهاق أرواحهم بالعقوبة لهم في ثاني الحال أو بالمداولة.
{وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ} نزلت في قوم لم يشهدوا بدرًا فلما شاهدوا الموت في أصحابهم يوم أحد (¬5) فهزموا (¬6) ولم يقدموا لما تمنوا؛ عن الحسن ومجاهد وقتادة والربيع (¬7)، وهي وجه العتاب وإنما تمنوا ذلك
¬__________
(¬1) في الأصل: (فكأنه).
(¬2) ذكر أبو بكر بن الأنباري في تعلق هذه اللام وعطفها وجهين:
أحدهما: أن اللام صلة لفعل مضمر يدلُّ عليه أول الكلام، والتقدير: وليعلم الله الذين آمنوا نداولها.
والوجه الثاني: أن العامل فيه و"نداولها"، ويكون التقدير: نداولها بين الناس لنظهر أمرهم وليبين أعمالهم وليعلم الله الذين آمنوا. فلما ظهر معنى اللام المضمرة في "ليظهر" و"ليبين" جرت مجرى الظاهرة فجاز العطف عليها. وجوَّز أبو البقاء أن تكون الواو زائدة فلا عطف.
[معاني القرآن (1/ 125)؛ الإملاء (1/ 150)؛ الكشاف (1/ 466)].
(¬3) في الأصل: (عليه).
(¬4) ما ذكره المؤلف هو تأويل لصفة المحبة وصرفها عن حقيقتها على غرار مذهب الأشاعرة الذي سار عليه الجرجاني، والذي ندين الله به هو إئبات المحبة لله لأن نفي محبته للظالمين دليل على إثباتها للمؤمنين محبة تليق بجلال الله وعظمته.
(¬5) في الأصل و"ي": (يواحد).
(¬6) في الأصل: (فروا).
(¬7) أخرجه ابن أبي حاتم (1539/ حكمت) عن ابن عباس، قال ابن أبي حاتم: =