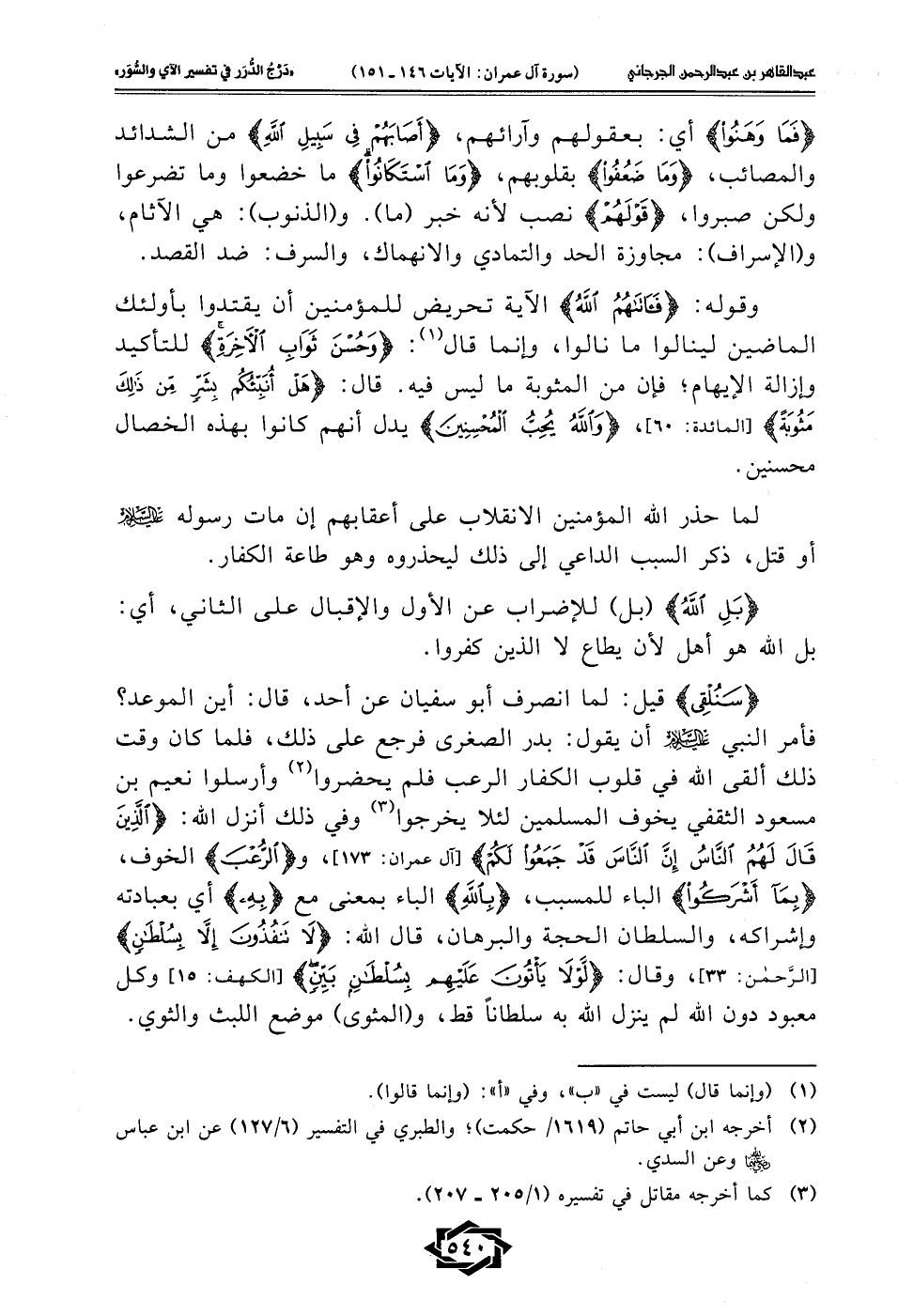
كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 2)
{فَمَا وَهَنُوا} أي: بعقولهم وآرائهم، {لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} من الشدائد والمصائب، {وَمَا ضَعُفُوا} بقلوبهم، {وَمَا اسْتَكَانُوا} ما خضعوا وما تضرعوا ولكن صبروا، {قَوْلَهُمْ} نصب لأنه خبر (ما). و (الذنوب): هي الآثام، و (الإسراف): مجاوزة الحد والتمادي والانهماك، والسرف: ضد القصد.وقوله: {فَآتَاهُمُ اللَّهُ} الآية تحريض للمؤمنين أن يقتدوا بأولئك الماضين لينالوا ما نالوا، وإنما قال (¬1): {وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ} للتأكيد وإزالة الإيهام؛ فإن من المثوبة ما ليس فيه. قال: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً} [المائدة: 60]، {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} يدل أنهم كانوا بهذه الخصال محسنين.
لما حذر الله المؤمنين الانقلاب على أعقابهم إن مات رسوله -عليه السلام- أو قتل، ذكر السبب الداعي إلى ذلك ليحذروه وهو طاعة الكفار.
{بَلِ اللَّهُ} (بل) للإضراب عن الأول والإقبال على الثاني، أي: بل الله هو أهل لأن يطاع لا الذين كفروا.
{سَنُلْقِي} قيل: لما انصرف أبو سفيان عن أحد، قال: أين الموعد؟ فأمر النبي -عليه السلام- أن يقول: بدر الصغرى فرجع على ذلك، فلما كان وقت ذلك ألقى الله في قلوب الكفار الرعب فلم يحضروا (¬2) وأرسلوا نعيم بن مسعود الثقفي يخوف المسلمين لئلا يخرجوا (¬3) وفي ذلك أنزل الله: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} [آل عِمرَان: 173]، و {الرُّعْبَ} الخوف، {بِمَا أَشْرَكُوا} الباء للمسبب، {بِاللَّهِ} الباء بمعنى مع {بِهِ} أي بعبادته وإشراكه، والسلطان الحجة والبرهان، قال الله: {لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ} [الرَّحمن: 33]، وقال: {لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ} [الكهف: 15] وكل معبود دون الله لم ينزل الله به سلطانًا قط، و (المثوى) موضع اللبث والثوي.
¬__________
(¬1) (وإنما قال) ليست في "ب"، وفي "أ": (وإنما قالوا).
(¬2) أخرجه ابن أبي حاتم (1619/ حكمت)؛ والطبري في التفسير (6/ 127) عن ابن عباس
- رضي الله عنه - وعن السدي.
(¬3) كما أخرجه مقاتل في تفسيره (1/ 205 - 207).