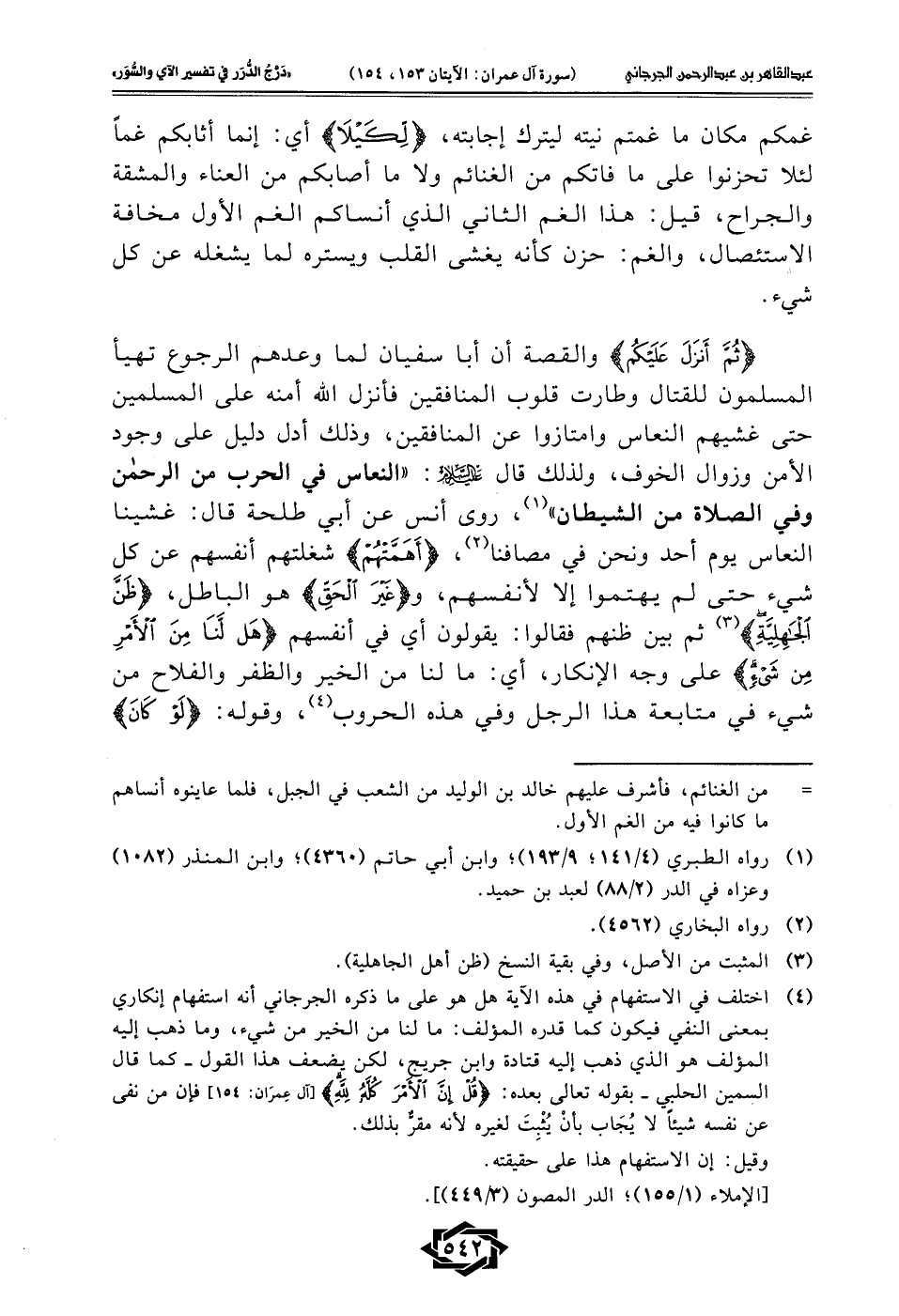
كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 2)
غمكم مكان ما غمتم نيته ليترك إجابته، {لِكَيْلَا} أي: إنما أثابكم غمًا لئلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم ولا ما أصابكم من العناء والمشقة والجراح، قيل: هذا الغم الثاني الذي أنساكم الغم الأول مخافة الاستئصال، والغم: حزن كأنه يغشى القلب ويستره لما يشغله عن كل شيء.{ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ} والقصة أن أبا سفيان لما وعدهم الرجوع تهيأ المسلمون للقتال وطارت قلوب المنافقين فأنزل الله أمنه على المسلمين حتى غشيهم النعاس وامتازوا عن المنافقين، وذلك أدل دليل على وجود الأمن وزوال الخوف، ولذلك قال -عليه السلام-: "النعاس في الحرب من الرحمن وفي الصلاة من الشيطان" (¬1)، روى أنس عن أبي طلحة قال: غشينا النعاس يوم أحد ونحن في مصافنا (¬2)، {أَهَمَّتْهُمْ} شغلتهم أنفسهم عن كل شيء حتى لم يهتموا إلا لأنفسهم، و {غَيْرَ الْحَقِّ} هو الباطل، {ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} (¬3) ثم بين ظنهم فقالوا: يقولون أي في أنفسهم {هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ} على وجه الإنكار، أي: ما لنا من الخير والظفر والفلاح من شيء في متابعة هذا الرجل وفي هذه الحروب (¬4)، وقوله: {لَوْ كَانَ}
¬__________
= من الغنائم، فأشرف عليهم خالد بن الوليد من الشعب في الجبل، فلما عاينوه أنساهم ما كانوا فيه من الغم الأول.
(¬1) رواه الطبري (4/ 141؛ 9/ 193)؛ وابن أبي حاتم (4360)؛ وابن المنذر (1082) وعزاه في الدر (2/ 88) لعبد بن حميد.
(¬2) رواه البخاري (4562).
(¬3) المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ (ظن أهل الجاهلية).
(¬4) اختلف في الاستفهام في هذه الآية هل هو على ما ذكره الجرجاني أنه استفهام إنكاري بمعنى النفي فيكون كما قدره المؤلف: ما لنا من الخير من شيء، وما ذهب إليه المؤلف هو الذي ذهب إليه قتادة وابن جريج، لكن يضعف هذا القول -كما قال السمين الحلبي- بقوله تعالى بعده: {قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ} [آل عِمرَان: 154] فإن من نفى عن نفسه شيئًا لا يُجَاب بأنْ يُثْبِتَ لغيره لأنه مقرٌّ بذلك.
وقيل: إن الاستفهام هذا على حقيقته.
[الإملاء (1/ 155)؛ الدر المصون (3/ 449)].