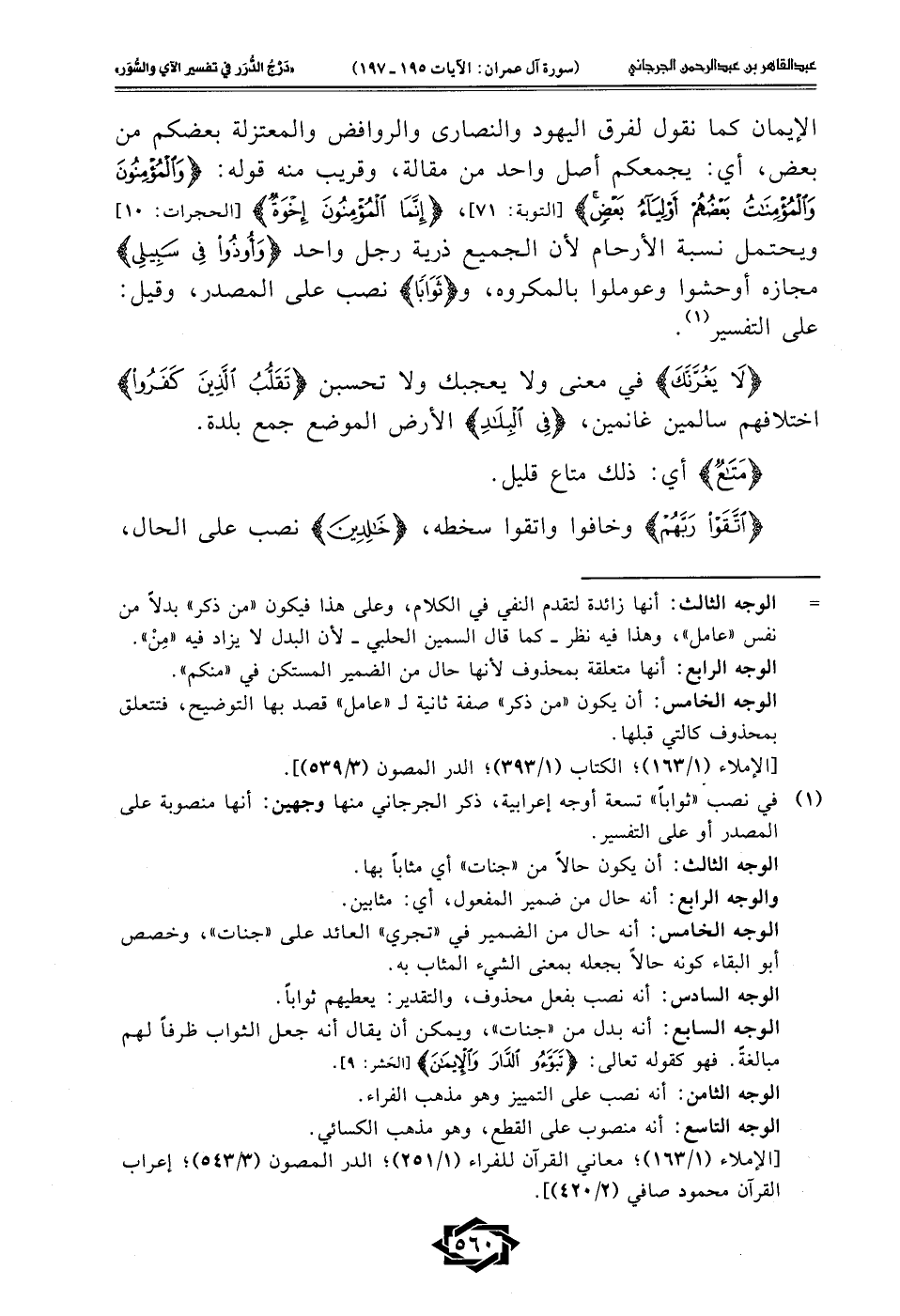
كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 2)
الإيمان كما نقول لفرق اليهود والنصارى والروافض والمعتزلة بعضكم من بعض، أي: يجمعكم أصل واحد من مقالة، وقريب منه قوله: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71]، {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10]، ويحتمل نسبة الأرحام لأن الجميع ذرية رجل واحد {وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي} مجازه أوحشوا وعوملوا بالمكروه، و {ثَوَابًا} نصب على المصدر، وقيل: على التفسير (¬1).{لَا يَغُرَّنَّكَ} في معنى ولا يعجبك ولا تحسبن {تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا} اختلافهم سالمين غانمين، {فِي الْبِلَادِ} الأرض الموضع جمع بلدة.
{مَتَاعٌ} أي: ذلك متاع قليل.
{اتَّقَوْا رَبَّهُمْ} وخافوا واتقوا سخطه، {خَالِدِينَ} نصب على الحال،
¬__________
= الوجه الثالث: أنها زائدة لتقدم النفي في الكلام، وعلى هذا فيكون "من ذكر" بدلًا من نفس "عامل"، وهذا فيه نظر - كما قال السمين الحلبي - لأن البدل لا يزاد فيه "مِنْ".
الوجه الرابع: أنها متعلقة بمحذوف لأنها حال من الضمير المستكن في "منكم".
الوجه الخامس: أن يكون "من ذكر" صفة ثانية لـ "عامل" قصد بها التوضيح، فتتعلق بمحذوف كالتي قبلها.
[الإملاء (1/ 163)؛ الكتاب (1/ 393)؛ الدر المصون (3/ 539)].
(¬1) في نصب "ثوابًا" تسعة أوجه إعرابية، ذكر الجرجاني منها وجهين: أنها منصوبة على المصدر أو على التفسير.
الوجه الثالث: أن يكون حالًا من "جنات" أي مثابًا بها.
والوجه الرابع: أنه حال من ضمير المفعول، أي: مثابين.
الوجه الخامس: أنه حال من الضمير في "تجري" العائد على "جنات"، وخصص أبو البقاء كونه حالًا بجعله بمعنى الشيء المثاب به.
الوجه السادس: أنه نصب بفعل محذوف، والتقدير: يعطيهم ثوابًا.
الوجه السابع: أنه بدل من "جنات"، ويمكن أن يقال أنه جعل الثواب ظرفًا لهم مبالغةً. فهو كقوله تعالى: {تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} [الحشر: 9].
الوجه الثامن: أنه نصب على التمييز وهو مذهب الفراء.
الوجه التاسع: أنه منصوب على القطع، وهو مذهب الكسائي.
[الإملاء (1/ 163)؛ معاني القرآن للفراء (1/ 251)؛ الدر المصون (3/ 543)؛ إعراب
القرآن محمود صافي (2/ 420)].